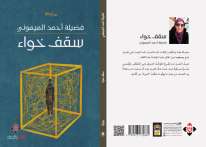قراءة تقييميَة لمشروع القانون التربوي الجديد بتونس
رام الله - دنيا الوطن
إيمانا منه بأنَ المسألة التربوية هي مسألة وطنية تهمَ كلَ مكوّنات المجتمع، وتقديرا منه بضرورة إصلاح المنظومة التربويّة الحاليّة، وحرصا منه على الشراكة في هذا الشأن، نظَم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالتشارك مع الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية، ندوة حول قراءة تقييمية لمشروع القانون التربوي الجديد يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة.
إيمانا منه بأنَ المسألة التربوية هي مسألة وطنية تهمَ كلَ مكوّنات المجتمع، وتقديرا منه بضرورة إصلاح المنظومة التربويّة الحاليّة، وحرصا منه على الشراكة في هذا الشأن، نظَم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالتشارك مع الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية، ندوة حول قراءة تقييمية لمشروع القانون التربوي الجديد يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة.
وتوزعت المداخلات بين الدكتور محمد بن فاطمة الخبير الدولي في تقييم النظم التربوية ورئيس الهيئة العلمية للائتلاف المدني، والدكتور مصدق الجليدي الخبير الدولي في التربية والمنسق العام للائتلاف، والدكتور فتحي جرَاي الوزير السابق للتربية، والأستاذ بلقاسم حسن المتفقد العام المتقاعد للتربية.
وفي كلمة ترحيبية عبّرت السيدة وداد بن عيسى الناطقة باسم جمعية الائتلاف المدني عن سرورها باستقبال الحضور وخاصّة الوفد الحاضر عن وزارة التربية واهتمامهم بالإصلاح التربوي الذي يعدَ مسألة وطنية جامعة. وترأست الجلسة السيّدة سعاد حجي عضو الهيئة المديرة لمركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة.
وفي مداخلته التي تحمل عنوان “مدى مطابقة مشروع القانون للدستور”، أكَد السيد مصدَق الجليدي على أنَ الإصلاح التربوي هو همَ وطني استراتيجي حيوي مشترك من مسؤوليات وزارة التربية والمجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والأولياء والأحزاب والبرلمان وكلَ الفاعلين في المجال التربوي. كما أشار إلى نقاط القوَة في المشروع والمتمثلة أساسا في :
أوَلا، إفراد مسألة الحياة المدرسية بعنوان خاص بها، وذلك من الفصل 57 إلى الفصل 61. ثانيا، التركيز على ذات المتعلَم في مختلف أبعادها.
وأخيرا، إحداث صنف من المؤسسات العمومية للتربية تتمتَع بالاستقلال المعنوي.
وقد ارتكز الدكتور في تقييمه على 5 مبادئ أساسيّة في الدستور هي:
ـ المسألة الحضاريّة الثقافيّة القيميّة (الأخلاقيّة)
ـ اللغة الوطنيّة.
ـ الحوكمة الرشيدة.
ـ الديمقراطيّة التشاركيّة.
ـ التمييز الإيجابي.
ينصّ الفصل 6 من مشروع القانون الجديد على أنَ مرجعيّة هذا القانون هي منظومة حقوق الإنسان والمثل الكونيّة، وهذا فيه تعارض واضح مع فصول الدستور(1/39) التي تنص على أن المرجعية في تشريع القوانين هي الهويّة العربيّة الإسلاميّة وهو ما يعدَ إسقاطا صارخا لمنظومة حقوق الإنسان على الواقع الثقافي التونسي العربي الإسلامي، علما وأنَ الدستور قد حسم مسألة الهوية ولا مجال لتجاهله.
ثانيا: مدى استجابته للمسألة الحضارية والثقافية والقيمية. فعلى مستوى اللغة، يكرس مشروع القانون الازدواجية اللغويَة، وهو مرفوض تماما لأنَ معيار التحكيم هو الدستور الذي ينصَ على اعتماد اللغة العربية في كلَ المراحل التربوية.
ثالثا، الحوكمة الرشيدة. يخلط كلَ من الفصل 75و76 بين مفهومي اللَامركزية واللَاتمركز إذ ينصَان على أنَ القرار يبقى مركزيّا وإن وجدت أجهزة محلية وهو ما يكرَس اللَاتمركز وليس اللَامركزية.
رابعا، الديمقراطية التشاركية. ينص الفصل 82 من المشروع على أنَ المجلس الأعلى للتربية يتولى تنفيذ الخيارات الكبرى والأرجح أنَه هو الجهة التي تضع الخيارات الكبرى من غير الفصل بين التربية والتعليم والتكوين المهني.
أمّا المداخلة الثانية فكانت للدكتور فتحي جرَاي تحت عنوان: “هل جاء القانون الجديد بالإضافة المرجوة؟” استهلها بالقول إنّنا نريد من المدرسة أن تحمل الأخلاق والقيم، وأن تنأى عن التجاذبات السياسيّة والايديولوجيّة. كما أكَد فيها وزير التربية السابق على أنَ هذا القانون لن تكون له الوجاهة الكافية لتغيير المجتمع لأنَه عبارة عن قانون 2002 تمَت صياغته بطريقة مختلفة وأضيف إليه 13 فصلا. فما الفائدة من إصدار قانون جديد؟ والحال أنّه لم يفعّل منه سوى حوالي 20% فقط؟ وقد ألحّ على ضرورة استعمال اللغة الوطنيّة في تدريس العلوم.
وأشار في الأخير إلى أنَ الرّهان الأساسيّ لتطبيق هذا المشروع هو تغيير المنهجية من أجل ضمان ديمومته. كما أنَه من الضروري تكوين المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني بمبادرة شرعية وضمان استقلاليته ليشرف على تشخيص استراتيجي لكل المنظمات التربوية.
وفي المداخلة الثالثة بعنوان: “ما مدى الوجاهة البيداغوجيّة والمتانة العلميّة لمشروع القانون الجديد؟، لاحظ الدكتور بن فاطمة أوّلا غياب رؤية عامَة متكاملة للمنظومة التربوية، ممَا نتج عنه عدم وجاهة الاستراتيجيات والبرامج والإجراءات وتقنيات تقييمية وهذا أمر مركزي في تحديد الرؤية الوزارية. ثانيا، لا يخضع القانون إلى خيط ناظم يربطه بالمخرجات السابقة في استراتيجيات الإصلاح. ثالثا، يحتوي المشروع على مضامين غامضة أو غير صحيحة في المفاهيم المفتاحية المستخدمة كمفهوم المقاربة والكفاية، رابعا، لا يقدَم المشروع إطلالة على المستقبل في مجال التربية والتعليم، خامسا وأخيرا، احتوى مشروع القانون على 22 نصَ ترتيبيَ لم يرفق بنصوصها ممَا يجعل المشروع مبتورا كما أنَه صيغ بأسلوب غير قانوني ويكتفي بالاعتماد على عبارة فضفاضة “التراتيب الجاري بها العمل”.
وفي آخر مداخلته، أشار الدكتور بن فاطمة إلى أن هذا الإصلاح التربوي يحتاج إلى المزيد من التعديل والتعمَق والإغناء من قبل وزارة التربية والمجتمع المدني ليكون إصلاحا تربويا متينا وشاملا.
أمّا المداخلة الأخيرة فكانت للأستاذ بلقاسم بن حسن وجاءت في شكل تعقيب وملاحظات. فبدأ بالتأكيد على أنَ هذه المسألة الوطنية لا علاقة لها بالمزايدات ولا بالحسابات السياسية وإنَما الاتفاق عليها يصبَ في مصلحة المجموعة الوطنيَة. كما أشار إلى أنَ الخلل في مشروع القانون ناتج عن خلل في المسار السياسي والإداري برمَته. كما أكَد السيد بن حسن على أن الخبراء والأطر لهم القدرة على إنجاز الجوانب البيداغوجية التعلَميّة، أمَا فيما يتعلق بالجوانب التربوية القيمية فهي مع الأسف من مسؤوليات السياسيين والقوى الاجتماعية التي لها بصمة غير سليمة. فبالنسبة إلى مشروع القانون تمَ تجنَب إدراج الفصول السابقة المتعلَقة بالهوية العربية الإسلامية وبخصوصيّة الشعب التونسي. وبنبرة حادَة، أكَد على أنَ هذه المحاولات السياسية التي تحاول ضرب الهويّة مجدَدا، خاصَة على مستوى اللغة العربية وعلى مستوى خصوصيّة التونسيين، ستبوء بالفشل بحيث لن يقبل بضرب هويته وباغترابه مجدَدا.
وخلال النقاش، أكَد العديد من المتدخلين على دور بعض القوى الخارجية في عرقلة الإصلاح التربوي بما يتماشى مع الهوية العربية الإسلامي لتكريس المزيد من التبعية الاستعمارية الثقافية كما أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربية واعتمادها في تدريس كل المواد التعليمية لأَنَ تقدم الأمم يقوم على الحفاظ على اللغة الأمّ.
أكَد السيد وحيد قدورة مدير سابق بوزارة التربية، على أنَ مشروع القانون لم ينضج بعد وهو غير صالح للتطبيق مشيرا إلى الحاجة للكثير من العمل المشترك وخاصة ضرورة تكوين هيئة مستقلَة بعيدة عن التجاذبات السياسية مثل المجلس الأعلى للتربية.
كما عبر أعضاء وفد وزارة التربية الذين كانوا حاضرين على أنَ الوزارة ترحّب بكلَ النقد الذي سيمكَن من تحسين مشروع القانون الذي مازال في أوّل محطات صياغته ويمرَ باستشارة موسَعة معروضة على كلَ أطياف المجتمع المدني. كما أكَدوا على أن لا تعارض بين الكونية والخصوصيّة علما وأنَ الكونيّة هي الحامية للخصوصية.
وفي كلمة ترحيبية عبّرت السيدة وداد بن عيسى الناطقة باسم جمعية الائتلاف المدني عن سرورها باستقبال الحضور وخاصّة الوفد الحاضر عن وزارة التربية واهتمامهم بالإصلاح التربوي الذي يعدَ مسألة وطنية جامعة. وترأست الجلسة السيّدة سعاد حجي عضو الهيئة المديرة لمركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة.
وفي مداخلته التي تحمل عنوان “مدى مطابقة مشروع القانون للدستور”، أكَد السيد مصدَق الجليدي على أنَ الإصلاح التربوي هو همَ وطني استراتيجي حيوي مشترك من مسؤوليات وزارة التربية والمجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والأولياء والأحزاب والبرلمان وكلَ الفاعلين في المجال التربوي. كما أشار إلى نقاط القوَة في المشروع والمتمثلة أساسا في :
أوَلا، إفراد مسألة الحياة المدرسية بعنوان خاص بها، وذلك من الفصل 57 إلى الفصل 61. ثانيا، التركيز على ذات المتعلَم في مختلف أبعادها.
وأخيرا، إحداث صنف من المؤسسات العمومية للتربية تتمتَع بالاستقلال المعنوي.
وقد ارتكز الدكتور في تقييمه على 5 مبادئ أساسيّة في الدستور هي:
ـ المسألة الحضاريّة الثقافيّة القيميّة (الأخلاقيّة)
ـ اللغة الوطنيّة.
ـ الحوكمة الرشيدة.
ـ الديمقراطيّة التشاركيّة.
ـ التمييز الإيجابي.
ينصّ الفصل 6 من مشروع القانون الجديد على أنَ مرجعيّة هذا القانون هي منظومة حقوق الإنسان والمثل الكونيّة، وهذا فيه تعارض واضح مع فصول الدستور(1/39) التي تنص على أن المرجعية في تشريع القوانين هي الهويّة العربيّة الإسلاميّة وهو ما يعدَ إسقاطا صارخا لمنظومة حقوق الإنسان على الواقع الثقافي التونسي العربي الإسلامي، علما وأنَ الدستور قد حسم مسألة الهوية ولا مجال لتجاهله.
ثانيا: مدى استجابته للمسألة الحضارية والثقافية والقيمية. فعلى مستوى اللغة، يكرس مشروع القانون الازدواجية اللغويَة، وهو مرفوض تماما لأنَ معيار التحكيم هو الدستور الذي ينصَ على اعتماد اللغة العربية في كلَ المراحل التربوية.
ثالثا، الحوكمة الرشيدة. يخلط كلَ من الفصل 75و76 بين مفهومي اللَامركزية واللَاتمركز إذ ينصَان على أنَ القرار يبقى مركزيّا وإن وجدت أجهزة محلية وهو ما يكرَس اللَاتمركز وليس اللَامركزية.
رابعا، الديمقراطية التشاركية. ينص الفصل 82 من المشروع على أنَ المجلس الأعلى للتربية يتولى تنفيذ الخيارات الكبرى والأرجح أنَه هو الجهة التي تضع الخيارات الكبرى من غير الفصل بين التربية والتعليم والتكوين المهني.
أمّا المداخلة الثانية فكانت للدكتور فتحي جرَاي تحت عنوان: “هل جاء القانون الجديد بالإضافة المرجوة؟” استهلها بالقول إنّنا نريد من المدرسة أن تحمل الأخلاق والقيم، وأن تنأى عن التجاذبات السياسيّة والايديولوجيّة. كما أكَد فيها وزير التربية السابق على أنَ هذا القانون لن تكون له الوجاهة الكافية لتغيير المجتمع لأنَه عبارة عن قانون 2002 تمَت صياغته بطريقة مختلفة وأضيف إليه 13 فصلا. فما الفائدة من إصدار قانون جديد؟ والحال أنّه لم يفعّل منه سوى حوالي 20% فقط؟ وقد ألحّ على ضرورة استعمال اللغة الوطنيّة في تدريس العلوم.
وأشار في الأخير إلى أنَ الرّهان الأساسيّ لتطبيق هذا المشروع هو تغيير المنهجية من أجل ضمان ديمومته. كما أنَه من الضروري تكوين المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني بمبادرة شرعية وضمان استقلاليته ليشرف على تشخيص استراتيجي لكل المنظمات التربوية.
وفي المداخلة الثالثة بعنوان: “ما مدى الوجاهة البيداغوجيّة والمتانة العلميّة لمشروع القانون الجديد؟، لاحظ الدكتور بن فاطمة أوّلا غياب رؤية عامَة متكاملة للمنظومة التربوية، ممَا نتج عنه عدم وجاهة الاستراتيجيات والبرامج والإجراءات وتقنيات تقييمية وهذا أمر مركزي في تحديد الرؤية الوزارية. ثانيا، لا يخضع القانون إلى خيط ناظم يربطه بالمخرجات السابقة في استراتيجيات الإصلاح. ثالثا، يحتوي المشروع على مضامين غامضة أو غير صحيحة في المفاهيم المفتاحية المستخدمة كمفهوم المقاربة والكفاية، رابعا، لا يقدَم المشروع إطلالة على المستقبل في مجال التربية والتعليم، خامسا وأخيرا، احتوى مشروع القانون على 22 نصَ ترتيبيَ لم يرفق بنصوصها ممَا يجعل المشروع مبتورا كما أنَه صيغ بأسلوب غير قانوني ويكتفي بالاعتماد على عبارة فضفاضة “التراتيب الجاري بها العمل”.
وفي آخر مداخلته، أشار الدكتور بن فاطمة إلى أن هذا الإصلاح التربوي يحتاج إلى المزيد من التعديل والتعمَق والإغناء من قبل وزارة التربية والمجتمع المدني ليكون إصلاحا تربويا متينا وشاملا.
أمّا المداخلة الأخيرة فكانت للأستاذ بلقاسم بن حسن وجاءت في شكل تعقيب وملاحظات. فبدأ بالتأكيد على أنَ هذه المسألة الوطنية لا علاقة لها بالمزايدات ولا بالحسابات السياسية وإنَما الاتفاق عليها يصبَ في مصلحة المجموعة الوطنيَة. كما أشار إلى أنَ الخلل في مشروع القانون ناتج عن خلل في المسار السياسي والإداري برمَته. كما أكَد السيد بن حسن على أن الخبراء والأطر لهم القدرة على إنجاز الجوانب البيداغوجية التعلَميّة، أمَا فيما يتعلق بالجوانب التربوية القيمية فهي مع الأسف من مسؤوليات السياسيين والقوى الاجتماعية التي لها بصمة غير سليمة. فبالنسبة إلى مشروع القانون تمَ تجنَب إدراج الفصول السابقة المتعلَقة بالهوية العربية الإسلامية وبخصوصيّة الشعب التونسي. وبنبرة حادَة، أكَد على أنَ هذه المحاولات السياسية التي تحاول ضرب الهويّة مجدَدا، خاصَة على مستوى اللغة العربية وعلى مستوى خصوصيّة التونسيين، ستبوء بالفشل بحيث لن يقبل بضرب هويته وباغترابه مجدَدا.
وخلال النقاش، أكَد العديد من المتدخلين على دور بعض القوى الخارجية في عرقلة الإصلاح التربوي بما يتماشى مع الهوية العربية الإسلامي لتكريس المزيد من التبعية الاستعمارية الثقافية كما أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربية واعتمادها في تدريس كل المواد التعليمية لأَنَ تقدم الأمم يقوم على الحفاظ على اللغة الأمّ.
أكَد السيد وحيد قدورة مدير سابق بوزارة التربية، على أنَ مشروع القانون لم ينضج بعد وهو غير صالح للتطبيق مشيرا إلى الحاجة للكثير من العمل المشترك وخاصة ضرورة تكوين هيئة مستقلَة بعيدة عن التجاذبات السياسية مثل المجلس الأعلى للتربية.
كما عبر أعضاء وفد وزارة التربية الذين كانوا حاضرين على أنَ الوزارة ترحّب بكلَ النقد الذي سيمكَن من تحسين مشروع القانون الذي مازال في أوّل محطات صياغته ويمرَ باستشارة موسَعة معروضة على كلَ أطياف المجتمع المدني. كما أكَدوا على أن لا تعارض بين الكونية والخصوصيّة علما وأنَ الكونيّة هي الحامية للخصوصية.