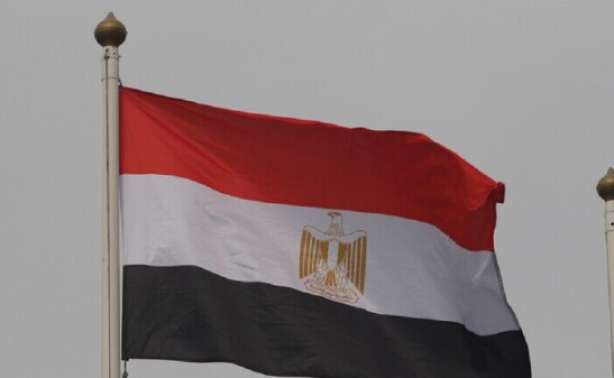التنمية تحت الاحتلال

ناجح شاهين
كأني أسير في اتجاه مطار ج.ف. كنيدي في نيويورك: أزمة السيارات الخانقة من مشفى الهلال حتى مفترق مخيم الجلزون، مسافة ربما لا تزيد عن أربعة كيلومترات تحتاج إلى زهاء ساعة. وفوضى سيارات مريعة. من أين جاءت تلك السيارات التي لاعد لها والتي تنافس في كثافة حركتها الطريق الذي يوصل إلى مطار كنيدي أو الجسر الذي يربط بين الشارقة ودبي؟
إنها التنمية التي تتحقق في فلسطين –الحمد لله- على الرغم من أنف الاحتلال.
عندما احتل الانجليز مصر والسودان والهند وغيرها، فتحوا المدارس: إن أول مدارس فتحت في الدنيا المستمعرة فتحها الاستعمار لكي يصنع شعباً على مقاس ما يحتاجه اقتصاد البلد المستعمر وبما يخدم مصالحه. الاستعمار أراد بناء ثقافة اقتصادية وسياسية واستهلاكية تخدم مصالحه وتسهل له دمج البلاد المحكومة في سياق اقتصاده، "فنمت" نمواً تبعياً يجعلها مناسبة تماماً لدعم البناء القائم في بلاد الاستعمار الرأسمالي الصناعي. لذلك اعتقد اللورد كرومر أن مصر صنعها الله، تخيلوا صنعها الله، لكي تكون مزرعة قطن للمصانع الانجليزية، وأنها لا تنفع للصناعة أبداً.
بالطبع علم الاستعمار "نخبة" من أبناء البلاد الخاضعة للاستعمار وأعطاهم شيئاً من فتات الامتيازات كيما يتحولوا إلى أداة له لكي يسهلوا عليه عملية إخضاع البلاد ونهبها.
لا جرم أن مناطق الضفة الغربية وغزة قد "نمت" تحت الاحتلال الصهيوني. وقد ارتفع مستوى الدخل، ومستوى الاستهلاك، وقد نجح الاحتلال في إزاحة أو احتواء القيادات الإقطاعية الزراعية وأحل محلها نخباً من المقاولين الذين يعملون في البناء والإنشاءات في مستوطناته داخل "الخط الأخضر" وفي الضفة على السواء. نجح الاحتلال في تقزيم الزراعة ودورها لمصلحة العمل "المجزي" والمربح أكثر في سياق الاقتصاد "الإسرائيلي". وتم تقويض الصناعة. وانتشر التعليم العالي الذي خرج أناساً لا مكان لهم في البلاد ليسافروا –بعضهم دون رجعة- الى الخليج. وتوسعت قدرة المواطن الفلسطيني على الاستهلاك المعتمد على دخل لا بأس به من دولة الكيان. لكن ذلك الدخل صب بالطبع في نهاية اليوم في اقتصاد الكيان ذاته.
وجاءت سلطة أوسلو ليتواصل النهج تقريباً كما هو من ناحية تقلص الزراعة والصناعة مع اتساع دور الوظيفة الحكومية وقطاع العاملين في الامن والعسكر. وفي هذا السياق ازدادت النزعة الاستهلاكية التي تأتي على المنتجات المستوردة من كل حدب وصوب. وانخفض دور الزراعة والصناعة عن ذي قبل. وتوسع "التعليم" الى حد أصبحت فيه "فلسطين" أكبر مصنع للشهادات العليا التي لا مكان لحامليها في بنية الاقتصاد.
لكن التمويل الأجنبي الذي يتحقق بصفته ريعياً سياسياً مكن شرائح واسعة من العيش في مستويات تتفوق بشكل ساحق على بلدان لا بأس بدرجة نموها مثل البرازيل والهند وحتى الصين. ولا بد أن الغالبية العظمى من الصينيين الذين تهدد بلادهم بكسر هيمنة الولايات المتحدة تعيش في مستوى أقل من المستوى الفلسطيني. لكن بالطبع يعلم القاصي والداني أن الدخل المتأتي من الوظيفة في السلطة ومنظمات الأنجزة ليس مضوناً مدة شهر واحد: في اية لحظة يقرر الممول الغربي إغلاق صنبور التمويل تنهار المؤسسات كلها، وتغرق البلد في ظلام المجاعة.
لكن ما دام التمويل يواصل تدفقه فإن النمو –أم أسميه تنمية؟- الاستهلاكي يتسع خالقاً الوهم لدى البعض بأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن. لكن واقع الحال يعرفه أي مواطن ذكي بسيط، وهو لا يحتاج إلى علماء في الاقتصاد أو السياسة أو الاقتصاد السياسي أو التنمية: واقع الحال يلخصة مظفر النواب في قوله
"والبلاد إذا سمنت وارمة". كذلك حذر المتنبي الذي يستلهمه النواب من توهم أن المرض نمو وازدهار:
"أعيذها نظرات منك فاحصة ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم"
وإنه لأسفنا الشديد ورم يجتاحنا عن طريق الريع السياسي مثلما اجتاح إخوتنا في خليج النفط عن طريق الريع البترولي. ولا بد أن حالنا أصعب وأشد خطراً من ناحية قدرة "التنمية" القائمة على تهيئة البلاد لقمة سائغة ليلتهمها الاحتلال نهائياً حين تحل اللحظة المناسبة.
كأني أسير في اتجاه مطار ج.ف. كنيدي في نيويورك: أزمة السيارات الخانقة من مشفى الهلال حتى مفترق مخيم الجلزون، مسافة ربما لا تزيد عن أربعة كيلومترات تحتاج إلى زهاء ساعة. وفوضى سيارات مريعة. من أين جاءت تلك السيارات التي لاعد لها والتي تنافس في كثافة حركتها الطريق الذي يوصل إلى مطار كنيدي أو الجسر الذي يربط بين الشارقة ودبي؟
إنها التنمية التي تتحقق في فلسطين –الحمد لله- على الرغم من أنف الاحتلال.
عندما احتل الانجليز مصر والسودان والهند وغيرها، فتحوا المدارس: إن أول مدارس فتحت في الدنيا المستمعرة فتحها الاستعمار لكي يصنع شعباً على مقاس ما يحتاجه اقتصاد البلد المستعمر وبما يخدم مصالحه. الاستعمار أراد بناء ثقافة اقتصادية وسياسية واستهلاكية تخدم مصالحه وتسهل له دمج البلاد المحكومة في سياق اقتصاده، "فنمت" نمواً تبعياً يجعلها مناسبة تماماً لدعم البناء القائم في بلاد الاستعمار الرأسمالي الصناعي. لذلك اعتقد اللورد كرومر أن مصر صنعها الله، تخيلوا صنعها الله، لكي تكون مزرعة قطن للمصانع الانجليزية، وأنها لا تنفع للصناعة أبداً.
بالطبع علم الاستعمار "نخبة" من أبناء البلاد الخاضعة للاستعمار وأعطاهم شيئاً من فتات الامتيازات كيما يتحولوا إلى أداة له لكي يسهلوا عليه عملية إخضاع البلاد ونهبها.
لا جرم أن مناطق الضفة الغربية وغزة قد "نمت" تحت الاحتلال الصهيوني. وقد ارتفع مستوى الدخل، ومستوى الاستهلاك، وقد نجح الاحتلال في إزاحة أو احتواء القيادات الإقطاعية الزراعية وأحل محلها نخباً من المقاولين الذين يعملون في البناء والإنشاءات في مستوطناته داخل "الخط الأخضر" وفي الضفة على السواء. نجح الاحتلال في تقزيم الزراعة ودورها لمصلحة العمل "المجزي" والمربح أكثر في سياق الاقتصاد "الإسرائيلي". وتم تقويض الصناعة. وانتشر التعليم العالي الذي خرج أناساً لا مكان لهم في البلاد ليسافروا –بعضهم دون رجعة- الى الخليج. وتوسعت قدرة المواطن الفلسطيني على الاستهلاك المعتمد على دخل لا بأس به من دولة الكيان. لكن ذلك الدخل صب بالطبع في نهاية اليوم في اقتصاد الكيان ذاته.
وجاءت سلطة أوسلو ليتواصل النهج تقريباً كما هو من ناحية تقلص الزراعة والصناعة مع اتساع دور الوظيفة الحكومية وقطاع العاملين في الامن والعسكر. وفي هذا السياق ازدادت النزعة الاستهلاكية التي تأتي على المنتجات المستوردة من كل حدب وصوب. وانخفض دور الزراعة والصناعة عن ذي قبل. وتوسع "التعليم" الى حد أصبحت فيه "فلسطين" أكبر مصنع للشهادات العليا التي لا مكان لحامليها في بنية الاقتصاد.
لكن التمويل الأجنبي الذي يتحقق بصفته ريعياً سياسياً مكن شرائح واسعة من العيش في مستويات تتفوق بشكل ساحق على بلدان لا بأس بدرجة نموها مثل البرازيل والهند وحتى الصين. ولا بد أن الغالبية العظمى من الصينيين الذين تهدد بلادهم بكسر هيمنة الولايات المتحدة تعيش في مستوى أقل من المستوى الفلسطيني. لكن بالطبع يعلم القاصي والداني أن الدخل المتأتي من الوظيفة في السلطة ومنظمات الأنجزة ليس مضوناً مدة شهر واحد: في اية لحظة يقرر الممول الغربي إغلاق صنبور التمويل تنهار المؤسسات كلها، وتغرق البلد في ظلام المجاعة.
لكن ما دام التمويل يواصل تدفقه فإن النمو –أم أسميه تنمية؟- الاستهلاكي يتسع خالقاً الوهم لدى البعض بأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن. لكن واقع الحال يعرفه أي مواطن ذكي بسيط، وهو لا يحتاج إلى علماء في الاقتصاد أو السياسة أو الاقتصاد السياسي أو التنمية: واقع الحال يلخصة مظفر النواب في قوله
"والبلاد إذا سمنت وارمة". كذلك حذر المتنبي الذي يستلهمه النواب من توهم أن المرض نمو وازدهار:
"أعيذها نظرات منك فاحصة ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم"
وإنه لأسفنا الشديد ورم يجتاحنا عن طريق الريع السياسي مثلما اجتاح إخوتنا في خليج النفط عن طريق الريع البترولي. ولا بد أن حالنا أصعب وأشد خطراً من ناحية قدرة "التنمية" القائمة على تهيئة البلاد لقمة سائغة ليلتهمها الاحتلال نهائياً حين تحل اللحظة المناسبة.