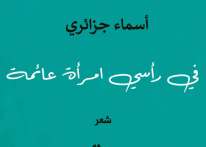الجزائر تحتل صدارة سوق المواد الصيدلانية في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
يُعد توفير الخدمة الصحية أو الرعاية الصحية الجيدة في المجتمع للجزائري من أكبر التحديات التي يواجهها القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة ، ذلك أن هذه الخدمات لها صلة مباشرة بصحة الأفراد وحياتهم بالدرجة الأولى ، كما أن هذه الأخيرة تتميز بالتكلفة العالية نسبيا وهو ما لا يتلاءم مع محدودية الموارد المخصصة لها ، خصوصا بالنسبة للمستشفيات العامة.
ما ميز هذه المرحلة هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة 1986، وهي المراكز الاستشفائية الجامعية، وفي نهاية الثمانينيات، جاء دستور 23 فيفري 1989 ليحدد تدخل الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية، كما نصت عليه المادة 51 من الدستور سالف الذكر، والتي تقول أن: «الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض المعدية وبمكافحتها، ويؤكد ذلك قانون المالية لسنة 1993، حيث نص على أنه بداية من هذه السنة، فإن مجال تدخل الدولة سيكون في الوقاية والتكفل بالمعوزين والتكوين، مع البحث في العلوم الطبية، أما باقي العلاجات، فتتم وفق اتفاق بين المؤسسات الاستشفائية وهيئات الضمان الاجتماعي،
يُعد توفير الخدمة الصحية أو الرعاية الصحية الجيدة في المجتمع للجزائري من أكبر التحديات التي يواجهها القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة ، ذلك أن هذه الخدمات لها صلة مباشرة بصحة الأفراد وحياتهم بالدرجة الأولى ، كما أن هذه الأخيرة تتميز بالتكلفة العالية نسبيا وهو ما لا يتلاءم مع محدودية الموارد المخصصة لها ، خصوصا بالنسبة للمستشفيات العامة.
لا شك أن الجزائر عملت منذ الاستقلال سنة 1962 على وضع مبادئ أساسية تقوم عليها السياسة الصحية ، بغية تجسيد حق المواطن في العلاج ، كما نصت عليه المواثيق والدساتير ، والذي اعتبر مكسبا ثوريا. هذه المبادئ عرفت نجاحات وبعض الاختلالات عبر المراحل المختلفة التي مرت بها الجزائر ، وكانت وضعية الصحة العمومية قبل الاستقلال متردية ، حيث كان الشعب الجزائري يعاني الفقر والحرمان ومختلف الأمراض الوبائية ، وهذه الأمراض التي كانت ناتجة عن الظروف المعيشية السيئة لأغلبية الشعب من جهة ، وغياب التغطية الصحية من جهة أخرى.
وبلغة الأرقام غداة الاستقلال ، كان في خدمة ل 10 ملايين نسمة قرابة 300 طبيب فقط ، مما استوجب تحديد الأولويات والتركيز على سياسة وطنية للصحة ، ترمي إلى القضاء على الأمراض الوبائية ومكافحة وفيات الأطفال ، وكذا بناء الهياكل وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية.
وتمثلت هذه السياسة في المكافحة المكثفة للأمراض الوبائية وتعميم العلاج الوقائي ، كالتلقيح ، نظافة المحيط ، حماية الأمومة والطفولة ، النظافة المدرسية وطب العمل وهما الهدفان الرئيسيان اللذان شملهما البرنامج المسطر لعام 1962. وقد خصصت الوسائل لتنفيذ هذا البرنامج الطبي المستعجل كتكوين الأطباء ، بناء الهياكل والتجهيزات ، وتشجيع التمويل الطبي ، إلا أنها في الغالب لم تكن كافية مقارنة مع نسبة نمو السكان.
وبالرغم من العوائق ، فقد حقق هذا البرنامج الكثير من الأهداف ، منها التحكم في آفة الأمراض الوبائية من جهة ، وظهور معطيات جديدة من جهة أخرى ، تمثلت على الخصوص في النمو السكاني وتشبيب الشعب الجزائري هذه المعطيات السكانية جعلت التركيز على الحماية كهدف وكأولوية للسياسة الصحية في الجزائر ،
وفي هذا الإطار، رسمت الحكومة محاور كبرى للسياسة الصحية ، تمثلت في رسم إستراتيجية من شأنها تعديل مواقع الخلل التي عرفها النظام الصحي السابق ، وتمثلت هذه الإستراتيجية في عدد من المحاور: أهمها الوقاية التي تعتبر أفضل طرق العلاج ، لتجنب المرض والعمل على عدم وقوعه ، وذلك من خلال الحملات التلقيحية وإجراءات النظافة ومحاصرة المرض قبل انتشاره عن طريق التلقيح واحترام معاييره.
وبما أن سياسة التصنيع في الجزائر تعتمد على الصناعات الثقيلة التي تتطلب يدا عاملة كبيرة ، وهو ما أدى إلى انتشار حوادث العمل بكثرة ، واستوجب ذلك تطوير طب العمل لحماية العامل والاقتصاد في آن واحد ، كما انجر عن سياسة التصنيع اتساع شبكة الطرقات وتلوث البيئة نتيجة الغازات الصناعية ، بالإضافة إلى حوادث المرور والأمراض البيئية.
السياسة الصحية من 1962 إلى 1965
السياسة الصحية من 1962 إلى 1965
كان النظام الصحي الموروث عند الاستقلال متمركزا أساسا في كبريات المدن كالجزائر ووهران ، وقسنطينة. ويتمثل خاصة في الطب العمومي الذي يتم داخل المستشفيات ، وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم المساعدات الطبية المجانية للسكان ، إلى جانب مراكز الطب المدرسي النفسي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
ومن جهة أخرى ، هناك الطب الخاص الذي يسهر عليه حوالي 600 طبيب يعملون في عيادات خاصة ، جلهم كانوا من الأجانب.
لقد عرف قطاع الصحة خلال الحقبة الممتدة من الاستقلال إلى غاية منتصف الستينيات وما بعدها، تطورات كبيرة من حيث المستخدمين والهياكل القاعدية، لكن بمستوى تميز بالبطء مقارنة مع التطور السكاني الذي عرفته البلاد ، وكذا بجملة من النصوص والقوانين لتوحيد النظام الموروث عن المستعمر.
فقبل سنة 1965، لم تكن البلاد تتوفر إلا على 1319 طبيبا ؛ منهم 285 جزائريا فقط ، وهو ما يعادل طبيبا واحدا لكل 8092 نسمة ، و264 صيدليا ؛ أي صيدلي واحد لكل 52323 نسمة. أما أطباء الأسنان ، فكانوا حوالي 151 طبيبا ، أي طبيب أسنان واحد لكل 70688 نسمة.
لقد عرف قطاع الصحة خلال الحقبة الممتدة من الاستقلال إلى غاية منتصف الستينيات وما بعدها، تطورات كبيرة من حيث المستخدمين والهياكل القاعدية، لكن بمستوى تميز بالبطء مقارنة مع التطور السكاني الذي عرفته البلاد ، وكذا بجملة من النصوص والقوانين لتوحيد النظام الموروث عن المستعمر.
فقبل سنة 1965، لم تكن البلاد تتوفر إلا على 1319 طبيبا ؛ منهم 285 جزائريا فقط ، وهو ما يعادل طبيبا واحدا لكل 8092 نسمة ، و264 صيدليا ؛ أي صيدلي واحد لكل 52323 نسمة. أما أطباء الأسنان ، فكانوا حوالي 151 طبيبا ، أي طبيب أسنان واحد لكل 70688 نسمة.
أما من حيث الهياكل القاعدية ، فقد كان هناك عجز كبير، حيث كان قبل سنة 1967 قرابة 39000 سرير بكامل مستشفيات الوطن، وما ميز هذه المرحلة هو الزيادة النسبية لقاعات العلاج مقارنة بسنة 1962.
وتميزت السياسة الصحية خلال هذه الفترة ، بمحدودية في خياراتها جراء ضعف الوسائل المتوفرة لها ، وكان ينبغي في أول الأمر إعادة إنعاش البنايات والهياكل التي خلفها الاستعمار، قبل توفير أدنى قسط من الخدمات الصحية للسكان ، ومن جانب آخر، كانت الدولة عازمة على تنمية سياسية على شكل إعانة تتمثل في الحملات التلقيحية لبعض الأمراض الفتاكة والمعدية.
كما تميزت هذه المرحلة من جهة ، بطب الدولة من خلال المؤسسات الإستشفائية التي تضمن العلاج والاستشفاء ، والتي تسيّر من طرف وزارة الصحة والمراكز الصحية التي تضمن المساعدة الطبية المجانية في المدن والبلديات ، وتسيّر من طرف البلديات. وأخيرا، مراكز النظافة المدرسية التي تسيّر من طرف وزارة التعليم.
كما تميزت هذه المرحلة من جهة ، بطب الدولة من خلال المؤسسات الإستشفائية التي تضمن العلاج والاستشفاء ، والتي تسيّر من طرف وزارة الصحة والمراكز الصحية التي تضمن المساعدة الطبية المجانية في المدن والبلديات ، وتسيّر من طرف البلديات. وأخيرا، مراكز النظافة المدرسية التي تسيّر من طرف وزارة التعليم.
ومن جهة أخرى، كان هناك قطاع طبي خاص يقدم علاجا وهو ذو طابع لبيرالي في العيادات الخاصة ، ولكن بإمكان الأطباء الخواص استعمال المؤسسات العمومية التابعة للدولة ، في إطار تعاقد هذا الخليط من الأنظمة ، ويتم التنسيق له من طرف مديرية دائرة الصحة.
مرحلة 1965 – 1979 وإعادة بعث نشاط المعهد الوطني للصحة العمومية مع بداية المخطط الوطني وبداية نشاط المعهد الوطني للصحة العمومية الذي أنشئ عام 1964، وبصدور الأمر المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة عام 1966، أخذت الأمور تتحسن شيئا فشيئا من خلال تحسين دفع عجلة التكوين الطبي والشبه الطبي، وكذا إنشاء بعض الهياكل القاعدية بين سنتي1967 و1969. وما ميّز هذه المرحلة التاريخية من جهة الهياكل القاعدية، هو مضاعفة قاعات العلاج بين سنتي 1969 و1979 محاولة من المسؤولين منح الأولوية العلاج الأولي ، وذلك عن طريق توفير قاعات العلاج والمراكز الصحية على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل حي. والهدف من هذه الهياكل القاعدية، هو قبل كل شيء الوقاية، نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري الشاب، وكذلك إنشاء العيادات متعددة الخدمات بداية من سنة 1974.
وبما أن نسبة 37 % من السكان فقط كانت ممونة بالمياه الصالحة للشرب، و23% تتوفر بها قنوات الصرف الصحي، وما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، لم تقف الدولة موقف المتفرج، بل أخذت التدابير من أجل تنفيذ بعض البرامج التي سطرت بهذا الشأن، والتي تعتبر ذات أولوية بالغة مثل؛ التكفل بالطب المجاني للأطفال من طرف الدولة، سواء في إطار مراكز حماية الطفولة والأمومة أو في إطار الطب المدرسي. كما صدر في هذه الأثناء مرسوم رقم 69 -96، المؤرخ في 9 جويلية سنة 1969 والقاضي بإلزامية التلقيح ومجانيته. هذه الأخيرة التي تعتبر خطوة إيجابية ترمي إلى القضاء على الأمراض المعدية. كما تم إقرار التكفل الشامل من طرف الدولة لمكافحة بعض الأوبئة، مثل مرض السل، من خلال إنشاء المراكز الخاصة بمكافحة مرض السل، ليصبح علاجه مجانيا، ونفس الشيء بالنسبة لمرض الشلل وسوء التغذية، فضلا عن عملية توزيع وتنظيم الولادات بمراكز حماية الأمومة والطفولة.
وميز هذه المرحلة التاريخية كذلك، بداية الحملات الوطنية للتلقيح 1969 -1970، التلقيح ضد الشلل، ومكافحة الملاريا بداية من سنة 1965 بالمناطق الوبائية، وذلك مع البرامج المسطرة من طرف منظمة الصحة العالمية. كما ضمت هذه المقاييس مكافحة مرض الرمد، والإعلان عنه إجباريا، بالإضافة إلى برنامج الحماية من حوادث العمل ووضع لجان النظافة والوقاية.
من ركائز المنظومة مجانية الطب والوقاية
كان قرار مجانية الطب خطوة أولى في طريق إعطاء فعالية أكثر للقطاع الصحي وتوحيد نظامه ككل ، ووضع برامج صحية، لها ارتباط وثيق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وذلك بتسخير كافة الوسائل والإجراءات لحماية الصحة وترقيتها، وتعميم مجانية العلاج الصحي.
من ركائز المنظومة مجانية الطب والوقاية
كان قرار مجانية الطب خطوة أولى في طريق إعطاء فعالية أكثر للقطاع الصحي وتوحيد نظامه ككل ، ووضع برامج صحية، لها ارتباط وثيق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وذلك بتسخير كافة الوسائل والإجراءات لحماية الصحة وترقيتها، وتعميم مجانية العلاج الصحي.
وانطلاقا من ذلك، أصبح العلاج مهمة وطنية يستوجب اتخاذ إجراءات هامة وحاسمة من أجل تدعيمها، خاصة في مجال التعليم والتكوين، والزيادة في عدد الهياكل القاعدية، مع التطبيق الصارم للتوازن الجهوي في ذلك. بموجب القرار السياسي الخاص بالطب المجاني في جميع القطاعات الصحية، وبالموازاة مع هذا، توحيد النظام الوطني للصحة وتطبيقه، وتبع هذا الإصلاح قرار وزاري مشترك صادر في جانفي 1974، تم بموجبه تحويل هياكل التعاضديات الفلاحية إلى مصالح الصحة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية على مستوى القطاعات الصحية والتكفل المالي بعمال الصحة من طرف الولايات، بعدما كانت تابعة للوزارة، وتحويل جميع المراكز الطبية الاجتماعية التي كانت تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي والتعاضديات إلى وزارة الصحة. وهكذا أصبح النظام الصحي الوطني يضم جميع الهياكل الصحية مهما كانت مهامها أو مجال نشاطاتها.
وفي هذا الإطار، نص الميثاق الوطني ل 1976، على حق المواطن في الطب المجاني، حيث جاء فيه «الطب المجاني مكسب ثوري وقاعدة لنشاط الصحة العمومية، وتعبير عملي عن التضامن الوطني، ووسيلة تجسد حق المواطن في العلاج». كما دعم دستور 1976 هذا الحق وذلك في المادة 67 منه، والتي تنص صراحة بأن "كل المواطنين لهم الحق في حماية صحتهم وهذا الحق مضمون بخدمات صحية عامة ومجانية وبتوسيع الطب الوقائي".
وبالرغم من حداثة الاستقلال والظروف الصعبة التي ميزت المرحلة وطنيا ودوليا -استطاعت الجزائر أن تحقق تطورا في القطاع الصحي، وهذا من خلال تشجيع التنمية البشرية وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية، وفي مقابل هذا التطور في الموارد البشرية، ظهرت عدة مشاكل تتمثل في هجرة الأدمغة خاصة الأطباء، تمركز الإطارات الطبية في المدن الكبرى، عدم التوازن في التخصصات بما فيها الطبية، قلة وتيرة التطور في التنمية البشرية، بحكم الحاجيات والتحديات محليا ودوليا.
أما بشأن تطور الموارد المادية، فتميزت هذه المرحلة بنوع من الاستقرار من حيث الهياكل القاعدية، ومع هذا، سُجل ارتفاع محسوس في عدد العيادات من متعددة الخدمات، من حيث هي همزة الوصل بين المراكز الصحية وقاعات العلاج من جهة، والمستشفيات والقطاعات الصحية من جهة أخرى.
إن المؤشرات الصحية لعام 1979 مثلا تؤكد بعض التطور المتمثل في معدل الوفيات الإجمالي 1 .15 من الألف، وفيات الأطفال 122 من الألف والولادات 46.5 من الألف، بينما ارتفع معدل العمر إلى 52.5 سنة.
أما بشأن تطور الموارد المادية، فتميزت هذه المرحلة بنوع من الاستقرار من حيث الهياكل القاعدية، ومع هذا، سُجل ارتفاع محسوس في عدد العيادات من متعددة الخدمات، من حيث هي همزة الوصل بين المراكز الصحية وقاعات العلاج من جهة، والمستشفيات والقطاعات الصحية من جهة أخرى.
إن المؤشرات الصحية لعام 1979 مثلا تؤكد بعض التطور المتمثل في معدل الوفيات الإجمالي 1 .15 من الألف، وفيات الأطفال 122 من الألف والولادات 46.5 من الألف، بينما ارتفع معدل العمر إلى 52.5 سنة.
كما تميز النظام الصحي في نهاية هذه المرحلة (1979) إلى حد ما بلامركزية حقيقية للعلاج، وإيصال واسع للعلاج للمواطن، وهذا بواسطة تدعيم القطاع الصحي في كل من الدائرة والولاية، والوقاية من الأمراض بالمناطق الريفية مع التكفل بالاستشفاء. وحتى يقوم القطاع الصحي من خلال المستشفى بالمهام المنوطة به، تم اقتراح ما يسمى بالقطاعات الصحية الفرعية، والتي تعد العيادة متعددة الخدمات المقر التقني الإداري لها. وبدأت ثمار إصلاح العلوم الطبية وإعادة ترتيب التكوين شبه الطبي، تظهر بوضوح، حيث لوحظ ارتفاع محسوس للسلك الطبي بمختلف رتبهم (كالأستاذ والأستاذ المحاضر، الأستاذ المساعد، الطبيب المختص، والطبيب العام، بالإضافة إلى أعوان شبه الطبي. ففي هذه السنة (1979)، بلغ عدد الهيئة الطبية الجزائرية 3761 طبيبا ، مقابل 2320 طبيبا أجنبيا، وهذا المجموع من الأطباء(6081) يضمنون تغطية صحية، تعادل طبيبا واحدا لكل 2960 نسمة.
ومن جهة أخرى، فإن عدد أعوان الشبه الطبي وصل إلى 46669 ممرضا وعونا بمختلف التخصصات والفروع، وهذا ما يمثل تغطية شبه طبية تتمثل في عون شبه طبي واحد لكل 386 نسمة. أما بشأن الموارد المادية، فنلاحظ ظهور هياكل جديدة من نمط العيادة متعددة الخدمات التي جاءت لإيصال العلاج لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والقضاء على الفواق بين المناطق، بالإضافة إلى بعض البناءات وإنجاز وتوسيع الهياكل القاعدية.
ومن جهة أخرى، فإن عدد أعوان الشبه الطبي وصل إلى 46669 ممرضا وعونا بمختلف التخصصات والفروع، وهذا ما يمثل تغطية شبه طبية تتمثل في عون شبه طبي واحد لكل 386 نسمة. أما بشأن الموارد المادية، فنلاحظ ظهور هياكل جديدة من نمط العيادة متعددة الخدمات التي جاءت لإيصال العلاج لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والقضاء على الفواق بين المناطق، بالإضافة إلى بعض البناءات وإنجاز وتوسيع الهياكل القاعدية.
السياسة الصحية 1979 - 2007
ما ميز هذه المرحلة هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة 1986، وهي المراكز الاستشفائية الجامعية، وفي نهاية الثمانينيات، جاء دستور 23 فيفري 1989 ليحدد تدخل الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية، كما نصت عليه المادة 51 من الدستور سالف الذكر، والتي تقول أن: «الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض المعدية وبمكافحتها، ويؤكد ذلك قانون المالية لسنة 1993، حيث نص على أنه بداية من هذه السنة، فإن مجال تدخل الدولة سيكون في الوقاية والتكفل بالمعوزين والتكوين، مع البحث في العلوم الطبية، أما باقي العلاجات، فتتم وفق اتفاق بين المؤسسات الاستشفائية وهيئات الضمان الاجتماعي،
كما عرفت هذه المرحلة إعادة تنظيم المؤسسات الصحية من حيث التنظيم والتسيير وذلك سنة 1997، من خلال المراسيم التنفيذية الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي سنة 2007، أعيد تنظيم القطاعات الصحية لتصبح المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية أي فصل الاستشفاء عن العلاج والفحص، وهي نوع من اللامركزية هدفها تسهيل الوصول إلى العلاج وتقريب المستشفى أو المؤسسة الصحية من المواطن.
وقد عرفت هذه المرحلة تطور عدد الهياكل القاعدية وكذا عدد المستخدمين.
أما المؤشرات الصحية الخاصة بسنة 2005، فقد عرفت تحسنا، لكنه غير كاف، وخير دليل على ذلك تقرير المنظمة العالمية للصحة بشأن الجزائر، حيث اعتبرت المنظمة أنه بالرغم من المبالغ المالية العمومية المرصودة للقطاع الصحي في الجزائر والمقدرة ب 9.1 ٪ من الميزانية العامة، إلا أن الخدمات الصحية لا سيما ما يتعلق بوفيات الأطفال، كانت دون المستوى، والسبب في ذلك عدم وجود سياسة واستراتيجية ناجعة، وسوء توزيع الأطباء والتفاوت، فيما يخص الرعاية الصحية. ومن أهم المؤشرات، نجد وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات 40.5 من الألف، حسب المنظمة وحسب الجزائر ، فهي 35.8 من الألف، بينما بلغ معدل الحياة 74.8 سنة، في الوقت الذي بلغت فيه التغطية التلقيحية ضد الشلل 98% ، الدفتيريا، الكزاز والسعال الديكي ب 87%، التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي 81 %، أما متوسط توزيع الأطباء، فنجد طبيبا واحدا تقريبا لكل ألف مواطن وأقل من سريرين لكل ألفي مواطن... فإذا كانت التغطية الطبية تقارب المتوسط العالمي على المستوى الكلي، فعلى المستوى الجزئي، نجد تفاوتا كبيرا بين الولايات والجهات، مما يترجم سوء توزيع الأطباء وعدم التحكم في التوازن الجهوي.
2012 سنة المكتسبات
يجمع المتتبعون للقطاع الصحي على أن هذا الأخير شهد قفزة متميزة من حيث الكم والنوع، بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع، غير أن هناك اختلالات مازالت تعتري مجال الصحة، حسب تقديرات المختصين.
وكانت العشرية (1992-2002) غنية بالإنجازات، حيث شهدت ميلاد عدة مؤسسات دعمت القطاع، على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ومعهد باستور ) الذي أصبح مخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة والتكوين حول مقاومة الجراثيم للضمادات الحيوية.
وتضاف إلى هذه المؤسسات الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للدم والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية والمركز الوطني لمكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي.
وتضاف إلى هذه المؤسسات الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للدم والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية والمركز الوطني لمكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي.
كما عرفت هذه المرحلة إعادة النظر في النصوص القانونية المسيرة للمؤسسات الصحية، بما فيها المستشفيات الجامعية والمؤسسات المتخصصة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تطبيق النظام المسير للنشاطات الإضافية بين القطاعين العمومي والخاص فضلا عن إعادة بعث البرامج الوطنية، تحديد سياسة للأدوية في مجال الاستيراد والتسجيل، المراقبة والتوزيع، وتخلي الدولة عن احتكارها للمواد الصيدلانية في المجال.
وتتمثل المرحلة الأخيرة الممتدة بين 2002 و2012 والتي أثبتت محدودية الخدمة بسبب معاناة المؤسسات من عدة اختلالات هيكلية وتنظيمية، مما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مبادرة سياسة إصلاح المستشفيات التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم العلاج بها.
وتتمثل المرحلة الأخيرة الممتدة بين 2002 و2012 والتي أثبتت محدودية الخدمة بسبب معاناة المؤسسات من عدة اختلالات هيكلية وتنظيمية، مما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مبادرة سياسة إصلاح المستشفيات التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم العلاج بها.
كما تهدف السياسة الجديدة إلى أنسنة وتأمين الخدمات وعصرنة النشاطات تماشيا مع الطلبات الجديدة ، مما يسمح بتوفير خدمة ذات نوعية، مع المحافظة على مبدئي العدالة والتضامن المكرسين من طرف الدولة.
وقد عرف القطاع من جانب آخر، انتقالا للوضعية الديموغرافية والوبائية للسكان، إلى تعزيز العلاج الجواري من أجل تقريب الصحة من المواطن، حيث باشرت السلطات العمومية في تطبيق تنظيم جديد للمؤسسات الصحية في سنة 2007، يهدف إلى فصل مهام المستشفيات الجامعية عن تلك التي تضمن علاجا قاعديا أسفر عن تأسيس الطب الجواري الذي قرب العلاج من المواطن. كما برز تقسيم جديد للمؤسسات الصحية، على غرار المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تشمل أيضا قاعات للعلاج والعيادات متعددة الخدمات. واستفاد القطاع من سنة 2005 إلى 2009 من غلاف مالي بقيمة 244 مليار دينار، تم استثماره في إنجاز 800 مؤسسة استشفائية وجوارية.
وبخصوص التغطية باللقاحات، حقق القطاع خلال العشرية الأخيرة عدة مكاسب، تمثلت في تعميم التغطية اللقاحية بنسبة 90 بالمائة، مما ساهم في القضاء على عدة أمراض خطيرة أدت خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى الوفيات والإعاقات إلى جانب القضاء على الأمراض المتنقلة وتراجع الوفيات لدى الأطفال إلى معدل حددته المنظمة العالمية للصحة، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الحوامل بنسبة 5 بالمائة كل سنة. فيما تعزز القطاع بتجهيزات طبية عصرية لعبت دورا هاما في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض المزمنة التي سجلت ظهورها خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على مواكبة المجتمع الجزائري للتحولات التي شهدتها المجتمعات المتقدمة ، فيما يتوقع المخطط التوجيهي للصحة للفترة بين 2009 – 2025 إستثمارات ب 20 مليار أورو لبناء مرافق صحية جديدة و كذا تحديث المستشفيات الموجودة في هذا الصدد ، ليتم الشروع في الإصلاحات المتعلقة على تفريد وظيفة صيانة البنى التحتية و معدات المستشفيات الموجودة ، و في هذا الصدد تم الشروع في الإصلاحات المتعلقة على تفريد وظيفة صيانة البنى التحتية و معدات المستشفيات و تدريب الهيئات الصحية . في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين 2010 – 2014 ، إستفاد القطاع الصحي من غلاف مالي قدر ب 619 مليار دينار جزائري ، حيث تعتزم الخطوط العريضة لهذا البرنامج إنجاز 172 مستشفى 45 مجمع صحي متخصص ، 377 مستوصف ، 1.000 قاعة علاج ، 17 مدرسة للتدريب شبه الطبي و أكثر من 70 مؤسسة متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أما فيما يخص القطاع العام ، فإن هذا الأخير يعرف نمو هائل في المكانة التي احتلها في النظام الصحي .
كشفت الوكالة الوطنية لتسيير المنشآت وتجهيز المؤسسات الصحية مؤخرا عن "النقائص" التي تشهدها 42 مؤسسة جاهزة على مستوى 38 ولاية، والتي سيتم التكفل بها مستقبلا، مضيفا أنّ الجزائر تتوفر على 77 ألف سرير من بينها 4 آلاف سرير خاص، وأنه سيتم "بلوغ مجموع 112 ألف سرير؛ مما سيسمح للبلد ببلوغ المعيار الدولي المقدر بـ 3.4 سرير لكل ألف ساكن"، منوّها أنّ انشغال الوزارة التي باشرت عمليات واسعة يكمن في مطابقة 73 مؤسسة صحية بالمعايير الدولية.
وقال مسؤولو الوكالة الوطنية لتسيير المنشآت وتجهيز المؤسسات الصحية "نحن واعون بأنّ نوعية العلاج تستدعي مطابقة مخابرنا وقاعات العمليات بالمعايير الدولية"، مشيرين إلى أنّ مجموع 1541 بلدية عبر الوطن تشهد تغطية صحية بـ 73 مؤسسة بطاقة استيعاب تتراوح ما بين 120 و240 سرير في الجنوب، و142 في الهضاب العليا، إلا أنه من المقرر إنجاز 100 مستشفى بطاقة استيعاب تتراوح ما بين 60 و240 سرير في الجنوب، و 144 في الهضاب العليا.
بعد سنوات من المعاناة .. الوزارة تتحرك أخير لتحليل واقع الصحة بالجنوب
ويأتي هذا قبل أن يعلن وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي تنقل إلى المنطقة قصد التحضير لملتقى وطني حول الصحة بالجنوب المزمع عقده بولاية ورقلة قريبا، من أجل تحليل واقع الصحة بالجنوب، وذلك من خلال التطرق إلى شبكة الهياكل الاستشفائية بالولايات الجنوبية والفرق الطبية العاملة في هذه المناطق، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الشروع في تحضير الأرضيات الخاصة بالمروحيات التي ستوجه لإسعاف المرضى، مبرزا أنّ هذا الملف الذي وصفه بـ" الثقيل" يتطلب تحضيرا "كبيرا" سواء تعلق الأمر بالجوانب التقنية أو البشرية أو المادية، موضحا "إمكانية" استخدام مروحيتين أو ثلاثة لتجسيد هذا المشروع في مرحلته الأولى، مع إيلاء الأولية للولايات الجنوبية.
كما أجبرت فضيحة عدم وجود مختصين بمستشفى عين صالح بالجنوب الجزائري وزير الصحة بالتعهد على وضع حجر أساس لبناء مستشفى يتسع لـ 120 سرير بهذه المدينة، وذلك في غضون الشهرين القادمين، مع التعهد أمام جموع من سكان عين صالح، الذين تواجدوا بمدخل المؤسسة الاستشفائية بتدعيم الطاقم الطبي بمدينتهم من خلال إيفاد عدد معتبر من الأطباء الأخصائيين وذلك عقب عملية توزيع 2400 طبيب مختص على المستوى الوطني، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بأطقم طبية من كوبا، في حالة عدم توفر العدد الكافي من الأخصائيين.
كما أجبرت فضيحة عدم وجود مختصين بمستشفى عين صالح بالجنوب الجزائري وزير الصحة بالتعهد على وضع حجر أساس لبناء مستشفى يتسع لـ 120 سرير بهذه المدينة، وذلك في غضون الشهرين القادمين، مع التعهد أمام جموع من سكان عين صالح، الذين تواجدوا بمدخل المؤسسة الاستشفائية بتدعيم الطاقم الطبي بمدينتهم من خلال إيفاد عدد معتبر من الأطباء الأخصائيين وذلك عقب عملية توزيع 2400 طبيب مختص على المستوى الوطني، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بأطقم طبية من كوبا، في حالة عدم توفر العدد الكافي من الأخصائيين.
وشدد بوضياف على أنّ الدولة تعطي الأولية للولايات الجنوبية تليها ولايات الهضاب العليا في مجال تدعيم خدمات الصحة، خاصة ما تعلق بتوفير الأطقم الطبية وبناء المؤسسات الاستشفائية، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين الأطباء من أداء واجبهم المهني، لاسيما ما تعلق بتجهيز المستشفيات وتوفير السكن اللائق لهم، مشيرا إلى استكمال 13 مسكنا وظيفيا خاصا بالأطباء بعين صالح.
للإشارة تعتبر الجزائر أول سوق للمواد الصيدلانية في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط 19672.75 مليون دولار من الواردات في عام 2011 . حددت الصناعة الصيدلانية في الجزائر لنفسها هدف تحسين آلياتها من أجل تحقيق جلب الاستثمار المحلي و الأجنبي بهدف ضمان تغطية السوق من الإنتاج المحلي لتصل إلى 70 بالمائة في عام 2014 و الذي عرف نمو قوي سريع و ثابت ، إضافة إلى ذلك وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتموين المؤسسات بالمواد الصيدلانية الموجهة لضمان التوفر الكامل و الدائم للأدوية ، يضاف هذا النظام إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتصفية قطاع توزيع الأدوية و تطوير و تحديث المنتجات "الحساسة "، تشمل نشاطات فرع المواد الصيدلانية مجالات : - التصنيع - توضيب السلع – بائعون بالجملة مستوردين – موزعون بالجملة – موزعون التجزئة " صيدليات و غيرها " ، علما أن واردات الجزائر في مجال الصيدلانية وصلت السنة المنقضية إلى 1 967 مليون دولار مقابل 492.53 مليون دولار خلال عام 2001 .
من جهة أخرى أفاد البروفيسور أسير طيبي بأن الجزائر صرفت أكثر من 70 مليار دولار خلال 11 سنة الماضية على قطاع الصحة في الجزائر " ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة" ، لكن تبقى المردودية والنوعية حسبه مغيبة وضعيفة ، من عدة نواحي تتصدرها سوء ظروف الاستقبال، ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين، وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، حيث أنّ قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أيّ أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي. وهذا ما يؤكده نقابيون أطباء ومهنيون في الصحة، الذين سلطوا في أكثر من مرة الضوء على تقارير سوداء تكشف المشاكل العديدة التي يعرفها قطاع الصحة بالجزائر، في وقت أضحت الرعاية الصحية تقدم بالرشاوى والمحاباة، والبيروقراطية في قلب العاصمة ، وأكبر المدن الجزائرية، فيما يترك الفقير والضعيف يواجه المرض وشبح الموت بصمت في هذه المستشفيات . وهنا نتساءل : كيف هي حالة المرضى الذين هم في أقصى الجنوب الذين تبعد عنهم مستشفيات العاصمة بآلاف الكيلومترات، في ظل غياب من يرفع شكاويهم أو ينقل معاناتهم، وهذا باعتراف المسؤولين أنفسهم.
فيما أشار الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ، أن البلاد تملك كل الإمكانيات لتوفير قطاع صحي في المستوى، ولكن لابد من إعادة النظر في بعض الجوانب الهامة، واستدراك بعض النقائص المسجلة والتي حطمت ثقة المواطن في القطاع.
وأضاف الدكتور بقاط ، الذي يرأس أيضا المنظمة الدائمة لعمادة الأطباء الأورو متوسطيين أن »الحل للوضعية المزرية التي آل إليها القطاع، يستلزم إعادة تامة لهيكلة المستشفيات الموجودة، أو بناء أخرى، والتفريق بالمرة بين تلك الموجهة لطب الكبار والأخرى الخاصة بطب الأطفال«.
ويرى نفس المتحدث أنه لابد من العمل على استعادة المواطن لثقته المفقودة بالمستشفيات والسلك الطبي، هذا بالحرص على "توفير الخدمات اللازمة، الاستقبال الجيد والتكفل الحسن به" .
وقال الدكتور بقاط أن على الدولة أن تزيد من الميزانية المخصصة سنويا للصحة، مع الاهتمام أكثر بتكوين الأطباء والممرضين وكذا عمال الإدارة.
وركز الدكتور « بصفة خاصة على » ضرورة تحديد المسؤوليات في الهرم الصحي، ودراسة كل المعطيات على الساحة الوطنية للتمكين من التقنين الجيد لقطاع الصحة«.
للإشارة تعتبر الجزائر أول سوق للمواد الصيدلانية في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط 19672.75 مليون دولار من الواردات في عام 2011 . حددت الصناعة الصيدلانية في الجزائر لنفسها هدف تحسين آلياتها من أجل تحقيق جلب الاستثمار المحلي و الأجنبي بهدف ضمان تغطية السوق من الإنتاج المحلي لتصل إلى 70 بالمائة في عام 2014 و الذي عرف نمو قوي سريع و ثابت ، إضافة إلى ذلك وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتموين المؤسسات بالمواد الصيدلانية الموجهة لضمان التوفر الكامل و الدائم للأدوية ، يضاف هذا النظام إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتصفية قطاع توزيع الأدوية و تطوير و تحديث المنتجات "الحساسة "، تشمل نشاطات فرع المواد الصيدلانية مجالات : - التصنيع - توضيب السلع – بائعون بالجملة مستوردين – موزعون بالجملة – موزعون التجزئة " صيدليات و غيرها " ، علما أن واردات الجزائر في مجال الصيدلانية وصلت السنة المنقضية إلى 1 967 مليون دولار مقابل 492.53 مليون دولار خلال عام 2001 .
من جهة أخرى أفاد البروفيسور أسير طيبي بأن الجزائر صرفت أكثر من 70 مليار دولار خلال 11 سنة الماضية على قطاع الصحة في الجزائر " ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة" ، لكن تبقى المردودية والنوعية حسبه مغيبة وضعيفة ، من عدة نواحي تتصدرها سوء ظروف الاستقبال، ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين، وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص، حيث أنّ قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أيّ أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي. وهذا ما يؤكده نقابيون أطباء ومهنيون في الصحة، الذين سلطوا في أكثر من مرة الضوء على تقارير سوداء تكشف المشاكل العديدة التي يعرفها قطاع الصحة بالجزائر، في وقت أضحت الرعاية الصحية تقدم بالرشاوى والمحاباة، والبيروقراطية في قلب العاصمة ، وأكبر المدن الجزائرية، فيما يترك الفقير والضعيف يواجه المرض وشبح الموت بصمت في هذه المستشفيات . وهنا نتساءل : كيف هي حالة المرضى الذين هم في أقصى الجنوب الذين تبعد عنهم مستشفيات العاصمة بآلاف الكيلومترات، في ظل غياب من يرفع شكاويهم أو ينقل معاناتهم، وهذا باعتراف المسؤولين أنفسهم.
فيما أشار الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ، أن البلاد تملك كل الإمكانيات لتوفير قطاع صحي في المستوى، ولكن لابد من إعادة النظر في بعض الجوانب الهامة، واستدراك بعض النقائص المسجلة والتي حطمت ثقة المواطن في القطاع.
وأضاف الدكتور بقاط ، الذي يرأس أيضا المنظمة الدائمة لعمادة الأطباء الأورو متوسطيين أن »الحل للوضعية المزرية التي آل إليها القطاع، يستلزم إعادة تامة لهيكلة المستشفيات الموجودة، أو بناء أخرى، والتفريق بالمرة بين تلك الموجهة لطب الكبار والأخرى الخاصة بطب الأطفال«.
ويرى نفس المتحدث أنه لابد من العمل على استعادة المواطن لثقته المفقودة بالمستشفيات والسلك الطبي، هذا بالحرص على "توفير الخدمات اللازمة، الاستقبال الجيد والتكفل الحسن به" .
وقال الدكتور بقاط أن على الدولة أن تزيد من الميزانية المخصصة سنويا للصحة، مع الاهتمام أكثر بتكوين الأطباء والممرضين وكذا عمال الإدارة.
وركز الدكتور « بصفة خاصة على » ضرورة تحديد المسؤوليات في الهرم الصحي، ودراسة كل المعطيات على الساحة الوطنية للتمكين من التقنين الجيد لقطاع الصحة«.
وأكد من جهة أخرى، على "أهمية التركيز الجيد على الوقاية، الذي من شأنه أن يساعد في تخفيض فاتورة الصحة، والتقليل من حدة انتشار الأمراض المزمنة والمتنقلة، التي أثقلت اليوم كاهل المواطن الجزائري ، وكذا خزينة الدولة".
ووقف الدكتور بقاط مطولا على واقع الصحة الأليم، ليركز على "أهمية تشبيب القطاع، وإعطاء الفرصة أكثر إلى الأطباء الجدد لإبراز قدراتهم، على شرط أن يعزز تكوينهم الميداني، بتوفير كل الإمكانيات الضرورية للتكفل الجيد بالمريض، وآداء واجبهم على أحسن وجه«.
وأكد في ذات السياق، أن الشباب هم مستقبل الصحة في الجزائر ، هذا القطاع الذي شهد رغم كل الانتقادات والنقائص تقدما ملحوظا منذ استرجاع الجزائر لسيادتها، بحيث قفز عدد الأطباء من 500 طبيب في 1962 إلى 55 ألف في 2012".
واستغرب الدكتور التدهور الذي يشهده القطاع بالرغم من الإمكانيات الضخمة والجبارة والأموال الطائلة التي تضخها الدولة سنويا، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أولته له البرامج الخماسية التي نص عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة«.
ونصح أيضا بإعادة دراسة توزيع الأطباء على التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكنه تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية والجنوب، هذا من أجل تخفيف الضغط على الأطباء الاستشفائية في المدن الكبرى ووضع حدّ لمعاناة المريض الجزائري
واعتبر من جهة أخرى، أن ثقة المواطن قد اهتزت كثيرا في القائمين على مراكز الصحة الجوارية، الأر الذي ولّد ضغطا كبيرا على المستشفيات الكبرى، إذ يجد المريض اليوم، سوء الاستقبال، نقص في الخدمات والأدوية والإمكانيات، مقابل التكفل الصحي الذي يطمح إليه«.
من جانبه أكد مكلف بالإعلام بمستشفى وهران السيد كمال بابو في تصريحه بأن التقرير الصحة العالمي الصادر مؤخرا عن البنك العالمي ، من أن الجزائر تضيع حوالي 20 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير و التكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية ، و يبلغ بذلك حجم إنفاق الدولة الجزائرية على الرعاية الصحية نسبة 8 بالمائة من ميزانيتها ، في مقابل 17 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة ، حيث قدر التقرير حجم الضياع الخاص بالنفقات على قطاع الصحة بما يعادل 20 بالمائة ، حيث تأتي الجزائر في نفس خانة عدة بلدان من الشرق الأوسط و شمال إفريقيا كواحدة من أدنى مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية ، و يتسبب في ذلك عدة مؤشرات منها سوء تسيير القطاع الصحي في الجزائر ، علما أنه جاء في هذا التقرير بأن " هناك تتباين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى ضعف جودتها في المستشفيات الجزائرية ، مما يهدد صحة المواطن و عدم تقبله لنوعية الرعاية الصحية التي يستفيد منها " ، التقرير الذي يحمل عنوان " العدالة و المساءلة : الانخراط في الأنظمة الصحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا " الصادر عن البنك العالمي ، يبرز بأن حكومة المنطقة لا تنفق سوى 8 في المائة في المتوسط من ميزانيتها على الرعاية الصحية ، مقابل 17 في المائة في المتوسط تنفقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ، و يمكن تغيير هذا الاتجاه عن طريق الاستثمار في أنظمة صحية عادلة تخضع للمساءلة ، وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي الجديد حول الصحة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، و بخصوص حالة الجزائر فإن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية ، تبين بأنه في منحنى تصاعدي ، حيث قفز من 79,5 بالمائة العام 2008 إلى 80,8 بالمائة العام 2011، لكنه يبقى مقارنة بالمؤشر المطلوب بعيدا، لأن الأموال والخدمة لا تصل إلى المواطن كما يجب، وتضيع بسبب سوء التسيير والفساد.
وحذّر البنك العالمي من هذا الوضع السائد في الجزائر، وأشار إلى أنه "يساند بناء أنظمة صحية عادلة وشفافة، يجب أن تشمل الرعاية الصحية في الجزائر".
وبلغة الأرقام، فإن العائلة الجزائرية تغطي الفرق من دخلها الخاص بما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي ، مقابل 14 في المائة في بلدان متطورة ، خاصة الأوروبية منها. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بكثير من المواطنين، إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة، أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها.
وتراجعت الجزائر مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية. وأمام هذا، أجرى البنك الدولي العديد من المشاورات لجمع معلومات ذات فاعلية تخدم محاور الإستراتيجية الجديدة، والتي تعتبر ضرورية لاستحداث أنظمة وخدمات صحية تتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة.
وألح البنك العالمي على ضرورة تمكين المواطن من المعلومات عن كيفية الأداء الجيد للأنظمة وكيفية تقديم الخدمات، وتحسين مستوى مسائلة المهنيين في قطاع الصحة عن طريق وضع حوافز مقابل تقديم رعاية صحية ووقائية جيدة ومحكمة التوقيت بتكلفة معقولة.
من جهته، أفاد تقرير الصحة في العالم بأن في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرّة، بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار، ومن بينها الجزائر. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حجم إنفاق الجزائري على الصحة من ميزانيته الخاصة بالدولار، تصل إلى 315 دولارا سنويا.
وخصصت السلطات الجزائرية ميزانيات معتبرة لقطاع الصحة، حيث تراوحت حسب التقديرات الإحصائية ما بين 270 وقرابة 307 مليار دينار، أي في حدود 3.31 إلى 3.75 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وإن كانت الحصة بعيدة عن المقاييس الدولية والجهوية، حيث تعادل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الخام الجزائري، أي كل ما ينتج من ثروة في الجزائر والمقدر حاليا بحوالي 208 مليار دولار. وتمثل نسبة 20 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع، ما بين 630 و750 مليون دولار سنويا .
فراغ قانوني يعرقل التكفّل بضحايا الأخطاء الطبّية
أمام حجم الأخطاء التي يرتكبها بعض أصحاب المآزر البيضاء في حقّ المرضى، والتي قد تودي بحياة بعضهم يبقى القانون الجزائري عاجزا عن التكفّل بضحايا هذه الأخطاء مهما بلغ حجم الضرر الذي يتعرّض له الضحية• حيث تثبت تقارير لبعض الهيئات والجمعيات المهتمّة بهذه المسائل أن قيمة التعويضات التي يقرّها القضاة للمتضرّرين في قضايا الأخطاء الطبّية لا تتوافق في الغالب مع حجم الضرر الحاصل، ناهيك عن الوقت الطويل الذي تستغرقه القضايا في المحاكم، والتي قد يصل بعضها إلى 13 سنة•
وتشير تقديرات المتتبّعين إلى أن 99 بالمائة من قضايا الأخطاء الطبّية في المحاكم تكون لصالح الأطبّاء، حيث لا يكلّف القاضي نفسه عناء استدعاء المتّهمين ولا الشهود، وهذا ما جعل القضاء يتستّر على الكثير من الجرائم الطبّية التي لازالت عالقة في المحاكم منذ أزيد من 13 سنة• ويرجع متتبّعون سبب هذه الأحكام القضائية التي تكون غير معقولة في بعض الأحيان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بوفاة أو تشوّه أو إعاقة دائمة إلى وجود فراغ قانوني صارخ، فيما يخص التكفّل بالأخطاء الجزائية الطبّية، ممّا يجعل القاضي يجد صعوبة في تحديد الخطأ ومعرفته ومن ثَمّ التمييز بين الخطأ الطّي وحجم الضرر الذي يتعرّض له المريض• وأجمع الكثير من المتخصّصين في هذا المجال من أساتذة جامعيين في الطبّ وأطبّاء متخصّصين وعامين ورجال قانون وقضاة بأن النصوص القانونية الحالية وغياب الخبرة الطبّية اللاّزمة على مستوى المؤسسات القضائية لا تساعد القاضي على معالجة قضية مطروحة أمامه متعلّقة بالخطأ الطبّي، ممّا طرح إشكالية الغموض في تحديد الخطأ الطبّي والتمييز بينه وبين الضرر، بالإضافة إلى التمييز بين الضرر الحاصل بسبب خطأ ارتكبه الطبيب والضرر الذي يحدث رغم قيام الطبيب بالدور المنوط به على أكمل وجه، ومع ذلك حصل ضرر للمريض لا دخل للطبيب المعالج فيه، وهو ما جعل بعض المختصّين يدعون إلى ضرورة استعانة القضاء بأطبّاء أكِفّاء بإمكانهم تحديد حجم الضرر ومعرفة إذا ما كان للطبيب المعالج يد فيه، هذا إلى جانب تكوين القضاة في بعض الاختصاصات التي تساعدهم على معالجة مثل هذه القضايا، زيادة عن العمل من أجل الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال للتكفّل بملف الأخطاء الطبّية بهدف ضمان حقّ ضحايا هذه الأخطاء وحماية الطبيب من تبعيات لم تكن له يد فيها•
تونس والطبّ البديل وِجهة المرضى في الجزائر
أمام الوضع المتردّي الذي يعيشه القطاع الصحّي في الجزائر وما يلاقيه المواطن من سوء استقبال وإهمال، بل ورفض لمعاينته حتى، لا سيّما فيما يتعلّق بالعلاج المتخصّص يلجأ الكثير من المواطنين إلى ما يعرف بالطبّ البديل أو التداوي بالأعشاب الذي أصبحت له شعبية كبيرة ويحقّق نتائج أفضل، حسب ما يفيد به الكثير من المرضى الذي يلجأون إلى مثل هذا النّوع من التداوي الذي صار يدرّ على ممتهنيه المال الوفير نتيجة للطلب المتزايد عليه• وقد قدّرت إحصائيات أن باعة الأعشاب الذين يمارس معظمهم الطبّ البديل في محلاّتهم قد بلغ نهاية السنة الفارطة حوالي 2000 تاجر ما بين ملاّك محلاّت وباعة متجوّلين في الأسواق• وبالرغم من خطورة التداوي ببعض الأعشاب على صحّة المواطن إلاّ أنها تبقى بديلا مقنعا للكثير من المرضى الذين لم يجدوا سبيلا إلى الطبّ المتخصّص في المستشفيات الحكومية، لتكون الأعشاب بذلك أقلّ تكلفة وإن كانت نتائجها غير مضمونة• وإلى جانب التداوي بالأعشاب برزت ظاهرة جديدة في الجزائر تمثّلت في التوجّه إلى الجارة تونس من أجل العلاج، لا سيّما من سكان الولايات الحدودية أو القريبة من الحدود الجزائرية التونسية كولاية وادي سوف التي يتوجّه سكانها بالآلاف إلى تونس من أجل العلاج ولأبسط الأمراض أحيانا كالجراحة من أجل استئصال الزائدة الدودية أو تضخّم الغدّة الدرقية، كل هذا نتيجة الوضع الكارثي الذي تعرفه المستشفيات العمومية في الولاية وغياب أبسط التخصّصات في القطاعين الخاص والعام، ما دفع ببعض الأطبّاء العامّين إلى امتهان بعض التخصّصات كطبّ النّساء والطبّ الداخلي علانية وبختم طبيب .
الطب البديل ومنافسته للطب الحديث
في ظل غياب أرقام وإحصائيات تؤكد انتصار الطب البديل على الطب الحديث في علاج العديد من الأمراض المستعصية على غرار السرطان، جعل علماء المهن الطبية الكلاسيكية يتساءلون عن جدوى إقحام كلمة «طب» في الطب البديل عوض تسميته الطب المتمم أو المكمل وهنا قاموا بطرح قضية مناقشة النوايا قبل مناقشة القضية بحد ذاتها، أين أجزموا أن نوايا المتخصصين في الطب البديل تتلخص في المكسب المادي فقط بهدف الترويج للبديل الطبيعي لان الأخير يتخصص في عدة مجالات أبرزها علم الأعشاب وعلوم الرياضة وتمارين الاسترخاء كما يتخصص أيضا في علم التغذية.
كما يرى ممتهنو الطب العادي أن الأمر أصبح يشكل خطرا على عقول من لا يملكون المعرفة الكافية التي تمكنهم من إعطاء الحكم الصحيح خاصة في الوقت الذي أصبح الأمر لا يقتصر فقط على وجود من يسمون أنفسهم بالمتخصصين في الطب البديل، بل تعدى الأمر ذلك إلى وجود متحدثين من بينهم يحملون شهادة الطب سواء كانوا أطباء بشريون متخصصين في «الطب الطبيعي» أو أطباء بشريون تحولوا إلى ممارسة الطب البديل بعد اقتناعهم بـ«فشل أو عدم جدوى الطب الكلاسيكي!»، معتبرين أن استخدام بعض وسائل الطب البديل في شفاء الأمراض المستعصية كالسرطان والعقم وغيرها ضرب من السحر!
كما يدعو هؤلاء إلى ضرورة توخي سبل الوقاية والعلاج، مشيرين إلى أن خلو المواد الطبيعية المستخدمة في الطب البديل من المواد الكيميائية مجرد «إيهام مضلل» وكل علاج طبيعي قد يحمل خطر الآثار الجانبية.
وجاء ردّ المتخصصين في الطب البديل، أنه لا يمكن الحكم على كافة طرق الطب البديل لكونها فعالة أم لا، لكننا كمسلمين لابد لنا من الإيمان بالطرق العلاجية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية كالعلاج بالقرآن والرقية الشرعية والعسل وحبة البركة وغيرها، كما أننا نحث الأطباء والباحثين على إجراء الأبحاث لمعرفة كيفية تأثير كل من هذه الطرق على الصحة والمرض.
ثلاثة مخطّطات لتطوير قطاع الصحّة
خلال السنوات الأخيرة بدأت السلطة تبدي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الصحّة وتحسين الخدمات، حيث أعلن وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مؤخّرا عن الشروع في تنفيذ ثلاثة مخطّطات بهدف تطوير آداء قطاع الصحّة في الجزائر•
ذكر الوزير لدى إشرافه على لقاء حضره مديرو الصحّة والسكان لولايات الوطن ومسؤولي المراكز الاستشفائية للوقوف على مدى تطبيق التوجيهات الرّامية إلى تحسين الآداء أن القطاع سيدخل مرحلة تجسيد ثلاثة مخطّطات من المنتظر أن تعطي ثمارا كبيرة في تطوير القطاع وتحسين آدائه من جانب الخدمة العمومية• كما ينتظر أن تحقّق المخطّطات التي سطّرتها الدولة بهدف تحسين قطاع الصحّة العمومية نتائج جيّدة، لا سيّما وأنها تضع يدها على الكثير من المسائل الحسّاسة التي طالما كانت سببا في المشكلات الكثيرة التي يتخبّط فيها القطاع، ما أدّى إلى حالة التسيّب والإهمال التي تسجّل اليوم في أغلب المؤسسات الاستشفائية• ومن بين أهداف المخطّطات التي ينتظر أن يتمّ تحقيقها قبل نهاية السنة الجارية تسوية أوضاع الحياة المهنية لمستخدمي القطاع وتطهير المالية وتصفية ديون المستشفيات، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الفحوص الطبّية المتخصّصة• ومن المنتظر في هذا الإطار أن يتمّ التكفّل بنحو 95 بالمائة من الحالات المطروحة بالنّسبة للمنازعات المتعلّقة بالترقية المهنية في مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحّة، فيما سيتمّ العمل على دفع 80 بالمائة من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد (باستور) التي هي على عاتق المؤسسات التابعة للقطاع• وإلى جانب ذلك سيسمح المخطّط الثالث بتسهيل الحصول على الفحوص الطبّية بنسبة 95 بالمائة من حجم الطلب المحلّي، خاصّة تلك المتعلّقة بطبّ أمراض النّساء والتوليد والجراحة العامّة وغيرها، كما سيتمّ تعزيز إمكانيات القطاع للتكفّل بالحوامل خلال المراحل التي تسبق الولادة• وستكون هذه الأهداف إن تحقّقت على أرض الواقع بمثابة حلقة الوصل التي سترمّم علاقة المواطن بقطاع الصحّة العمومية بعد الشرخ الذي حصل والنظرة السيّئة التي يكوّنها المواطن الجزائري على المؤسسات الاستشفائية العمومية نتيجة الإهمال وسوء الاستقبال والأخطاء الطبّية التي أودت بحياة الكثيرين، إلى جانب نقص في الخدمات والأدوية والإمكانيات• وتبقى معاناة المواطن مستمرّة باستمرار هذه الظروف في انتظار توفير التكفّل الصحّي الجيّد الذي يطمح إليه الجميع•
نقاط قوة السوق الجزائرية
• سوق دواء ديناميكي : بعد تزايد سجله بنسبة 27 بالمائة في عام 2015 خلال 5 سنوات .
• حماية الإنتاج المحلي عن طريق منع استيراد المنتجات المصنعة محليا وتعويض من فبل الضمان الإجتماعي على أساس تعرفة الأدوية الجنيسة ؛
• معدل ربح سريع للمشروع بنسبة 34٪ مع فترة إسترداد تصل إلى 6 سنوات.
مدارس ومراكز التكوين
هناك 27 مدرسة و مركز تكوين في القطاع العام و 17 في القطاع الخاص و الموزعة عبر 48 ولاية منها:
• المعهد الوطني للتدريب المتقدم للشبه طبي للجزائر العاصمة – الجزائر-
• مدرسة تدريب الشبه طبي- أدرار
• مدرسة تدريب الشبه طبي - الشلف
• مدرسة تدريب الشبه طبي - الأغواط
• مدرسة تدريب الشبه طبي باتنة
• مدرسة تدريب الشبه طبي لأوقاس -بجاية
• المعهد التكنولوجي للصحة العمومية - وهران
• مدرسة تدريب الشبه طبي بسكرة
• مدرسة تدريب الشبه طبي - بشار
• مدرسة تدريب الشبه طبي - البليدة
• مدرسة تدريب الشبه طبي -تمنراست
• تقدر النفقات الإجمالية التي جاء بها قانون المالية 2014 ب16ر7.656 مليار دينار جزائري (96.5 مليون دولار) بارتفاع قدره 28ر11 بالمائة مقارنة بنفقات قانون المالية لسنة 2013. يخصص نصفها للتسيير والذي ارتفعت نفقاته هو الأخر بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2013 و الباقي كنفقات تجهيز و الذي ارتفاع بمقدار 6ر15 بالمائة أيضاً وتعد ميزانية الصحة من كل هذا بما مقدراه 8 بالمائة فقط. ويبلغ حجم إنفاق الجزائر على الرعاية الصحية ما نسبته 8 بالمائة من ميزانيتها، في مقابل 17 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة.
• و خصصت السلطات الجزائرية ميزانيات معتبرة لقطاع الصحة، حيث تراوحت حسب التقديرات الإحصائية ما بين 270 وقرابة 307 مليار دينار جزائري ، أي في حدود 3.31 إلى 3.75 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
• وكان حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بالجزائر قد عرف منحى تصاعدي، حيث قفز من 79,5 بالمائة العام 2008 إلى 80,8 بالمائة العام 2011، لكنه يبقى مقارنة بالمؤشر المطلوب بعيدا، لأن الأموال والخدمة لا تصل إلى المواطن كما يجب، وتضيع بسبب سوء التسيير والفساد ومنه فما مقدراه 20 بالمائة يضيع بلا رقابة.
في سياق آخر نص المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد في الجزائر العديد من النقاط وهي كالتالي :
بطاقة صحية لكلّ جزائري ترافقه من الولادة إلى الوفاة
تنظيم إلزامية الفحص الوراثي وتحاليل الأمراض المزمنة قبل عقد الزواج
مراكز فحص بالحدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية
تستحدث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بطاقة مغناطسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن تتابعه منذ الولادة إلى غاية الوفاة، فيما تقرر تقنين الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج، بعد أن كان غير إجباري، بالموازاة مع فرض عقوبات ردعية في حق المتلاعبين بالصحة العمومية تصل إلى 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ 200 مليون.
ركز المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 402 مادة على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة، ومراجعة الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.
البطاقة المغناطيسية إلزامية عند كل فحص
وتضمنت المادة 20 من هذا القانون استحداث بطاقة مغناطيسية لكل شخص تسجل فيها المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية منذ الولادة إلى غاية الوفاة. وتشترط عند كل فحص أو علاج من قبل الطبيب المرجعي، حيث سيتم إعادة الاعتبار إلى مفهوم طبيب العائلة، حيث سيجبر جميع المواطنين على تكوين ملف طبي لدى أقرب مستشفى، قبل أن يتم استخراج بطاقته المغناطيسية، وبالتالي يكون طبيب العائلة الذي بحوزته الملف الطبي للمريض هو المخول بمتابعة وضعه الصحي، أي أنه لا يمكن لأي مريض العلاج عند طبيب مختص خارج المستشفى العمومي من دون المرور على الطبيب العام، وهذا الأخير هو المسؤول عن الترخيص له وذلك وفقا لشبكات الخدمات الطبية.
وبالمقابل قنن مشروع القانون الجديد الفحوصات الطبية الوراثية قبل الزواج، بعدما كان "الشرط" غير إلزامي في عقود الزواج خلال الفترة السابقة، حيث حدد ذلك في المادة 42 التي تنص على أنه قصد استكشاف الأمراض الوراثية، أو المعدية وكذا الأمراض المزمنة، يلزم إجباريا المقبلون على الزواج بفحص طبي سابق للقران تسلم نتائج الفحوص والتحاليل للمعنيين، بصفة فردية وسرية تحدد قائمة هذه الفحوصات والتحاليل عن طريق التنظيم.
10 سنوات سجنا للمتسببين في تسمم المواطنين
كما أقرّ مشروع القانون الجديد للصحة في شقه المتعلق بالممارسة الطبية الشرعية، عقوبات صارمة ومشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد كل من أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي، كما تفرض على المخالف غرامات مالية تتراوح بين 200.000 دج و 200 مليون سنتيم.
ولمحاربة انتقال الأمراض المعدية، تضمنت المواد المتعلقة بالمراقبة الصحية عند الحدود في القانون الجديد للصحة، إنشاء مراكز للمراقبة الصحية عند الحدود حيث ستمارس مصالح المراقبة نشاطها على مستوى الموانئ والمطارات والأماكن التي تراقب فيها مداخل التراب الوطني عبر الطرق أو السكة الحديدية، والهدف من هذه المراقبة الصحية هو الوقاية من انتشار جميع الأمراض المتنقلة برا أو جوا أو بحرا.
وتتكون مصلحة المراقبة الصحية حسب المادة 81 من نفس القانون من أطباء وأعوان مراقبة صحية ومحلفين طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يقوم المعنيون بالتعاون مع المصالح المعنية بإجراء التحقيقات والبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الصحة، كما يتخذون التدابير الوقائية اللازمة لحظر دخول أو استيراد مواد ذات مصدر حيواني أو نباتي أو أي مادة أخرى قد تكون لها آثار مضرة بالصحة حسب المادة 82.
سحب الاعتماد من مصنعي ومستوردي التبغ في حال التلاعب
وسيتعرض مستوردو ومصنعو التبغ لسحب الاعتماد في حال الإخلال بالإجراءات المعمول بها، من عدم تسجيل ملاحظة "التدخين مضر بالصحة"، على غلاف علب السجائر، مع نشر العبارة التحذيرية مرتين على التعليب وبشكل مميز، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية ما بين 20 مليونا و200 مليون سنتيم، حسب ما تضمنه القانون الجديد للصحة.
استحداث مقاطعات صحية
كما ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار إلى مفهوم هرم الخدمات الصحية من القاعدة إلى القمة، وفي إطار إقليم معين، عبر استحداث نمط جديد تحت تسمية المقاطعة أو الناحية الصحية، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة "أي بمعنى إقليم صحي له حدود معينة"، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا".
المقاطعات الصحية التي يقترحها مشروع النص يديرها "مجلس توجيهي" يرأسه مدير عام ولائي ومدير على مستوى كل دائرة، ويسير المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمختصة.
مشروع القانون يقترح تعديلات على بعض المناصب الإدارية، مع إمكانية استحداث أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات، ومن أهم المهام الموكلة إلى هذه المقاطعات ترقية وضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، كما من المزمع أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاع شبه الطبي والتكوين، وتقسم كل مقاطعة إلى 3 وحدات صحية لكل منها مدير وبها طبيب منسق يساعده طبيب "متابع" سيكون بمثابة طبيب العائلة، بحيث يتابع كل مريض في جميع مراحل العلاج عبر حياته.
إلزام الممارسين الطبيين بالعمل 3 سنوات قبل الاستقالة أو التحويل
وفي الشق المتعلق بالخدمة المدنية في القطاع، تقرر إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84/10 المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيكون توظيف الممارسين المختصين من مهام المؤسسات العمومية والصحة. كما تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، ويلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة 3 سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل حسب المادة 292 من مشروع القانون .
حنان لعروسي
ووقف الدكتور بقاط مطولا على واقع الصحة الأليم، ليركز على "أهمية تشبيب القطاع، وإعطاء الفرصة أكثر إلى الأطباء الجدد لإبراز قدراتهم، على شرط أن يعزز تكوينهم الميداني، بتوفير كل الإمكانيات الضرورية للتكفل الجيد بالمريض، وآداء واجبهم على أحسن وجه«.
وأكد في ذات السياق، أن الشباب هم مستقبل الصحة في الجزائر ، هذا القطاع الذي شهد رغم كل الانتقادات والنقائص تقدما ملحوظا منذ استرجاع الجزائر لسيادتها، بحيث قفز عدد الأطباء من 500 طبيب في 1962 إلى 55 ألف في 2012".
واستغرب الدكتور التدهور الذي يشهده القطاع بالرغم من الإمكانيات الضخمة والجبارة والأموال الطائلة التي تضخها الدولة سنويا، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أولته له البرامج الخماسية التي نص عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة«.
ونصح أيضا بإعادة دراسة توزيع الأطباء على التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكنه تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية والجنوب، هذا من أجل تخفيف الضغط على الأطباء الاستشفائية في المدن الكبرى ووضع حدّ لمعاناة المريض الجزائري
واعتبر من جهة أخرى، أن ثقة المواطن قد اهتزت كثيرا في القائمين على مراكز الصحة الجوارية، الأر الذي ولّد ضغطا كبيرا على المستشفيات الكبرى، إذ يجد المريض اليوم، سوء الاستقبال، نقص في الخدمات والأدوية والإمكانيات، مقابل التكفل الصحي الذي يطمح إليه«.
من جانبه أكد مكلف بالإعلام بمستشفى وهران السيد كمال بابو في تصريحه بأن التقرير الصحة العالمي الصادر مؤخرا عن البنك العالمي ، من أن الجزائر تضيع حوالي 20 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير و التكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية ، و يبلغ بذلك حجم إنفاق الدولة الجزائرية على الرعاية الصحية نسبة 8 بالمائة من ميزانيتها ، في مقابل 17 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة ، حيث قدر التقرير حجم الضياع الخاص بالنفقات على قطاع الصحة بما يعادل 20 بالمائة ، حيث تأتي الجزائر في نفس خانة عدة بلدان من الشرق الأوسط و شمال إفريقيا كواحدة من أدنى مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية ، و يتسبب في ذلك عدة مؤشرات منها سوء تسيير القطاع الصحي في الجزائر ، علما أنه جاء في هذا التقرير بأن " هناك تتباين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ، بالإضافة إلى ضعف جودتها في المستشفيات الجزائرية ، مما يهدد صحة المواطن و عدم تقبله لنوعية الرعاية الصحية التي يستفيد منها " ، التقرير الذي يحمل عنوان " العدالة و المساءلة : الانخراط في الأنظمة الصحية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا " الصادر عن البنك العالمي ، يبرز بأن حكومة المنطقة لا تنفق سوى 8 في المائة في المتوسط من ميزانيتها على الرعاية الصحية ، مقابل 17 في المائة في المتوسط تنفقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ، و يمكن تغيير هذا الاتجاه عن طريق الاستثمار في أنظمة صحية عادلة تخضع للمساءلة ، وفقا لما جاء في تقرير البنك الدولي الجديد حول الصحة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، و بخصوص حالة الجزائر فإن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية ، تبين بأنه في منحنى تصاعدي ، حيث قفز من 79,5 بالمائة العام 2008 إلى 80,8 بالمائة العام 2011، لكنه يبقى مقارنة بالمؤشر المطلوب بعيدا، لأن الأموال والخدمة لا تصل إلى المواطن كما يجب، وتضيع بسبب سوء التسيير والفساد.
وحذّر البنك العالمي من هذا الوضع السائد في الجزائر، وأشار إلى أنه "يساند بناء أنظمة صحية عادلة وشفافة، يجب أن تشمل الرعاية الصحية في الجزائر".
وبلغة الأرقام، فإن العائلة الجزائرية تغطي الفرق من دخلها الخاص بما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي ، مقابل 14 في المائة في بلدان متطورة ، خاصة الأوروبية منها. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بكثير من المواطنين، إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة، أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها.
وتراجعت الجزائر مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية. وأمام هذا، أجرى البنك الدولي العديد من المشاورات لجمع معلومات ذات فاعلية تخدم محاور الإستراتيجية الجديدة، والتي تعتبر ضرورية لاستحداث أنظمة وخدمات صحية تتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة.
وألح البنك العالمي على ضرورة تمكين المواطن من المعلومات عن كيفية الأداء الجيد للأنظمة وكيفية تقديم الخدمات، وتحسين مستوى مسائلة المهنيين في قطاع الصحة عن طريق وضع حوافز مقابل تقديم رعاية صحية ووقائية جيدة ومحكمة التوقيت بتكلفة معقولة.
من جهته، أفاد تقرير الصحة في العالم بأن في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرّة، بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار، ومن بينها الجزائر. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حجم إنفاق الجزائري على الصحة من ميزانيته الخاصة بالدولار، تصل إلى 315 دولارا سنويا.
وخصصت السلطات الجزائرية ميزانيات معتبرة لقطاع الصحة، حيث تراوحت حسب التقديرات الإحصائية ما بين 270 وقرابة 307 مليار دينار، أي في حدود 3.31 إلى 3.75 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وإن كانت الحصة بعيدة عن المقاييس الدولية والجهوية، حيث تعادل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الخام الجزائري، أي كل ما ينتج من ثروة في الجزائر والمقدر حاليا بحوالي 208 مليار دولار. وتمثل نسبة 20 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع، ما بين 630 و750 مليون دولار سنويا .
فراغ قانوني يعرقل التكفّل بضحايا الأخطاء الطبّية
أمام حجم الأخطاء التي يرتكبها بعض أصحاب المآزر البيضاء في حقّ المرضى، والتي قد تودي بحياة بعضهم يبقى القانون الجزائري عاجزا عن التكفّل بضحايا هذه الأخطاء مهما بلغ حجم الضرر الذي يتعرّض له الضحية• حيث تثبت تقارير لبعض الهيئات والجمعيات المهتمّة بهذه المسائل أن قيمة التعويضات التي يقرّها القضاة للمتضرّرين في قضايا الأخطاء الطبّية لا تتوافق في الغالب مع حجم الضرر الحاصل، ناهيك عن الوقت الطويل الذي تستغرقه القضايا في المحاكم، والتي قد يصل بعضها إلى 13 سنة•
وتشير تقديرات المتتبّعين إلى أن 99 بالمائة من قضايا الأخطاء الطبّية في المحاكم تكون لصالح الأطبّاء، حيث لا يكلّف القاضي نفسه عناء استدعاء المتّهمين ولا الشهود، وهذا ما جعل القضاء يتستّر على الكثير من الجرائم الطبّية التي لازالت عالقة في المحاكم منذ أزيد من 13 سنة• ويرجع متتبّعون سبب هذه الأحكام القضائية التي تكون غير معقولة في بعض الأحيان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بوفاة أو تشوّه أو إعاقة دائمة إلى وجود فراغ قانوني صارخ، فيما يخص التكفّل بالأخطاء الجزائية الطبّية، ممّا يجعل القاضي يجد صعوبة في تحديد الخطأ ومعرفته ومن ثَمّ التمييز بين الخطأ الطّي وحجم الضرر الذي يتعرّض له المريض• وأجمع الكثير من المتخصّصين في هذا المجال من أساتذة جامعيين في الطبّ وأطبّاء متخصّصين وعامين ورجال قانون وقضاة بأن النصوص القانونية الحالية وغياب الخبرة الطبّية اللاّزمة على مستوى المؤسسات القضائية لا تساعد القاضي على معالجة قضية مطروحة أمامه متعلّقة بالخطأ الطبّي، ممّا طرح إشكالية الغموض في تحديد الخطأ الطبّي والتمييز بينه وبين الضرر، بالإضافة إلى التمييز بين الضرر الحاصل بسبب خطأ ارتكبه الطبيب والضرر الذي يحدث رغم قيام الطبيب بالدور المنوط به على أكمل وجه، ومع ذلك حصل ضرر للمريض لا دخل للطبيب المعالج فيه، وهو ما جعل بعض المختصّين يدعون إلى ضرورة استعانة القضاء بأطبّاء أكِفّاء بإمكانهم تحديد حجم الضرر ومعرفة إذا ما كان للطبيب المعالج يد فيه، هذا إلى جانب تكوين القضاة في بعض الاختصاصات التي تساعدهم على معالجة مثل هذه القضايا، زيادة عن العمل من أجل الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال للتكفّل بملف الأخطاء الطبّية بهدف ضمان حقّ ضحايا هذه الأخطاء وحماية الطبيب من تبعيات لم تكن له يد فيها•
تونس والطبّ البديل وِجهة المرضى في الجزائر
أمام الوضع المتردّي الذي يعيشه القطاع الصحّي في الجزائر وما يلاقيه المواطن من سوء استقبال وإهمال، بل ورفض لمعاينته حتى، لا سيّما فيما يتعلّق بالعلاج المتخصّص يلجأ الكثير من المواطنين إلى ما يعرف بالطبّ البديل أو التداوي بالأعشاب الذي أصبحت له شعبية كبيرة ويحقّق نتائج أفضل، حسب ما يفيد به الكثير من المرضى الذي يلجأون إلى مثل هذا النّوع من التداوي الذي صار يدرّ على ممتهنيه المال الوفير نتيجة للطلب المتزايد عليه• وقد قدّرت إحصائيات أن باعة الأعشاب الذين يمارس معظمهم الطبّ البديل في محلاّتهم قد بلغ نهاية السنة الفارطة حوالي 2000 تاجر ما بين ملاّك محلاّت وباعة متجوّلين في الأسواق• وبالرغم من خطورة التداوي ببعض الأعشاب على صحّة المواطن إلاّ أنها تبقى بديلا مقنعا للكثير من المرضى الذين لم يجدوا سبيلا إلى الطبّ المتخصّص في المستشفيات الحكومية، لتكون الأعشاب بذلك أقلّ تكلفة وإن كانت نتائجها غير مضمونة• وإلى جانب التداوي بالأعشاب برزت ظاهرة جديدة في الجزائر تمثّلت في التوجّه إلى الجارة تونس من أجل العلاج، لا سيّما من سكان الولايات الحدودية أو القريبة من الحدود الجزائرية التونسية كولاية وادي سوف التي يتوجّه سكانها بالآلاف إلى تونس من أجل العلاج ولأبسط الأمراض أحيانا كالجراحة من أجل استئصال الزائدة الدودية أو تضخّم الغدّة الدرقية، كل هذا نتيجة الوضع الكارثي الذي تعرفه المستشفيات العمومية في الولاية وغياب أبسط التخصّصات في القطاعين الخاص والعام، ما دفع ببعض الأطبّاء العامّين إلى امتهان بعض التخصّصات كطبّ النّساء والطبّ الداخلي علانية وبختم طبيب .
الطب البديل ومنافسته للطب الحديث
في ظل غياب أرقام وإحصائيات تؤكد انتصار الطب البديل على الطب الحديث في علاج العديد من الأمراض المستعصية على غرار السرطان، جعل علماء المهن الطبية الكلاسيكية يتساءلون عن جدوى إقحام كلمة «طب» في الطب البديل عوض تسميته الطب المتمم أو المكمل وهنا قاموا بطرح قضية مناقشة النوايا قبل مناقشة القضية بحد ذاتها، أين أجزموا أن نوايا المتخصصين في الطب البديل تتلخص في المكسب المادي فقط بهدف الترويج للبديل الطبيعي لان الأخير يتخصص في عدة مجالات أبرزها علم الأعشاب وعلوم الرياضة وتمارين الاسترخاء كما يتخصص أيضا في علم التغذية.
كما يرى ممتهنو الطب العادي أن الأمر أصبح يشكل خطرا على عقول من لا يملكون المعرفة الكافية التي تمكنهم من إعطاء الحكم الصحيح خاصة في الوقت الذي أصبح الأمر لا يقتصر فقط على وجود من يسمون أنفسهم بالمتخصصين في الطب البديل، بل تعدى الأمر ذلك إلى وجود متحدثين من بينهم يحملون شهادة الطب سواء كانوا أطباء بشريون متخصصين في «الطب الطبيعي» أو أطباء بشريون تحولوا إلى ممارسة الطب البديل بعد اقتناعهم بـ«فشل أو عدم جدوى الطب الكلاسيكي!»، معتبرين أن استخدام بعض وسائل الطب البديل في شفاء الأمراض المستعصية كالسرطان والعقم وغيرها ضرب من السحر!
كما يدعو هؤلاء إلى ضرورة توخي سبل الوقاية والعلاج، مشيرين إلى أن خلو المواد الطبيعية المستخدمة في الطب البديل من المواد الكيميائية مجرد «إيهام مضلل» وكل علاج طبيعي قد يحمل خطر الآثار الجانبية.
وجاء ردّ المتخصصين في الطب البديل، أنه لا يمكن الحكم على كافة طرق الطب البديل لكونها فعالة أم لا، لكننا كمسلمين لابد لنا من الإيمان بالطرق العلاجية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية كالعلاج بالقرآن والرقية الشرعية والعسل وحبة البركة وغيرها، كما أننا نحث الأطباء والباحثين على إجراء الأبحاث لمعرفة كيفية تأثير كل من هذه الطرق على الصحة والمرض.
ثلاثة مخطّطات لتطوير قطاع الصحّة
خلال السنوات الأخيرة بدأت السلطة تبدي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الصحّة وتحسين الخدمات، حيث أعلن وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مؤخّرا عن الشروع في تنفيذ ثلاثة مخطّطات بهدف تطوير آداء قطاع الصحّة في الجزائر•
ذكر الوزير لدى إشرافه على لقاء حضره مديرو الصحّة والسكان لولايات الوطن ومسؤولي المراكز الاستشفائية للوقوف على مدى تطبيق التوجيهات الرّامية إلى تحسين الآداء أن القطاع سيدخل مرحلة تجسيد ثلاثة مخطّطات من المنتظر أن تعطي ثمارا كبيرة في تطوير القطاع وتحسين آدائه من جانب الخدمة العمومية• كما ينتظر أن تحقّق المخطّطات التي سطّرتها الدولة بهدف تحسين قطاع الصحّة العمومية نتائج جيّدة، لا سيّما وأنها تضع يدها على الكثير من المسائل الحسّاسة التي طالما كانت سببا في المشكلات الكثيرة التي يتخبّط فيها القطاع، ما أدّى إلى حالة التسيّب والإهمال التي تسجّل اليوم في أغلب المؤسسات الاستشفائية• ومن بين أهداف المخطّطات التي ينتظر أن يتمّ تحقيقها قبل نهاية السنة الجارية تسوية أوضاع الحياة المهنية لمستخدمي القطاع وتطهير المالية وتصفية ديون المستشفيات، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الفحوص الطبّية المتخصّصة• ومن المنتظر في هذا الإطار أن يتمّ التكفّل بنحو 95 بالمائة من الحالات المطروحة بالنّسبة للمنازعات المتعلّقة بالترقية المهنية في مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحّة، فيما سيتمّ العمل على دفع 80 بالمائة من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد (باستور) التي هي على عاتق المؤسسات التابعة للقطاع• وإلى جانب ذلك سيسمح المخطّط الثالث بتسهيل الحصول على الفحوص الطبّية بنسبة 95 بالمائة من حجم الطلب المحلّي، خاصّة تلك المتعلّقة بطبّ أمراض النّساء والتوليد والجراحة العامّة وغيرها، كما سيتمّ تعزيز إمكانيات القطاع للتكفّل بالحوامل خلال المراحل التي تسبق الولادة• وستكون هذه الأهداف إن تحقّقت على أرض الواقع بمثابة حلقة الوصل التي سترمّم علاقة المواطن بقطاع الصحّة العمومية بعد الشرخ الذي حصل والنظرة السيّئة التي يكوّنها المواطن الجزائري على المؤسسات الاستشفائية العمومية نتيجة الإهمال وسوء الاستقبال والأخطاء الطبّية التي أودت بحياة الكثيرين، إلى جانب نقص في الخدمات والأدوية والإمكانيات• وتبقى معاناة المواطن مستمرّة باستمرار هذه الظروف في انتظار توفير التكفّل الصحّي الجيّد الذي يطمح إليه الجميع•
نقاط قوة السوق الجزائرية
• سوق دواء ديناميكي : بعد تزايد سجله بنسبة 27 بالمائة في عام 2015 خلال 5 سنوات .
• حماية الإنتاج المحلي عن طريق منع استيراد المنتجات المصنعة محليا وتعويض من فبل الضمان الإجتماعي على أساس تعرفة الأدوية الجنيسة ؛
• معدل ربح سريع للمشروع بنسبة 34٪ مع فترة إسترداد تصل إلى 6 سنوات.
مدارس ومراكز التكوين
هناك 27 مدرسة و مركز تكوين في القطاع العام و 17 في القطاع الخاص و الموزعة عبر 48 ولاية منها:
• المعهد الوطني للتدريب المتقدم للشبه طبي للجزائر العاصمة – الجزائر-
• مدرسة تدريب الشبه طبي- أدرار
• مدرسة تدريب الشبه طبي - الشلف
• مدرسة تدريب الشبه طبي - الأغواط
• مدرسة تدريب الشبه طبي باتنة
• مدرسة تدريب الشبه طبي لأوقاس -بجاية
• المعهد التكنولوجي للصحة العمومية - وهران
• مدرسة تدريب الشبه طبي بسكرة
• مدرسة تدريب الشبه طبي - بشار
• مدرسة تدريب الشبه طبي - البليدة
• مدرسة تدريب الشبه طبي -تمنراست
• تقدر النفقات الإجمالية التي جاء بها قانون المالية 2014 ب16ر7.656 مليار دينار جزائري (96.5 مليون دولار) بارتفاع قدره 28ر11 بالمائة مقارنة بنفقات قانون المالية لسنة 2013. يخصص نصفها للتسيير والذي ارتفعت نفقاته هو الأخر بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2013 و الباقي كنفقات تجهيز و الذي ارتفاع بمقدار 6ر15 بالمائة أيضاً وتعد ميزانية الصحة من كل هذا بما مقدراه 8 بالمائة فقط. ويبلغ حجم إنفاق الجزائر على الرعاية الصحية ما نسبته 8 بالمائة من ميزانيتها، في مقابل 17 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة.
• و خصصت السلطات الجزائرية ميزانيات معتبرة لقطاع الصحة، حيث تراوحت حسب التقديرات الإحصائية ما بين 270 وقرابة 307 مليار دينار جزائري ، أي في حدود 3.31 إلى 3.75 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
• وكان حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بالجزائر قد عرف منحى تصاعدي، حيث قفز من 79,5 بالمائة العام 2008 إلى 80,8 بالمائة العام 2011، لكنه يبقى مقارنة بالمؤشر المطلوب بعيدا، لأن الأموال والخدمة لا تصل إلى المواطن كما يجب، وتضيع بسبب سوء التسيير والفساد ومنه فما مقدراه 20 بالمائة يضيع بلا رقابة.
في سياق آخر نص المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد في الجزائر العديد من النقاط وهي كالتالي :
بطاقة صحية لكلّ جزائري ترافقه من الولادة إلى الوفاة
تنظيم إلزامية الفحص الوراثي وتحاليل الأمراض المزمنة قبل عقد الزواج
مراكز فحص بالحدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية
تستحدث وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بطاقة مغناطسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن تتابعه منذ الولادة إلى غاية الوفاة، فيما تقرر تقنين الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج، بعد أن كان غير إجباري، بالموازاة مع فرض عقوبات ردعية في حق المتلاعبين بالصحة العمومية تصل إلى 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ 200 مليون.
ركز المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 402 مادة على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة، ومراجعة الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.
البطاقة المغناطيسية إلزامية عند كل فحص
وتضمنت المادة 20 من هذا القانون استحداث بطاقة مغناطيسية لكل شخص تسجل فيها المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية منذ الولادة إلى غاية الوفاة. وتشترط عند كل فحص أو علاج من قبل الطبيب المرجعي، حيث سيتم إعادة الاعتبار إلى مفهوم طبيب العائلة، حيث سيجبر جميع المواطنين على تكوين ملف طبي لدى أقرب مستشفى، قبل أن يتم استخراج بطاقته المغناطيسية، وبالتالي يكون طبيب العائلة الذي بحوزته الملف الطبي للمريض هو المخول بمتابعة وضعه الصحي، أي أنه لا يمكن لأي مريض العلاج عند طبيب مختص خارج المستشفى العمومي من دون المرور على الطبيب العام، وهذا الأخير هو المسؤول عن الترخيص له وذلك وفقا لشبكات الخدمات الطبية.
وبالمقابل قنن مشروع القانون الجديد الفحوصات الطبية الوراثية قبل الزواج، بعدما كان "الشرط" غير إلزامي في عقود الزواج خلال الفترة السابقة، حيث حدد ذلك في المادة 42 التي تنص على أنه قصد استكشاف الأمراض الوراثية، أو المعدية وكذا الأمراض المزمنة، يلزم إجباريا المقبلون على الزواج بفحص طبي سابق للقران تسلم نتائج الفحوص والتحاليل للمعنيين، بصفة فردية وسرية تحدد قائمة هذه الفحوصات والتحاليل عن طريق التنظيم.
10 سنوات سجنا للمتسببين في تسمم المواطنين
كما أقرّ مشروع القانون الجديد للصحة في شقه المتعلق بالممارسة الطبية الشرعية، عقوبات صارمة ومشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد كل من أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي، كما تفرض على المخالف غرامات مالية تتراوح بين 200.000 دج و 200 مليون سنتيم.
ولمحاربة انتقال الأمراض المعدية، تضمنت المواد المتعلقة بالمراقبة الصحية عند الحدود في القانون الجديد للصحة، إنشاء مراكز للمراقبة الصحية عند الحدود حيث ستمارس مصالح المراقبة نشاطها على مستوى الموانئ والمطارات والأماكن التي تراقب فيها مداخل التراب الوطني عبر الطرق أو السكة الحديدية، والهدف من هذه المراقبة الصحية هو الوقاية من انتشار جميع الأمراض المتنقلة برا أو جوا أو بحرا.
وتتكون مصلحة المراقبة الصحية حسب المادة 81 من نفس القانون من أطباء وأعوان مراقبة صحية ومحلفين طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يقوم المعنيون بالتعاون مع المصالح المعنية بإجراء التحقيقات والبحث ومعاينة المخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الصحة، كما يتخذون التدابير الوقائية اللازمة لحظر دخول أو استيراد مواد ذات مصدر حيواني أو نباتي أو أي مادة أخرى قد تكون لها آثار مضرة بالصحة حسب المادة 82.
سحب الاعتماد من مصنعي ومستوردي التبغ في حال التلاعب
وسيتعرض مستوردو ومصنعو التبغ لسحب الاعتماد في حال الإخلال بالإجراءات المعمول بها، من عدم تسجيل ملاحظة "التدخين مضر بالصحة"، على غلاف علب السجائر، مع نشر العبارة التحذيرية مرتين على التعليب وبشكل مميز، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة مالية ما بين 20 مليونا و200 مليون سنتيم، حسب ما تضمنه القانون الجديد للصحة.
استحداث مقاطعات صحية
كما ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار إلى مفهوم هرم الخدمات الصحية من القاعدة إلى القمة، وفي إطار إقليم معين، عبر استحداث نمط جديد تحت تسمية المقاطعة أو الناحية الصحية، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة "أي بمعنى إقليم صحي له حدود معينة"، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا".
المقاطعات الصحية التي يقترحها مشروع النص يديرها "مجلس توجيهي" يرأسه مدير عام ولائي ومدير على مستوى كل دائرة، ويسير المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمختصة.
مشروع القانون يقترح تعديلات على بعض المناصب الإدارية، مع إمكانية استحداث أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات، ومن أهم المهام الموكلة إلى هذه المقاطعات ترقية وضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، كما من المزمع أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاع شبه الطبي والتكوين، وتقسم كل مقاطعة إلى 3 وحدات صحية لكل منها مدير وبها طبيب منسق يساعده طبيب "متابع" سيكون بمثابة طبيب العائلة، بحيث يتابع كل مريض في جميع مراحل العلاج عبر حياته.
إلزام الممارسين الطبيين بالعمل 3 سنوات قبل الاستقالة أو التحويل
وفي الشق المتعلق بالخدمة المدنية في القطاع، تقرر إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84/10 المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيكون توظيف الممارسين المختصين من مهام المؤسسات العمومية والصحة. كما تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، ويلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة 3 سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل حسب المادة 292 من مشروع القانون .
حنان لعروسي