التاريخ السري للموساد اعداد دكتور سمير محمود قديح
التاريخ السري للموساد
الأولوية للتجسس
(هذه الحلقات هي عبارة عن أهم ما ورد في كتاب التاريخ السري للموساد ، من تأليف غوردون توماس)
يستمد هذا الكتاب أهميته من مؤلفه ومن منهاج تعامله مع موضوعه، أما المؤلف، غوردون توماس، فهو كاتب شهير يقيم في بريطانيا ويصل رصيده من المؤلفات الى 37 كتاباً، ترجمت إلى العديد من لغات العالم.
ومعظمها مكرس لعالم الاستخبارات، وهو في كتابه هذا يقدم تأريخاً لجهاز الموساد عقب لقاءات مع شخصيات عديدة لها صلة بشكل ما برصد أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلي فضلاً عن الوصول إلى الكثير من الوثائق والمصادر السرية، مما أتاح له الكشف عن أسرار لم تكن معروفة من قبل، ويلقي عليها الضوء في كتابه للمرة الأولى.
في عام 1917 أطلق اللورد بلفور وعده المعروف بإقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين. بدأت الحركة الصهيونية بعدها بالتحرك وشرع اليهود القلائل الذين كانوا في عين المكان بالتعبئة.
هكذا ذات يوم من أيام سبتمبر 1929 حاولوا التجمع علانية بالقرب من حائط البراق. رأى الفلسطينيون في ذلك تحديا لمشاعرهم ورشقوهم بالحجارة. وقال يومها أحد المسؤولين اليهود المشاركين بالتجمع: «قام بقاء شعبنا منذ الملك داؤود على النوعية الممتازة لاستخباراته».
كانت تلك الفكرة هي نواة قيام تنظيم استخباري وتجسسي يعد من أكثر الأجهزة ضراوة في العالم، أي الموساد. وكان الشكل الجنيني لهذا الجهاز قد تشكّل داخل منظمة «الهاغاناه» التي أنشأها اليهود في فلسطين من أجل ممارسة كل أشكال العنف لإرهاب الفلسطينيين العرب، وزودوها بجهاز مختص في التضليل وتزييف المعلومات بواسطة جواسيسهم. واعتبر ديفيد بن غوريون أن الأولوية المطلقة للهاغاناه ينبغي أن تتمثل في تعزيز شبكة استخباراتها.
وفي عام 1949 أي بعد قيام الدولة العبرية قرر بن غوريون، رئيس وزرائها آنذاك، إنشاء خمسة أجهزة سرية للعمل على صعيدي الداخل والخارج. واتخذت دوائر التجسس الأجهزة المناظرة لها في فرنسا وانجلترا نموذجا احتذت به لا سيما أن هذه الأجهزة قبلت التعامل مع الإسرائيليين الذين أقاموا علاقات أيضا مع الأجهزة السرية الأميركية.
لكن سرعان ما قامت الصراعات بين الوزراء والضباط الكبار في إسرائيل للوصول إلى المناصب العليا الحساسة، وكان كل منهم يريد أن يتولّى تنسيق الاستراتيجية العامة لإدارات الاستخبارات وتجنيد العملاء والوصول أولا إلى المعلومات المحصّلة كي يزوّد القيادات السياسية بها. وكان الصراع «مريرا بشكل خاص بين وزير الدفاع ووزير الخارجية إذ كان يريد كل منهما امتلاك حق الإشراف على أجهزة التجسس الخارجي».
منهاج العمل
في الثاني من مارس 1951 استدعى ديفيد بن غوريون رؤساء الأجهزة السرية الإسرائيلية الخمسة إلى مكتبه، وأعلن لهم قراره بجمع كل نشاطات التجسس الخارجي في جهاز واحد عمّده باسم «ها موساد لوتوم» أي «معهد التنسيق» كما أعلن في الوقت نفسه حصر مسؤولية «العمليات الخاصة» به شخصيا، بينما أشرف وزير الخارجية على الجهاز «إداريا وسياسيا».
وضمّ في الوقت نفسه ضباطا كبارا يمثلون هيئات الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى وخاصة شين بيت»، جهاز الأمن الداخلي، و«أمان»، جهاز الاستخبارات العسكرية وممثلين أيضا عن سلاحي البحرية والطيران. واحتفظت رئاسة الحكومة بدورها في حسم أي خلاف بين مختلف الأطراف. ولخّص بن غوريون الوضع بالصيغة التالية:
«تقدمون للموساد قائمة متطلباتكم وهو الذي يقوم بتأمينها. وليس عليكم الاهتمام بمعرفة أين سوف يتوجه ولا بالسعر الذي سيدفعه»، وجاء في نص المذكرة الأولى التي وجهها بن غوريون إلى «روفن شيلواه»، أول مدير للموساد، قوله: «سيعمل الموساد تحت إمرتي، وسوف يتبع تعليماتي ويقدم لي باستمرار تقريرا عن نشاطاته».
في مايو 1951، أي بعد عدة أسابيع فقط من تأسيس الموساد رسميا، تمّ الكشف عن الشبكة التي كان قد أنشأها في العراق.واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية عددا من الأشخاص بينهم عميلان إسرائيليان وعشرات من اليهود العراقيين ومن العرب.
ووجهت المحكمة العراقية تهمة التجسس لثمانية وعشرين شخصا وحكمت على العميلين الإسرائيليين بالإعدام وعلى 17 متعاملا معهم بالسجن مدى الحياة. خرج العميلان الإسرائيليان من السجن بعد فترة مقابل مبلغ مالي كبير جرى وضعه في حساب سويسري باسم وزير الداخلية العراقي، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب.
حلّت بعد فترة وجيزة كارثة أخرى، إذ أن العميل تيودور غروس لم يكن يعمل لحساب الموساد فقط وإنما أيضا لحساب الأجهزة السرية المصرية كما أكّد ايسر هاريل رئيس جهاز شين بيت مشيرا إلى امتلاكه لـ البرهان القاطع على خيانة غروس.
سافر هاريل إلى روما وأقنع غروس بالعودة معه إلى تل أبيب بعد أن وعده بمنصب رفيع في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية. حوكم غروس سرا وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، ويُفترض أنه مات قبل خروجه منه.
أدّت تلك القضية إلى استقالة روفن شيلواه وتولّي ايسر هاريل رئاسة الموساد لمدة أحد عشر عاما. وقد قوبل في البداية بقليل من الحماس من قبل ضباط الموساد، إذ كان قصير القامة، لا يتجاوز طوله مترا ونصف المتر مع أذنين منتصبتين مثل الرادار، هذا فضلا عن أنه كان يتحدث اللغة العبرية بلكنة واضحة مثل يهود أوروبا الوسطى.
وكانت ثيابه مهملة باستمرار وكأنه قد نام بها. كانت كلماته الأولى لأركان قيادته هي: «الماضي هو الماضي. ولن تكون هناك أخطاء بعد اليوم. سوف نعمل معا. ولن نتحدث لأحد إلا فيما بيننا».
في اليوم نفسه أفهم المتعاونين معه ماذا يعني بذلك، إذ عندما سأله سائقه عن الوجهة التي يقصدانها أجابه أنه سر وأخذ هاريل مكان السائق ثم عاد بعد قليل ومعه علبة من الحلوى لفريق عمله. كانت الرسالة واضحة وهو أنه هو وحده من يحق له أن يطرح الأسئلة. كانت ايماءة بسيطة، ولكنها حاسمة، إذ وجدت التعاطف لدى مرؤوسيه الذين قابلوه بفتور في البداية.
وقام هاريل بزيارة عدد من البلدان العربية سرا كي يشرف بنفسه على تجنيد عملاء لشبكات الموساد. ولم يكن يخفي تفضيله لأولئك الذين كانوا قد عاشوا في «الكيبوتزات»، الأمر الذي فسّره بالقول: «يعيش هؤلاء بالقرب من العرب ولم يتعلّموا كيف يفكرون مثلهم فقط، وإنما أن يفعلوا ذلك بسرعة أكبر».
لقاء في واشنطن
يحدد مؤلّف هذا الكتاب أهم صفات هاريل أنه كان صبورا جدا وكان شديد الحرص على المقرّبين منه بينما كان ينظر بعيون الشك والريبة لكل من ليس في دائرة هؤلاء.
واستطاع أن يثبت مواقعه أكثر بعد زيارته إلى واشنطن عام 1954 حيث التقى بـ آلان دالاس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقدّم يومها الإسرائيلي ذو القامة القصيرة هدية نقش عليها العبارة التالية:
«لن ينام حارس إسرائيل أبدا ولن يدغدغ النعاس عينيه»، وهذا ما علّق عليه الأميركي بالقول: «يمكنك الاعتماد عليَّ كي تبقى عيوني مفتوحة معك».
توطدت منذ ذلك اللقاء العلاقات أكثر بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي قدّمت للجهاز الإسرائيلي كل الأعتدة والتجهيزات الضرورية من أجل التنصت وآلات التصوير الدقيقة وأجهزة عديدة أخرى اعترف هاريل يومها أنه لم يكن يعرف حتى بوجودها. بل أقام الرجلان بينهما خطا هاتفيا أحمر للتحدث مباشرة، بعيدا عن كل «الآذان الأخرى» بل وبعيدا عن مصالح وزارتي الخارجية الأميركية والإسرائيلية.
وفي عام 1961 أشرف رئيس الموساد على عملية استهدفت استقدام آلاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل. وبعد عام انطلق «هاريل» إلى جنوب السودان من أجل دعم المتمردين الموالين لإسرائيل ضد النظام القائم. وساعد في السنة نفسها إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الصديق القديم لإسرائيل من أجل التغلب على محاولة انقلاب عسكري.
لكن في الوقت نفسه واجه هاريل غضبا متصاعدا في الداخل من قبل اليهود المتزمتين، بمن في ذلك أشخاص داخل حكومة ديفيد بن غوريون، إذ اتهموه أنه لم يعد يحسب أي حساب لحساسيتهم الدينية، بل اتهموه بالسعي سرا للوصول إلى أعلى المراتب السياسية. وسيطر الفتور على علاقات بن غوريون وهاريل، الذي وجد نفسه مضطرا لتقديم تقرير مفصل قبل الشروع بأية عملية بينما كان طليق اليدين قبل ذلك.
تزايدت حدة الشائعات في فبراير 1962 إثر عملية خطف «يوزيل شوماشير» ابن الثامنة من قبل فرقة يهودية متطرفة جدا، كان جدّه لأمه أحد أعضائها وكانت تدعى فرقة «حرّاس جدران القدس».
سجنت الشرطة الإسرائيلية الجد فقامت مظاهرات عنيفة من قبل اليهود المتزمتين شبّهوا فيها بن غوريون بالنازيين لأنه تجرأ وسجن «عجوزا طاعنا في السن». أنذر مستشارو بن غوريون رئيسهم أن تلك القضية قد تكون سببا في هزيمته خلال الدورات الانتخابية المقبلة، بل قالوا له إنه في حالة نشوب حرب مع العرب قد «تدعم بعض المجموعات المتطرفة العدو».
استدعى بن غوريون رئيس الموساد هاريل وطلب منه إيجاد الطفل فاعترض قائلا بأن مثل هذا العمل ليس من مهمة جهازه. وينقل المؤلف عن هاريل قوله: «انخفضت الحرارة فجأة عدة درجات، وشرح لي أن هذا أمرا ينبغي تنفيذه. فأجبت أنني أحتاج على الأقل إلى قراءة ملف الشرطة. وافق رئيس الوزراء على ذلك وأعطاني ساعة واحدة من أجل ذلك».
جنّد هاريل 40 من رجاله بعد قراءة الملف بغية تحديد مكان وجود الطفل. كانت المهمة شديدة الصعوبة، إذ فشل أحد عملاء الموساد - أصبح رئيسا لجهاز الشين بيت فيما بعد- في التغلغل إلى صفوف الفرقة المتطرفة. وتمّ اكتشاف عميل آخر بعد أيام من تكليفه بمراقبة مدرسة تلمودية.
وحاول ثالث أن ينخرط بين مجموعة من اليهود الذين كانوا في الطريق إلى القدس من أجل دفن أحد أقاربهم. لكن أُكتشف أمره سريعا ذلك أنه أخطأ في تلاوة الصلوات.
لم يثن هذا الفشل المتكرر عزيمة هاريل الذي أعلن عن اقتناعه أن الطفل موجود خارج إسرائيل وفي مكان ما بأوروبا. فأقام خلية عمل مكلّفة بالبحث عنه في باريس. ولم يتم العثور على الطفل فاتجه فريق من الموساد إلى أميركا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
ألقت الشرطة البريطانية على عشرة من عملاء الموساد كانوا قد تزيّوا بهيئة «متدينين» مع لحى مزيفة وشاركوا في الاجتماع الديني صباح يوم سبت في كنيس بضواحي لندن. لكن جرى الإفراج عنهم سرا وسريعا عن طريق تدخل السفارة الإسرائيلية لدى السلطات المعنية.
جرت في تلك الأثناء دعوة حاخام متشدد حقيقي إلى باريس للإشراف على عملية ختان أحد صبيان عائلة يهودية غنية، استقبله في المطار حاخامان بثياب سوداء على غرار أزياء المتطرفين اليهود، ولم يكونا في الحقيقة سوى اثنين من عناصر الموساد.
وقد جاء في التقرير الذي أرسلاه لمسؤولهما: «اقتيد الحاخام إلى أحد مواخير شارع بيغال من دون أن يعتريه أي شك حول طبيعة المكان. دخلت عاهرتان كنّا قد دفعنا لهما الأجر إلى غرفته وألقيتا نفسهما عليه. التقطنا له صورا ثم عرضناها عليه مع التهديد بنشرها إذا لم يخبرنا عن مكان الطفل. لكنه أقنعنا بعدم معرفته مكان وجوده فقمنا بتمزيق الصور أمامه».
هناك حاخام آخر هو شاي فراير اعترض عملاء الموساد طريقه عندما كان يقصد جنيف قادما من باريس. بدا أن هذا الاحتمال الجديد لا يؤدي إلى أية نتيجة. مع ذلك أصدر هاريل الأوامر باعتقال الحاخام في مقر الموساد بجنيف حتى نهاية التحقيق خشية أن يقوم بإخطار المجموعات اليهودية المتطرفة كلها.
هناك سبيل آخر بدا واعدا وتمثل في مادلين فراي ابنة الأسرة الأرستقراطية الفرنسية التي كانت أنقذت الكثير من الأطفال اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت تتردد بعد ذلك كثيرا نعلى إسرائيل حيث قابلت بعض أعضاء الفرقة المتطرفة، وكانت هي نفسها قد اعتنقت اليهودية. في شهر أغسطس 1926 حدد عملاء الموساد مكان إقامتها في إحدى ضواحي باريس.
قابلت مادلين عملاء الموساد بجفاء عندما قدّموا أنفسهم لها، فجاء هاريل نفسه لمقابلتها وشرح لها الظلم الكبير الواقع على والدي الطفل يوزيل. أكّدت مادلين أنها لا تعرف شيئا عن الأمر، فطلب منها هاريل رؤية جواز سفرها، كانت توجد تحت صورتها صورة لابنتها فأشار رئيس الموساد لأحد عناصره كي يعطيه صورة ليوزيل. كان الشبه كبيرا إلى حد التماثل بين الوجهين. فاتصل هاريل حالا بتل أبيب وقال:
«أعرف كل ما أحتاج معرفته عن مادلين من أبسط تفاصيل حياتها الغرامية عندما كانت طالبة إلى قرارها الالتحاق بالحركة اليهودية المتطرفة بعد تخليها عن مسيحيتها. لقد قلت لها، كما لو أنني أملك البرهان القاطع، إنها صبغت شعر الطفل يوزيل بغية إخراجه من إسرائيل. نفت كل شيء».
لكنها اعترفت أخيرا بكل شيء وكيف أنها سافرت كسائحة إلى حيفا بحرا. وبعد أسبوع خرجت أمام الشرطة قاصدة زيوريخ جواً بعد أن ألبست يوزيل ثياب طفلة وصبغت شعره.
أمضى يوزيل بعض الوقت في مدرسة تلمودية متطرفة في جنيف ثم اصطحبته مادلين إلى نيويورك. وعندما سألها هاريل عن مكان وجوده الراهن أعطته العنوان في بروكلين بنيويورك، وأن اسمه أصبح يانكال جيرتنر. عندها قال لها هاريل مبتسما:
«شكرا مادلين، وإنني أرغب عرض منصب عليك في جهاز الموساد. فموهبتك يمكنك أن تقدم خدمات كبرى لإسرائيل». ورفضت مادلين ذلك. طار عملاء الموساد إلى نيويورك حيث كان ينتظرهم فريق من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بطلب خاص من بن غوريون إلى وزير العدل الأميركي. وصل الجميع إلى العنوان.
فتحت السيدة «جيرتنر» لهم الباب، دخلوا فوجدوا الأب يصلي وبجانبه طفل شاحب وعلى رأسه القلنسوة اليهودية وخصلتا شعر طويلتان تتدليان على وجهه. فقال له أحد عملاء الموساد «مرحبا يوزيل. نحن هنا كي نعيدك إلى أهلك». هكذا مضت ثمانية أشهر منذ بداية البحث وأُنفق مليون دولار في العملية.
لم يمنع هذا النجاح الذي حققه هاريل من تقديمه استقالته بتاريخ 25 مارس 1963 بعد حملة شائعات وتشهير قادها مائير اميت، رئيس جهاز «أمان» وخلف «هاريل» على رأس الموساد. كان عمر هاريل آنذاك خمسين عاما. وانتهت باستقالته حقبة من تاريخ الجهاز الإسرائيلي.
الأولوية للتجسس
بعد عدة دقائق فقط من جلوسه خلف مكتبه الجديد استدعى أميت رؤساء الدوائر. لقد اصطفوا أمامه، ونظر إليهم بهدوء واحدا بعد الآخر، ليقول لهم بعد ذلك أنه لن تكون هناك بعد آلان مهمات البحث عن أطفال، وأعطى الأولوية للتجسس.
وبعد فترة قصيرة من استلام أميت منصبه حضر إلى السفارة الإسرائيلية بباريس شخص قدّم نفسه باسم «سلمان». وقال أنه يمكن أن يقدم، مقابل مليون دولار، إحدى الطائرات المقاتلة الأكثر مضاء آنذاك أي «الميغ-21». وختم سلمان حديثه بالجملة الغريبة التالية: «ما عليكم سوى إرسال أحدهم إلى بغداد. وهناك يقوم بالاتصال بهذا الرقم ويطلب جوزيف، ولا تنسوا تحضير المليون دولار».
عرض الدبلوماسي مضمون المحادثة على جاسوس إسرائيلي موجود في السفارة حافظ على موقعه رغم التغييرات التي قام بها مائير أميت. وأرسل الجاسوس بدوره المعلومات إلى تل أبيب مع رقم الهاتف الذي أعطاه «سلمان».
حيّرت القضية أميت، فمن جهة هناك خشية أن يكون سلمان عميلا مزدوجا جندته الاستخبارات العراقية من أجل نصب فخ للموساد. وهناك خطر الكشف عن عملاء الموساد في العراق. لكن كان إغراء الحصول على الميغ-21 كبيرا أيضا، إذ كان مسؤولو الطيران الإسرائيليون على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على المعلومات الخاصة بها.
قال أميت نفسه حول تلك القضية: «كنت أفكر بها قبل أن أنام وحالما أستيقظ، وكل الأوقات بينهما عندما تكون لديًّ دقيقة فراغ. فمعرفة السلاح المتقدم للعدو هي أولوية بالنسبة لكل جهاز استخبارات، والحصول على طائرة من هذا النوع أمر شبه مستحيل». اختار أميت للعميل الموفد إلى بغداد اسما وجواز سفر بريطانيين:
جورج بيكون الذي ذهب بصفة مدير مبيعات في شركة لندنية مختصة بتصنيع أجهزة التصوير الشعاعي الطبي. وصل إلى بغداد بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية ومعه عدة صناديق من العينات، بل وأظهر كفاءة عالية حيث باع عدة أجهزة لمستشفيات عراقية.
في بداية الأسبوع الثاني لإقامته اتصل بيكون بالرقم المعني. وينقل عنه المؤلف قوله: «اتصلت من هاتف مدفوع الأجر في بهو الفندق. ذلك أن خطر التنصت أقل مما هو في الغرفة. رفع أحدهم السماعة عند الرنّة الأولى وسأل بالفارسية عن المتحدّث.
فأجبت بالإنجليزية معتذرا بغموض وكأنني قد أخطأت بالرقم. فطلب مني المتكلم - بالإنجليزية هذه المرّة - الافصاح عمّن أكون. فقلت إنني صديق لجوزيف، وهل يعرف أحدا بهذا الاسم؟ فرجاني الانتظار. قلت لنفسي إنهم يحاولون الآن تحديد موقع الهاتف الذي أتحدّث منه وأنني ربما وقعت في الفخ. لكن شخصا ودودا قال لي أن اسمه جوزيف وأنه مسرور لاتصالي. وسألني إن كنت أعرف باريس. كان هو الشخص المقصود قلت لنفسي».
جرى اللقاء ظهر اليوم الثاني في أحد مقاهي بغداد. يقول بيكون عن اللقاء: قال لي جوزيف أنه مسرور لرؤيتي (...). وتحدث عن المطر والطقس الجميل (...). فهمت أنه ليس عميلا في جهاز مكافحة التجسس، فهدأت انفعالاتي، وقلت له أن أصدقائي مهتمون جدا بالسلعة التي تحدث عنها صديقه.
فأجابني: «سلمان ابن أخي. يعيش في باريس كنادل في مقهى. جميع الندل الجيدون غادروا». ثم اقترب من الطاولة وأضاف: «أنت هنا من أجل الميغ؟ أستطيع جلبها لك. لكن هذا كلفته مليون دولار».
ثم طلب العجوز عدم التحدث حيث هما، وحددا موعدا في أحد الأماكن العامة على ضفة الفرات في اليوم التالي. لم تغمض عينا «بيكون» تلك الليلة بسبب هاجس أن فخا قد نُصب له إمّا من قبل الاستخبارات العراقية وإمّا من قبل عصابة من المحتالين الدهاة.
قدّم له موعد اليوم الثاني إيضاحات أكثر عن شخصية جوزيف ودوافعه. إنه ينتمي في الأصل إلى عائلة يهودية فقيرة.
عمل عندما كان فتى لدى عائلة مارونية غنية صرفته من الخدمة بعد 30 سنة من العمل. فوجد نفسه في الشارع وعمره 50 سنة. واعتراه وهو بتلك الحالة الحنين إلى جذوره اليهودية.
عبّر عن رغبته تلك لأخته المدعوة مانو التي كان ابنها منير قائدا لطائرة مقاتلة في سلاح الطيران العراقي. فأخبرته مانو بأنها تحلم هي أيضا بالهجرة إلى إسرائيل. لكن كيف؟
بقيت الفكرة في ذهن جوزيف، وسمع منير يردد أمامه عدة مرّات أثناء الطعام أن رئيسه لا يكف عن القول بأن الإسرائيليين مستعدون لدفع مليون دولار من أجل إلقاء نظرة واحدة على طائرته. هكذا رسخ مبلغ المليون دولار في رأسه.
وفكر جوزيف بهجرة جماعية تترك الأسرة كلها في اطارها العراق دفعة واحدة. كان منير شديد التعلق بوالدته وعلى استعداد لفعل أي شيء من أجلها، وقد يقبل الفرار بطائرته. أما بقية أفراد العائلة فيتكفل العملاء الإسرائيليون بذلك، وهم أصحاب خبرة كبيرة في هذا الميدان. وضمن هذا الإطار ذهب «سلمان» إلى السفارة الإسرائيلية بباريس.
«ومنير؟ هل هو على اطلاع؟» هكذا سأل بيكون فأجاب جوزيف: «بالتأكيد. وهو موافق على الهرب. لكنه يريد نصف المبلغ حالا والنصف الآخر قبيل الرحيل». اندهش بيكون، فكل ما سمعه بدا ممكنا وقابلا للتحقيق. لكن ينبغي عليه أولا تقديم تقريره إلى مائير أميت. سأل هذا الأخير بعد لقاء استمر نصف يوم كامل مع بيكون عند عودته وشرح خطة جوزيف كاملة. «لكن، أين يريد أن يتم الدفع؟»، «في أحد البنوك السويسرية».
فأردف أميت: «يبدو أن جوزيف هذا لاعب ماهر، وعندما نضع المال على الحساب لن نراه بعد ذلك. فما الذي يدفعك للثقة به؟» «أثق به، إذ ليس هناك خيار آخر. فأمر «أميت» بوضع نصف مليون دولار في بنك سويسري «كريدي سويس».كان الرهان دقيقا، وليس فقط على الصعيد المالي، إذ كان يعرف أنه لن يبقى على رأس الموساد إذا تكشف أن جوزيف محتال كما يتوقع بعض العاملين معه.
الميغ التي اختفت
أخطر أميت كلاً من بن غوريون وإسحاق رابين رئيس الأركان، فأعطيا الضوء الأخضر. فأخبرهما أميت أنه سوف يسحب جميع عملاء الموساد في العراق.
قال: «في حالة الفشل، ستكون رأسي وحدها التي ستطيح. لقد شكّلت خمسة فرق. الفريق الأول مسؤول عن الاتصال بين بغداد وبيني. والتعليمات الموجهة له تنص على التزام الصمت الكامل إلا في حالة وقوع أزمة كبيرة. بتعبير آخر لم أكن أريد التحدث عن هذا الفريق تحت أية حجة كانت.
وكان على الفريق الثاني الذهاب إلى بغداد دون أن يكون أحد على علم بذلك، لا بيكون ولا عناصر الفريق الأول، فعلا لا أحد. وتمثلت مهمته في إخراج بيكون إذا حدث خلل وأيضا جوزيف إذا أمكن ذلك. والفريق الثالث مهمته أن لا تغيب عائلة جوزيف عن ناظريه. والفريق الرابع مهمته جلاء المعنيين. وكان على الفريق الخامس تأمين الصلات مع واشنطن والأتراك.
كان ينبغي على طائرة الميغ اختراق الأجواء التركية بعد مغادرة العراق قبل أن تحط عندنا. وكان ينبغي على الأميركيين الذين يمتلكون قاعدة في شمال تركيا، دفع الأتراك للتعاون عبر القول لهم أن الطائرة موجهة إلى الولايات المتحدة. وكان قد تمّ إخباري بأن العراقيين، بدافع خشية هروب أحد طياريهم، لم يكونوا يملؤون خزانات وقود طائرات الميغ إلا نصفها. وهذا ما كان باستطاعتنا أن نفعل شيئا حياله».
انطلقت العملية بعد ذلك. وحصل ابن عم جوزيف على السماح له بالخروج بحجة العلاج إلى جنيف. وعندما وصل إليها بعث ببطاقة بريدية إلى بغداد قال فيها: «المنشآت الصحية ممتازة، وأنا متأكد من أنني سوف أتوصل إلى الشفاء الكامل». كانت تلك هي الإشارة المتفق عليها للتأكيد أنه جرى ايداع مبلغ نصف المليون دولار الثاني في رقم الحساب المعني في سويسرا.
أعلن جوزيف، بعد أن اطمأن إلى وصول المبلغ كاملاً إلى الحساب السويسري، للعميل الإسرائيلي «بيكون» أن جميع أفراد أسرته جاهزين للسفر. فعشية المهمة الأخيرة التي كان منير سيقوم فيها للتدرب على طائرته المقاتلة قادهم جوزيف كلهم في موكب إلى أحد الجبال «للاستمتاع بعذوبة المناخ».
لم تعترض القوات العراقية المنتشرة على عدة حواجز في الطريق على ذلك، إذ كان من المألوف أن يهجر العديد من سكان العاصمة حرارتها الشديدة كل صيف للذهاب إلى الجبال.
استقبل فريق الاتصال الإسرائيلي الذي كان موجوداً في المناطق الكردية أفراد عائلة جوزيف الذين جرى اقتيادهم إلى منطقة أخرى حيث كانت تنتظرهم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش التركي. وكانت الطائرات تخترق الحدود من دون أية صعوبات عبر طيرانها على ارتفاع منخفض جدا بحيث لا يمكن لأجهزة الرادار أن تكتشفها.
اتصل أحد عملاء الموساد بمنير كي يخطره بأن أخته قد ولدت طفلة وأن كل شيء تم على ما يرام، كانت تلك رسالة مشفرة جديدة تعني أن عملية ترحيل أفراد العائلة قد اكتملت تماما.
في صباح اليوم التالي الذي صادف الخامس عشر من شهر أغسطس 1966، ومع شروق الشمس أقلع منير بطائرته في مهمة اعتيادية. وما إن ابتعد عن القاعدة حتى زاد قوة محركات طائرته الميغ إلى أقصى حد ممكن وبلغ الحدود التركية قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء ضده، بما في ذلك احتمال إسقاط طائرته.
ومع اجتيازه الحدود التركية رافقت طائرته عدة طائرات من طراز فانتوم تابعة للسلاح الجوي الأميركي. لقد حطّ منير بطائرته في إحدى القواعد التركية حيث جرى تزويدها بالوقود وأقلع من جديد، وعندها تلقى رسالة جديدة صريحة وغير مشفرة جاء فيها: «عائلتك في مكان آمن وسوف تلحق بهم بعد فترة قليلة». حطت طائرة الميغ-21 بعد ساعة في أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية.
هكذا نجح جهاز الموساد في أن ينال شهرة على صعيد التجسس. كانت تلك مرحلة مفصلية في مسيرة هذا الجهاز الذي كان قد غدا ذا باع طويل في عالم العمليات السرية.
إسرائيل تنشر الجواسيس في المطارات العربية قبيل النكسة
* الحلقة الثانية :
يجد القارئ نفسه هنا على موعد مع إضاءة لمنعطف بالغ الأهمية في مسيرة جهاز الموساد، بما في ذلك إعداد هذا الجهاز لحرب يونيو 1967 ضد العرب، وكيف أفلح في أن يجمع في آن بين التعاون الوثيق مع الأميركيين ومع مد الجسور نحو جهاز المخابرات السوفييتي العتيد، «الكي جي بي». وتبرز في الصورة أيضاً قصة سقوط عميلين بارزين من عملاء الجهاز هما إيلي كوهين وولفغانغ لوتز.
أمضى مائير أميت خمس سنوات على رأس جهاز الموساد (1963-1968) قام خلالها بزيارات سرية إلى العديد من العواصم العربية وغير العربية. ولم يكن هناك من يتجرأ على سؤاله عن مصادر معلوماته وموارده وطرق عمله.
استطاع الموساد في ظل إدارته جمع كمّ هائل من المعلومات، وجنّد الكثير من الجواسيس في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وفي العالم العربي، حيث استطاع عملاؤه اختراق جهاز الاستخبارات الأردني الذي كان يُنظر إليه كأفضل جهاز أمني عربي وكذلك جهاز الاستخبارات العسكرية السوري الذي يوصف بأنه الجهاز الأكثر انغلاقا.
وبعد وصول أميت بفترة قصيرة إلى إدارة الموساد أمر بتعميم مذكرة على مختلف أقسام جهازه كان قد سرقها أحد عملائه من مكتب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات.
ومما جاء فيها: «يمتلك الموساد ملفا عن كل منّا. إنه يعرف أسماءنا وعناويننا. وتوجد فيه صورتان إحداهما لنا ونحن حاسرو الرؤوس والثانية ونحن نلبس الكوفية. وبالتالي لا يجد جواسيس الموساد صعوبة في رصدنا في أي مكان ولو كنّا بالزي المدني».
ويشير مؤلف هذا الكتاب إلى الدور الذي لعبه المخبرون الذين جنّدهم مائير أميت في الارشاد إلى مخابئ أسلحة منظمة التحرير وعلى أعضائها. وتفيد المعلومات التي يقدمها أنه مع اقتراب حرب 1967 كان للموساد مخبرون في جميع القواعد الجوية والقيادات العسكرية العامة.
وكان أميت يهتم بأبسط التفاصيل مثل «معرفة المسافة التي يقطعها طيار من موقع عمله ومكان تناول طعامه؟ وكم من الوقت يمضي أحد ضباط الأركان مثلا كل يوم في ازدحام السير بمدينة القاهرة؟ وهل لهذا الضابط القيادي خليلة؟».
وكانت «خلية الحرب النفسية داخل جهاز الموساد» تعمل باستمرار من أجل جمع ملفات حول الطيارين العرب والفرق العاملة على الأرض وأعضاء القيادات وكفاءاتهم وآليات ترقيتهم وميلهم نحو الكحول ونزوعهم الجنسي.
وكان أميت يدرس تلك الملفات بعناية حتى ساعة متأخرة في الليل أحيانا بحثا عن «الأكثر هشاشة» أمام الضغوط أو الوعود. هكذا استقبلت العديد من العائلات رسائل مجهولة المصدر تتحدث عن عادات وممارسات ابن أو زوج. وبمقدار ما كان يتم زرع البلبلة كان فرح مائير أميت كبيرا.
حديث النكسة
يشير المؤلف إلى أن مائير أميت حدد، بالاعتماد على المعلومات التي جمعها خلال فترة طويلة، لمسؤولي الطيران الإسرائيلي الساعات الأفضل للقيام بغارات خاطفة على القواعد الجوية المصرية في عام 1967.
وشدد على أنه ما بين الساعة السابعة والنصف والسابعة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحا تكون وحدات رقابة الرادار في أقصى مستوى من حيث هشاشتها.
فالفريق الليلي يكون في غاية الإنهاك بعد ساعات العمل الطويلة والفريق النهاري لا يكون شديد الحذر فضلا عن تأخر أفراده غالبا في تناول الطعام. أما الطيارون فكانوا يتناولون إفطارهم ما بين الساعة السابعة والربع والسابعة وخمس وأربعين دقيقة. ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مواقع عملهم لارتداء زي الطيران.
تستغرق هذه العملية حوالي عشر دقائق، ويضيع أغلبهم عدة دقائق إضافية في الحمّام قبل الوصول إلى حيث توجد طائراتهم في ملاجئها. هكذا يكونون على استعداد للبداية «الرسمية» لعملهم عند الساعة الثامنة صباحا.
عندها تقوم الفرق الأرضية بإخراج الطائرات من الملاجئ لتزويدها بالوقود وتسليحها. وخلال ربع ساعة تتزاحم حول الطائرات شاحنات الصهاريج وعربات نقل الذخائر.
وبالطريقة نفسها جرى الاستخبار الدقيق عن ضباط القيادات العليا الذين لا يكونون في مكاتبهم إلا في حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا، أما الضابط المسؤول عن إصدار القرارات فلا ينكب جديا على مراقبة حركة العمل في القواعد إلا حوالي الساعة الثامنة والنصف.
ونتيجة هذه التوصيفات كلها شرح مائير أميت أن أفضل توقيت لقيام الطائرات الإسرائيلية بغارة خاطفة على القواعد المصرية هي ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا.
وفي صبيحة الخامس من يونيو 1967 قامت الطائرات الإسرائيلية بغاراتها على القواعد الجوية المصرية عند الساعة الثامنة ودقيقة واحدة وارتفعت أعمدة الدخان من شاحنات الصهاريج والطائرات التي انفجرت مع ذخيرتها. اعتبر «مائير أميت» أن عمل جهازه قد حدد وحده سير المعارك.
كان كل مجنّد جديد في صفوف الموساد يمضي ثلاث سنوات في تدريب مكثّف يخضع خلالها لمساءلات شديدة. وينتهي الأمر به ـ أو بها ـ في نهاية التدريب إلى استخدام الأسلحة وخاصة مسدس سباريتا عيار 22».
وكان العملاء يبدؤون عملهم عادة في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا. وكانت مهمتهم في نيويورك مثلا هي التغلغل في صفوف البعثات الدبلوماسية في منظمة الأمم المتحدة.
أما في واشنطن فقد كانت لهم مسؤولية إضافية هي «مراقبة» البيت الأبيض. وكان بعض العملاء يقومون بمهمات محددة في هذه المنطقة أو تلك حيث توجد توترات ثم يعودون بعد القيام بمهامهم.
وسّع مائير أميت كثيرا من مجال نشاطات الموساد إذ أضاف للجهاز إدارة لجمع المعلومات مكلّفة بالتجسس في الخارج وإدارة للعمل السياسي تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة «الصديقة» وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات البريطاني.
أمّا إدارة البحوث فقد جرى تقسيمها إلى 15 مكتبا يختص كل منها ببلد عربي. هذا بالإضافة إلى مكتب مختص بكل من الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وبريطانيا وأوروبا والاتحاد السوفييتي. ثم أضيفت لها بعد ذلك مكاتب مختصة بالصين وجنوب إفريقيا والفاتيكان.
سقوط كوهين
شكّل عملاء الموساد قوة جاهزة باستمرار لزرع الشقاق ومناخ عدم الثقة بين الدول العربية وبث إشاعات دعائية مشككة وتجنيد مخبرين تطبيقا لقاعدة «فرّق تسد» التي كان مائير أميت يؤمن بها تماما. وكان رجاله لا يترددون أحيانا في أن يتركوا خلفهم الدمار والموت.
ويفتخر أميت بعميلين إسرائيليين كان وراء نشاطهما، وهما إيلي كوهين وولفغانغ لوتز. وكوهين من مواليد مدينة الإسكندرية بتاريخ 16 ديسمبر 1924. كان متدينا جدا مثل أسرته، وخرج من مصر في شهر ديسمبر 1956 بعد أزمة ثم حرب السويس في تلك السنة. وصل إلى حيفا لكنه أحس بالغربة فيها.
وجنّدته مصلحة الجاسوسية العسكرية الإسرائيلية عام 1957، ولم يعجبه عمله كمحلل فحاول الدخول إلى جهازالموساد لكن طلبه قوبل بالرفض.
وينقل المؤلف عن أميت قوله له: «لقد جرحه رفضنا بعمق. فترك الجيش وتزوج من فتاة عراقية اسمها نادية». عمل كوهين بعدها لمدة عامين في أحد مكاتب التأمين بتل أبيب.
وفي عملية تفحص لملفات «المرشحين المرفوضين» إثر بحث مائير أميت عن «نموذج خاص لعميل من أجل مهمة خاصة جدا هي الأخرى» لم يجد الشخص المطلوب بين عناصره فأعاد النظر في ملفات المرفوضين. وبدا له أن «كوهين» يمثل أفضل الإمكانيات المتوفرة. فبوشرت مراقبته سرا في الحال.
أشارت تقارير جهاز الموساد الأسبوعية إلى رتابة عاداته وتعلقه بزوجته وأطفاله. وكان الرأي النهائي به من قبل أميت أنه «صالح للخدمة».
أمضى كوهين دورة تدريبية مكثفة لمدة ستة أشهر في مدرسة الموساد. وعلّمه خبراء كيف يتعامل مع المتفجرات والقنابل الموقوتة وصناعتها من أبسط الأشياء، وتحوّل إلى قناص جيّد. وتعلم فك رموز الرسائل المشفرة وأيضا كتابتها، واستخدام جهاز البث اللاسلكي. أظهر كفاءات عالية وذاكرة قوية.
ومع ذلك بقي مائير أميت مترددا وقال عن ذلك: «تساءلت مئة مرة إذا كان إيلي صالحا بالفعل للقيام بما كنت أنتظره منه. وكنت بالطبع أُظهر له باستمرار ثقتي الكاملة به.
ولم أكن أريد خاصة أن يلاحظ خلال مهمته أنه مهدد باستمرار. ثم قلت لنفسي أن أفضل العقول في الموساد قدّموا له معارفهم وخبراتهم، وقررت القيام بالمحاولة».
وتقرر بعد تحضيرات عديدة ومعمقة ذهاب إيلي كوهين باسم جديد هو كامل أمين ثابت إلى بيونس ايريس في الأرجنتين بصفة تاجر يجيد لغة المبادلات التجارية مع سورية.
وجاء على لسان مائير أميت: «لقد تفهّم بسرعة كل ما كان بحاجة إليه مثل الفرق بين الفواتير وبوالس الشحن وبين العقود والكفالات، الخ. لقد كان حرباء حقيقية. واختفى أمام ناظري إيلي كوهين ليبرز كامل أمين ثابت، ذلك السوري المقيم في الأرجنتين والذي لم يتخلّ أبدا عن حلمه القديم في العودة إلى دمشق.
تعززت ثقة إيلي بنفسه يوما بعد يوم واستعجل الدخول في العملية وإثبات نجاحه في لعب الدور المطلوب منه. لقد فعلنا أفضل ما نستطيع لتعليمه إيقاع حياته الجديدة. والباقي عليه. كنا نعرف ذلك جميعا. ورحل من دون ضجة تاركا إسرائيل بشكل سري مثل جميع الجواسيس».
وجد كوهين بسرعة مكانة مرموقة في عالم الأعمال بالعاصمة السورية، وبالتالي تعرّف على العديد من الأصدقاء في المراكز العليا بالحكومة. ولم يتردد في المزايدة بالقول ان سوريا لن تقهر في مواجهة «العدو الصهيوني»، هكذا جرى اصطحابه مع وفد من الزائرين إلى هضبة الجولان السورية للاطلاع على التحصينات العسكرية فيها.
وهناك رأى بأم عينيه المخابئ التي توجد فيها المدافع طويلة المدى التي زوّدت روسيا بها سورية. بل وسُمح له بالتقاط صور. وكان كوهين قد أخبر تل أبيب بوصول دبابات ت-54 إلى سوريا بعد عدة ساعات فقط من استلامها. بل استطاع التوصل إلى خطة كاملة للإستراتيجية السورية الخاصة بشمال فلسطين المحتلة. كانت تلك معلومات لا تقدّر بثمن.
كان كوهين يعادل بنظر مائير أميت فرقة مدفعية كاملة. لكنه أخذ عليه تهوره قليلا. فمثلا كان مولعاً جداً بكرة القدم وغداة هزيمة الفريق الإسرائيلي خرق القاعدة الأكثر حزما في الاتصالات السرية إذ بعث إلى المسؤول عن الاتصال به رسالة تقول: «ربما أنه قد آن الأوان لنتعلم كيف نكسب أيضا في ملاعب كرة القدم». ثم تبع ذلك برسالة أخرى جاء فيها: «أتمنى عيد ميلاد سعيد لزوجتي» ثم «أتمنى عيد ميلاد سعيد لابنتي».
أعرب مائير أميت عن غضبه من سلوك جاسوسه قبل أن يردف: «إنها إحدى الإساءات المؤقتة التي تبدو في بعض اللحظات حتى لدى الأفضل» ثم أضاف: «كنت أسعى كي أضع نفسي في مكانه.
فهل كان بصدد فقدان الأمل؟ وهل كان يحاول إظهار ذلك عبر التقليل من الحذر؟ لقد أعدت في رأسي الحكاية كلها. وأخذت باعتباري مئة عامل وعامل. لكن في النهاية كان هناك عامل واحد له قيمة حقيقية وهو: هل كان لا يزال مؤهّلا للاستمرار في القيام بمهمته؟
كانت إجابة مائير أميت هي «نعم». لكن ذات مساء من يناير 1965، كان إيلي كوهين في غرفته بدمشق يستعد للقيام بعملية اتصال عبر جهاز الإرسال. وفي لحظة البدء بالإرسال وجد نفسه محاطا برجال مكافحة الجاسوسية السوريين.
بعد أن كان قد جرى التقاط مراسلاته من قبل وحدة متحركة مجهّزة بأعتدة سوفييتية كانت هي الأكثر تقدما في العالم آنذاك. طلب منه رجال الأمن السوري بث رسالة محددة للموساد. لكن فهم «أميت» من تغير نبرة الصوت أن إيلي كوهين سقط بيد السوريين الذين أعلنوا الخبر بعد يومين.
قال أميت: «اعتراني الإحساس أنني فقدت أحد أفراد أسرتي. وفي مثل هذه الحالات يطرح الإنسان على نفسه أسئلة مثل: ألم يكن ممكنا إنقاذه؟ كيف أمكن رصده؟ هل ارتكب حماقة؟ هل أوشى به أحد المقرّبين؟ هل كان يتمنى اكتشاف أمره في لا وعيه؟ مثل هذا الأمر قد يحصل أحيانا، أم كان الأمر يتعلق بمجرد سوء حظ؟ تبقى الإجابات غائبة، لكن يبقى التساؤل وسيلة لتخطي الأزمات».
لم يبح إيلي كوهين بشيء. وحاول مائير أميت إنقاذ حياته. وكان وراء الحملة الدولية التي أطلقتها زوجته نادية كوهين للدفاع عن زوجها حيث قابلت بابا الفاتيكان وملكة بريطانيا وعدداً آخر من رؤساء الدول.
وسافر أميت إلى أوروبا حيث قابل رؤساء الأجهزة السرية الألمانية والفرنسية الذين لم يستطيعوا عمل شيء. بل وقام باتصالات غير رسمية مع الاتحاد السوفييتي. وتابع مساعيه حتى يوم 18 مايو 1965 عندما خرجت من سجن المزّة العسكري بالقرب من دمشق سيارة عند الساعة الثانية صباحا وعلى متنها إيلي كوهين. كانت الوجهة هي ساحة المرجة حيث نُصبت مشنقة علّقوا فيها إيلي كوهين أمام أنظار الآلاف من السوريين وعدسات التلفزيون.
حكاية لوتز
الجاسوس الآخر الذي استولى على اهتمام مائير هو وولفغانغ لوتز اليهودي الألماني الذي وصل إلى فلسطين خلال سنوات الثلاثينات من القرن العشرين.
اختاره الموساد في قائمة من المرشحين للقيام بعمليات تجسس في مصر التي دخلها بصفة ألماني شرقي كان قد خدم في صفوف القوات الألمانية في إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية ولذلك قرر العودة إلى مصر التي كان قد عرفها لممارسة العمل التجاري.
بعد عامين من النشاط التجسسي اكتشفت الأجهزة المصرية الجاسوس الإسرائيلي وحُكم عليه بالسجن ربما كي يتم تبادله مع أسرى مصريين في حالة قيام حرب. حاول أميت التمكن من إطلاق سراحه بشتى الطرق. واقترحت إسرائيل مبادلة لوتز وزوجته بجميع سجناء الحرب المصريين الموجودين في السجون الإسرائيلية.
لكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر رفض الاقتراح. فلجأ مائير أميت إلى ممارسة الضغوط النفسية. قال: «أفهمت السجناء المصريين أن بقاءهم في السجون الإسرائيلية يعود إلى رفض عبد الناصر إعادة شخصين إسرائيليين. وسُمح لهم بالكتابة إلى ذويهم، لكن هذا كله بقي دون أي صدى».
ثم تقدم أميت باقتراح آخر هو إظهار الأمر وكأنه انتصار علني للرئيس المصري من دون ذكر أية كلمة عن إطلاق سراح لوتز وزوجته.
رفض عبد الناصر هذا العرض الجديد. فلجأ الإسرائيليون إلى المسؤول عن عناصر الارتباط لدى الأمم المتحدة الذي سافر إلى القاهرة وحصل على وعد بـ «إطلاق سراح لوتز وزوجته» لاحقا. ثم بعد شهر «غادر لوتز وزوجته القاهرة إلى جنيف بأكبر قدر ممكن من السرية، وكانوا بعد ساعات في مكتبي»، كما صرّح أميت.
فهم مائير أميت سريعا أن عملاءه بحاجة إلى دعم لتنفيذ مهماتهم. هكذا شكل شبكة «سيانيم» أي المتطوعين اليهود للتعاون كل في مجاله. فمن يعمل منهم مثلا في وكالات للسفر يسهل تقديم سيارة لجواسيس الموساد من دون عراقيل؛ والمصرفي يقدم التسهيلات المالية المطلوبة؛ والطبيب قد يساهم بإخراج رصاصة من دون إعلام السلطات.
لم يكن مائير أميت يعترض، بالطبع، على محاولات التجسس لكنه كان يؤكد على ضرورة التخطيط الجيد لها. وكان قد أصرّ كذلك على إيجاد شبكة عالمية للصلات مع وسائل الإعلام التي كان يستخدمها ببراعة كبيرة.
فمثلا كان يتبع قيام أي اعتداء أو تفجير في أوروبا حدوث «تسريبات» إلى الصحافة بقصد إثارة مقالات في الاتجاه الذي يريده جهاز الموساد، بل والقيام بحملات التضليل الإعلامي إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي كل مرّة كان ينبغي «اختيار» أن تكون إسرائيل الهدف أو الضحية. وكان القرار يعود لاعتبارات سياسية محضة ترمي إلى تحويل الأنظار عن مناورة دبلوماسية تنوي إسرائيل القيام بها في الشرق الأوسط أو الحصول على التعاطف معها خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
بداية الانحطاط
ينقل مؤلف الكتاب عن مائير أميت قوله أن جهاز الموساد قد بدأ بالانحطاط منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في شهر نوفمبر من عام 1995، أثناء اجتماع جماهيري مؤيد للسلام.
ويؤكد أميت، أثناء لقائه مؤخرا مع المؤلف، أن المدير العام للموساد «شاباتي شافيت» كان قد أخطر المقربين من رابين بإمكانية اقتراف عملية اغتيال. وقد قال أحد هؤلاء المقرّبين أن الإنذار كان غامضا إلى درجة «لا يمكن أن ينبئ معها أنه كان هناك تهديد حقيقي».
ميدان عمل الموساد هو الخارج، وكل عميل فيه ينبغي عليه المرور في المدرسة الخاصة للجهاز الموجودة بالقرب من تل أبيب. ومن الممنوع على وسائل الإعلام الإسرائيلية الكشف عن وجودها، تحت طائلة العقاب.
وقد ثارت ضجة كبيرة في تل أبيب عام 1996 عندما أفصحت صحيفة إسرائيلية عن اسم المدير العام للموساد «داني ياتوم». طالب البعض بضرورة ايداع الصحافي السجن، وليس وحده وإنما رئيس تحرير الصحيفة معه. لكن لم يتم ذلك بعد أن لاحظ مسؤولو جهاز الموساد أنفسهم أن العديد من الصحف العالمية كانت قد نشرت اسم ياتوم. وكان رأي أميت هو:
«إن الإفصاح عن اسم مدير الموساد وهو على رأس عمله أمر خطير جدا. والجاسوسية نشاط سري غالبا وغير مريح. وليس مهماً ما يفعله جاسوس وإنما تنبغي حمايته. وتمكن معاملته بقسوة داخل الجهاز ولكن على مستوى الخارج يجب عدم المساس به بل ينبغي أن يبقى مجهولا».
كان اسم «مائير أميت» المتعارف عليه عندما كان رئيسا للموساد هو «رام». وكان على اقتناع بأنه ينبغي تحقيق مقولة «إسرائيل الكبرى». كان قد انخرط في صفوف الجيش وعمل قائدا لكتيبة مدة عامين في ظل قيادة موشي ديان.
ووصل بعد ذلك إلى مرتبة قائد عمليات الجيش، أي الشخصية الثانية في القوات المسلحة الإسرائيلية. ترك صفوف الجيش إثر خلل في عمل مظلته أثناء إحدى القفزات. فسافر إلى أميركا للدراسة في جامعة كولومبيا. وبعد عودته عرض عليه موشي ديان رئاسة الاستخبارات العسكرية، ثم خلف إيسر هاريل في رئاسة الموساد بتاريخ 25 مارس 1963.
ومائير أميت هو الذي شرع بانتهاج سياسة اغتيال أعداء الموساد. وهو الذي أقام علاقات سرية مع جهاز الكي.جي.بي السوفييتي وهو الذي زاد من إيقاع استخدام النساء في الجاسوسية وقيامهن بدور «الطعم» أحيانا، الأمر الذي لم يكن بعيدا عن ولوج العديد من الدوائر. وكان يصف دائما طريقة عمله بالقول: «هذا سر، إنه سرّي».
ترك مائير اميت إدارة جهاز الموساد عام 1968، ليعيش بعدها في أحد أحياء تل أبيب، ولا يعرف ماضيه سوى أفراد أسرته المقربين، وهو لا يزال يحرص على أن يبقى بعيدا عن الأنظار. وقد طبّق حتى بعد تركه لإدارة الموساد بسنوات طويلة نفس المبدأ الذي كان يردده وهو أن «الجاسوسية مسألة ذكاء وليست مسألة عضلات».
ويبقى خصمه الأول والأخير هم العرب. وكان مائير أميت قد غادر إدارة جهاز الموساد بكل هدوء. وفي اليوم الأخير استدعى المتعاونين معه في إدارة الجهاز وقال لهم مرّة أخيرة إذا كان العمل في الموساد يطرح عليهم إشكالية أخلاقية فما عليهم سوى أن يتركوه على الفور. كانت تلك هي آخر كلماته لهم قبل أن يصافحهم مغادراً المقر من دون عودة إليه.
كانت هناك، في الواقع، أزمة تلوح في أفق العلاقات بين الموساد وأجهزة الاستخبارات الأميركية وتهدد ذلك التحالف القائم بينهما آنذاك، وبدا أنه قد تكون لها نتائج وخيمة بالنسبة لإسرائيل.
كان في قلب تلك الأزمة أحد العملاء الذين عملوا تحت أمرة مائير أميت، وهو عميل، ليس كالآخرين، إذ نال شهرة بعد تخطيطه وتنفيذه لعملية اختطاف المسؤول النازي السابق أدولف إيخمان من الأرجنتين وإعادته إلى إسرائيل حيث حوكم وأعدم، الشخص المقصود هنا اسمه رافائيل إيتان، الشهير بـ «رافي».
أولوية إسرائيلية للتجسس العلمي والتقني على أميركا
* الحلقة الثالثة :
يجد القارئ نفسه هنا على موعد مع عمليتين من عمليات الموساد يفصلهما مدى زمني بعيد، وبالتالي فإنهما تتيحان إلقاء نظرة على تطور الأساليب التي يعمل بها والإمكانات الموضوعة تحت تصرفه، العملية الأولى هي اختطاف أدولف ايخمان في الأرجنتين والثانية هي تجنيد جوناثان بولارد والحصول من خلاله على ألوف الوثائق الأميركية ذات الأهمية البالغة التي تكشف أدق أسرار المنطقة وأكثرها حساسية.
تعلّم سكان ضاحية أفيكا في شمال تل أبيب رؤية رافائيل إيتان بنظارتيه السميكتين والأصم تماما بأذنه اليمنى وهو يحمل تحت ذراعيه أنابيب قديمة أو سلاسل دراجات صدئة أو أشياء معدنية أخرى عتيقة. وما إن يصل إلى بيته حتى يلبس بزة العمل الزرقاء ويضع على وجهه قناع السبّاكين قبل لحم المعادن أو فكّ لحامها.
كان جيرانه يتساءلون عمّا إذا لم يكن يريد بذلك الهروب من ماضيه، لاسيما وأنهم كانوا يعرفون أنه قد قام بالقتل عدة مرّات، ليس في أرض المعارك وإنما في عمليات سرّية. ولم يكن أحد من أولئك الجيران يعرف عدد الذين قتلهم أحيانا رفسا بحذائه. يقول هو نفسه: «في كل مرّة كان علي أن أقتل أحدهم، كنت أحسّ بحاجة الى النظر إليه وجها لوجه، في بياض عينيه، ثم أشعر بالارتياح والتركيز. ولا أعود أفكر إلا بما ينبغي علي عمله، وكنت أفعله، هذا كل شيء».
كان رافي إيتان خلال ربع قرن نائب مدير عمليات الموساد. لم يكن من النوع الذي يجلس وراء مكتبه كي يقرأ التقارير بينما يقوم الآخرون بالعمليات في أرض الميدان. لذلك لم يكن يترك أية مناسبة للمشاركة في أية عملية وذلك تحت شعار: «عندما لا يشارك المرء في الحل، فهذا يعني أنه يشارك في المشكلة». وكان من أهم العمليات التي قام بها وجلبت له شهرة كبيرة عملية اختطاف أدولف إيخمان، أحد كبار مسؤولي النظام النازي الألماني.
عملية إيخمان
في عام 1957 وصلت إلى الموساد معلومة تفيد أنه تم رصد أدولف إيخمان في الأرجنتين، وتمّ تكليف رافائيل إيتان بخطف النازي السابق وجلبه إلى إسرائيل. لقد زيّنوا له العملية وأفهموه أنها سوف تضع جهاز الموساد في طليعة الأجهزة السرية العالمية، إذ ربما ليس هناك أي جهاز آخر يمكن أن يفكر بمثل هذه العملية. كانت المخاطر هائلة، فإيتان سيقوم بالعملية على بعد آلاف الكيلومترات وبهوية مستعارة ومن دون أي دعم وبوسط معادي إلى حد ما فالأرجنتين كانت ملاذ النازيين، وبالتالي يمكن للفشل أن يؤدي إلى السجن، وربما إلى المقبرة.
انتظر إيتان مدة عامين كاملين قبل أن تتأكد المعلومة الأولية التي تثبت حقيقة أن الرجل الذي كان يعيش في إحدى الضواحي البورجوازية لمدينة بيونس أيريس تحت اسم ريكاردو كليمانت هو بالفعل أدولف إيخمان. تجمّد الدم في عروق رافائيل إيتان عندما أعطوه الضوء الأخضر للشروع بالعملية. فالعواقب المترتبة على العملية قد تكون شديدة الخطورة.
استأجرت شركة «العال» الإسرائيلية للطيران، طائرة إنجليزية من أجل القيام بالرحلة الطويلة إلى بيونس أيريس. يقول إيتان: «أرسلنا أحدهم إلى بريطانيا، لقد دفع المبلغ المطلوب وحصلنا على الطائرة. كانت الرحلة تنقل رسمياً وفداً إسرائيلياً للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئة والخمسين لاستقلال الأرجنتين. ولم يكن أي من أعضاء الوفد يعرف سبب وجودنا معهم، وكانوا يجهلون أيضا أننا كنا قد جهّزنا زنزانة في مؤخرة الطائرة من أجل وضع إيخمان فيها عند العودة».
وصل إيتان ورجاله إلى العاصمة الأرجنتينية في أول مايو 1960، ونزلوا في إحدى الشقق السبع التي جرى استئجارها من أجلهم، وبحيث يتم استخدام إحداها كسجن مؤقت لإيخمان قبل ترحيله. استؤجرت 12 سيارة من أجل العملية. راقب إيتان وفريقه إيخمان طيلة ثلاثة أيام وعرفوا أنه ينزل في محطة محددة من حافلة النقل العام عند زاوية شارع غاريبالدي.
وفي مساء العاشر من شهر مايو 1960 قرر إيتان الانتقال إلى التنفيذ يرافقه سائق ورجلان مكلفان بالسيطرة على إيخمان عندما يصبح داخل السيارة. كان أحد الرجلين قد تلقى تدريبا خاصا للسيطرة على الأشخاص في الشارع. وكان يُفترض أن يبقى إيتان داخل السيارة بجانب السائق و«تقديم المساعدة إذا دعت الحاجة».
تحدد موعد تنفيذ العملية في اليوم التالي. ويوم الحادي عشر من مايو وصلت سيارة الموساد إلى شارع غاريبالدي. لم يكن أحد ينبس ببنت شفة، إذ لم يكن هناك ما يقال. كانت حافلات للنقل تقف وتكمل سيرها وعند الساعة الثامنة وخمس دقائق رصدوا إيخمان في إحدى الحافلات. يقول إيتان: «بدا إيخمان متعباً (...). كان الشارع مقفراً.
وسمعت عميلنا الأخصائي بالخطف يفتح باب السيارة قليلا خلفي. وعندما وصلنا إلى محاذاة إيخمان كان يمشي بخطوات سريعة كأنه في عجلة للعودة إلى منزله وتناول طعام العشاء (...). كان مقررا أن تستمر العملية اثنتي عشرة ثانية، ينطلق أثناءها رجلنا من المقعد الخلفي ويمسك إيخمان من رقبته ثم يدفعه إلى داخل السيارة».
وقفت السيارة بمحاذاة إيخمان. استدار ونظر مندهشاً للعميل الذي انطلق من المقعد الخلفي للسيارة. لكن هذا العميل مشى فجأة على رباط حذائه المفكوك وكاد يقع على رأسه. وكاد إيخمان أن ينجو بسبب رباط حذاء مفكوك. أسرع إيخمان الخطى؛ فانطلق إيتان من السيارة. يقول: «لقد أمسكته من رقبته بقوة رأيت عينيه تجحظان بسببها. ولو أنني شددت قبضتي قليلا فلربما كنت قتلته. كان مساعدي قد وقف وفتح لي باب السيارة فدفعت إيخمان على المقعد الخلفي، وتبعه عميلنا. استمرت العملية كلها خمس ثوان».
أُدين إيخمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقبيل إعدامه في 31 مايو 1962 كان رافائيل إيتان في زنزانة تنفيذ الحكم بسجن الرملة. يقول: «نظر لي إيخمان وقال لي: سيأتي دورك أيها اليهودي!، فأجبته: ليس اليوم، ليس اليوم». وكان قد تمّ بناء فرن خاص من أجل حرق جثته؛ وألقي رماده في البحر. لقد حرص بن غوريون على أن لا يبقى أي أثر منه كي يحول دون قيام الذين يحنّون للنازية بتكريمه. نظر رافائيل إيتان يومها طويلاً إلى أمواج البحر وهو في غاية الارتياح.
مهام مختلفة
تابع رافي إيتان عمليات الاغتيال في أوروبا بواسطة القنابل التي يجري تفجيرها عن بعد، أو بواسطة مسدس «بيريتا»، السلاح المفضل بالنسبة لجهاز الموساد. وكان إيتان يقوم بعمليات القتل من دون أن يهتز له جفن. وكان في كل سفرة إلى الخارج ينتحل هوية مزورة مختلفة من بين المخزون الهائل لدى الموساد من جوازات سفر وهويات مزورة أو مسروقة. وأظهر إيتان براعة كبيرة في تجنيد المتطوعين «سيانيم» لمساعدة الموساد من بين اليهود في الخارج.
وكان يستجلبهم، كما شرح قائلا: «كنت أشرح لهم أن شعبنا قد أمضى ألفي عام وهو يحلم. وأننا صلينا نحن اليهود خلال تلك المدة كلها كي يأتي يوم الخلاص. واحتفظنا بذلك الحلم في أغانينا وكتاباتنا وقلوبنا، واليوم أصبح حقيقة. ثم كنت أضيف: كي تستمر هذه الحقيقة نحن بحاجة لأناس من أمثالكم». وفي المحصلة وجد إيتان نفسه على رأس أكثر من مائة شخص بينهم المحامي والطبيب والتاجر وربة المنزل وكلهم مستعدون لتنفيذ أوامره في مختلف أنحاء أوروبا.
حرص رافائيل إيتان على أن يبقى بعيدا عن الخصومات السياسية التي ظلّت متأججة بين الأجهزة السرية الإسرائيلية. وهكذا كان جهاز الاستخبارات الداخلية «شين بيت» وجهاز الاستخبارات العسكرية «أمان» يريدان التخلص من وصاية الموساد. لكن ما كان لموقع الموساد أن يهتز في ظل إدارة مائير أميت الذي استطاع إفشال جميع محاولات هز أسبقيته.
لكن عندما ترك أميت منصبه سعى العديد من الضباط إقناع إيتان بترشيح نفسه وأكّدوا له أنهم وراءه. لكن قبل أن يتحرك جرى تعيين زافي زامير مديراً جديداً للموساد. فاستقال إيتان وفتح مكتبا للاستشارات الأمنية.بعد عام فقط أعرب إيتان عن استعداده للعودة إلى صفوف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ذلك أنه في عام 1974 عيّن إسحق رابين المدعو إسحق هوفي على رأس الموساد وربط الجهاز الأمني بأرييل شارون مستشاره للشؤون الأمنية.
اختار شارون رافي إيتان كمساعد له. بعد ثلاث سنوات أصبح مناحيم بيغن رئيسا لوزراء إسرائيل فاختار إيتان كمستشار أمني شخصي عنده. المهمة الأولى التي حددها إيتان، في هذا الموقع الجديد، هي اغتيال أعضاء منظمة إيلول الأسود الفلسطينية. وبعد عمليات اغتيال في روما وباريس ونيقوسيا لمن اعتبرهم الموساد بين منفذي عملية ميونيخ عام 1972 التي قُتل فيها أحد عشر رياضيا إسرائيليا، حدد رافي إيتان هدفه الجديد: علي حسن سلامة الذي استطاع أن ينجو في الدقيقة الأخيرة من محاولات لاغتياله أثناء تنقله بين العديد من العواصم وقبل أن يستقر في العاصمة اللبنانية بيروت.
ذهب رافائيل إيتان إلى بيروت بصفة رجل أعمال يوناني حيث استطاع التعرف على عنوان إقامة علي حسن سلامة. عاد بعدها إلى تل أبيب وأرسل ثلاثة من عملائه إلى العاصمة اللبنانية استأجر أحدهم سيارة وقاموا بحشوها بالمتفجرات وأوقفوها في الطريق الذي يسلكه هدفهم كل يوم وهو في طريقه إلى مكتبه. وفي لحظة مروره جرى تفجيرها وقتله.
وتقديرا من مناحيم بيجن لمواهب رافائيل إيتان عيّنه مديرا لمكتب العلاقات العلمية «لاكام» الذي تأسس عام 1960 في إطار وزارة الدفاع مع مهمة محددة هي «جمع المعلومات بكل السبل الممكنة». أثار هذا المكتب عداء جهاز الموساد في البداية إذ رأى فيه منافسا وحاول مائير أميت وقبله إيسر هاريل حذفه أو «امتصاصه». لكن شيمون بيريز الذي كان نائبا لوزير الدفاع أصرّ على بقائه، بل وفتح «لاكام» مكاتب له في نيويورك وبوسطن وواشنطن ولوس أنجلوس؛ أي في الأماكن الرئيسية لتواجد التكنولوجيات المتقدمة.
وفي عام 1968 حُكم على أحد مهندسي طائرة الميراج-3 الفرنسية بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب تسليمه معطيات كافية لبناء مثل تلك الطائرة لمكتب «لاكام». وعلى أساس هذا «النجاح» في الحصول على أسرار الطائرة المقاتلة الفرنسية قبل «إيتان» تولي رئاسة المكتب المعني مع طموحه في أن يجعل منه جهازا متميّزا في عالم التجسس.
وفي الوقت نفسه أعاد الصلة من جديد مع جهازه السابق «الموساد» الذي كان قد تولّى إدارته ناحوم ادموني الذي كان، مثل إيتان، يحذر كثيرا من النوايا الأميركية حيال الشرق الأوسط، وكان يرى بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لا تقدم له سوى معلومات متواضعة.
وزاد قلق مدير الموساد الجديد بعد تلقيه تقارير من عملائه في واشنطن أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية قد التقوا بزعماء عرب قريبين من ياسر عرفات وأنه يجري البحث من أجل إرغام إسرائيل على قبول المطالب الفلسطينية. وشرح ادموني لإيتان أنه لم يعد يستطيع اعتبار الولايات المتحدة ك«حليف له مصداقيته طيلة الوقت».
بالإضافة إلى هذا وصل إلى مسامع عملاء للموساد في شهر أغسطس 1983 أن عملية يتم تحضيرها ضد القوات الأميركية العاملة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في بيروت. وكان أولئك العملاء قد رصدوا وجود شاحنة مرسيدس قد تكون مفخخة. كان ينبغي على الموساد حسب الاتفاقات المبرمة إحالة المعلومات فوراً إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
لكن أثناء اجتماع للقيادة الإسرائيلية تلقى جهاز الموساد الأمر التالي: افعلوا كل ما هو ضروري لمراقبة شاحنة المرسيدس. أمّا بالنسبة لليانكي - الجنود الأميركيين - فليس مهمتنا هي حمايتهم، ويستطيعون أن يتكفّلوا هم أنفسهم بذلك. ولا مجال لعمل أكثر من ذلك لهم».
وبتاريخ 23 أكتوبر 1983، وتحت أنظار عملاء الموساد، انطلقت الشاحنة المفخخة بسرعة وصدمت قيادة المارينز بالقرب من مطار بيروت لتقُتل 243 جندياً أميركياً في الانفجار. وينقل المؤلف عن فكتور اوستروفسكي، العميل الإسرائيلي السابق، قوله أن رد فعل الموساد كان: «لقد أرادوا دسّ أنفهم في الورطة اللبنانية، وهم يدفعون الثمن».
التجسس على أميركا
في هذا السياق، جعل رافائيل إيتان من التجسس العلمي والتكنولوجي في الولايات المتحدة هدفا له، وكانت العقبة الأولى أمامه هي إيجاد مخبر فني في موقع رفيع. بحث في قائمة «المتطوعين» لخدمة إسرائيل مجانا التي كان قد أعدّها عندما كان في الموساد، وأشاع حوله أنه مهتم بكل شخصية علمية مقيمة في الولايات المتحدة ومتعاطفة مع إسرائيل.
ولم يحصل على أية نتيجة خلال عدة أشهر. لكن في شهر أبريل عام 1984 أخبره العقيد سيللا الذي كان يدرس المعلوماتية في نيويورك، وقائد السرب الذي كان قد قصف المفاعل الذري العراقي قبل ثلاث سنوات، إنه تعرّف على المدعو جوناثان بولارد أثناء حفلة عشاء نظمها ثريّ يهودي.
كشف له بولارد يومها أنه متحمس للصهيونية من جهة، ويعمل لصالح الاستخبارات البحرية الأميركية. واستطاع سيللا أن يعرف بعد فترة وجيزة أن بولارد يعمل في المركز السرّي لمكافحة الإرهاب التابع للبحرية الأميركية والموجود في سويتلاند بولاية ماريلاند. وكان من بين مهماته تحليل الوثائق المصنفة «أسرار دفاعية» والخاصة بجميع المنظمات الإرهابية في العالم.
كان منصبا شديد الحساسية سمح لبولارد أن يطلع على أعلى مستويات السرية في إطار أجهزة الاستخبارات الأميركية. ولم يصدّق سيللا أذنيه وهو يسمع محدثه يقدم له تفاصيل دقيقة حول قضايا رفضت فيها المصالح الأميركية التعاون الوثيق مع الأجهزة الإسرائيلية. وقد أشار سيللا أنه اعتراه الشك آنذاك بأن الأمر قد يتعلق بفخ نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. لكن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي أعطاه الأوامر بتعميق الصلة مع بولارد.
تعددت لقاءات سيللا وبولارد بعد ذلك في ملاعب رياضية أو في أحد المقاهي. وفي كل مرة كان بولارد يجلب معه وثائق في غاية السرية من أجل إثبات إخلاصه، وكان سيللا يرسلها مباشرة إلى تل أبيب. كانت دهشته شديدة عندما عرف أن الموساد قد اتصل قبل عامين ببولارد ولكنه وجده «شخصية غير مستقرة».
وذات يوم قام سيللا بدعوة يوسف ياجور، الذي كان يعمل بصفة ملحق علمي في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك والتابع لمكتب «لاكام» الذي كان يديره رافائيل إيتان، لتناول طعام العشاء مع بولارد. في ذلك العشاء كرر بولارد أن الولايات المتحدة تبخل بمعلوماتها على إسرائيل لأنها تريد المحافظة على علاقات جيدة مع البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.
وفي نفس ذلك المساء اتصل يوسف ياجور، بواسطة خط هاتفي محمي من عمليات التنصت، بمعلمه رافائيل إيتان الذي طلب منه أن يعمق صلاته أكثر مع بولارد وزوجته المقبلة، آن هندرسون. هكذا تكررت دعواتهما لتناول وجبات الطعام في المطاعم الفاخرة ولحضور حفلات العروض السينمائية الخاصة للأفلام الجديدة. وبنفس الوقت كان الجاسوس الذي تمّ تجنيده يقدم لإسرائيل وثائق في غاية الأهمية والتي اولاها إيتان أهمية كبيرة ورأى أنه حان الوقت للتعرف على مصدر معلوماته الثمين الجديد.
في نوفمبر 1984 قام سيللا وياجور بتقديم هدية إلى بولارد وآن هندرسون تمثلت في رحلة إلى باريس مدفوعة التكاليف بشكل كامل. وشرح ياجور لبولارد أن هذه الرحلة كانت بمثابة «مكافأة متواضعة بالقياس إلى الخدمات الجليلة التي تقدمها لإسرائيل«. لقد سافرا إلى فرنسا بالدرجة الأولى وكان في استقبالهما بمطار باريس سائق قادهما إلى فندق البريستول الشهير حيث كان بانتظارهما رافائيل إيتان.
في نهاية اللقاء اتفق إيتان مع بولارد على أن لا تعود اللقاءات مع عملاء الموساد مجرد لقاءات صداقة وفي مناسبات وإنما أصبحت لقاءات «عمل». خرج سيللا من الصورة وأصبح ياجور هو العميل المسؤول رسميا عن جوناثان بولارد. وتمّ الاتفاق على نظام جديد لتسليم الوثائق بحيث أصبح بولارد يجلبها إلى شقّة المدعوة «ايريت ايرب»، السكرتيرة في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وحيث كانت قد وُضعت في مطبخها آلة تصوير ذات سرعة كبيرة لأخذ نسخ عن جميع تلك الوثائق وكانت زيارات بولارد لهذه السكرتيرة تتعاقب مع مروره إلى عدة مغاسل للسيارات، حيث كانت سيارته بصدد الغسيل آليا،
كان يعطي الوثائق التي بحوزته سرا ليوسف ياجور الذي تكون سيارته أيضا بصدد الغسيل في الآلة المجاورة. وكان ياجور قد زوّد سيارته بآلة تصوير مخفية تحت المقود. بكل الحالات كانت شقة ايريت ومغاسل السيارات قريبة من مطار واشنطن مما كان يسهّل انتقال ياجور بين العاصمة الفيدرالية ونيوروك. وما إن كان يصل إلى القنصلية حتى يبعث ما لديه من وثائق عبر «فاكس محمي» إلى تل أبيب.
تجاوزت المعلومات المحصلة توقعات رافائيل إيتان إذ وصلته ذات يوم معلومات مفصّلة عن آخر الأسلحة التي قامت روسيا بتزويد سوريا بها مع تحديد دقيق لمواقع صواريخ اس.اس-21 وسي.آ-5، وكذلك خرائط وصور للترسانات العسكرية السورية والعراقية والإيرانية، بما في ذلك صور مصانع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وفضلاً عن الحساسية الكبرى للمعلومات المحصّلة توضحت أيضا بالنسبة لإيتان طرق التجسس التي تتبعها الأجهزة السرية الأميركية في الشرق الأوسط ولكن أيضا في جنوب إفريقيا. وكان بولارد قد سلّم للإسرائيليين تقريراً أعدّته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن البنية الكاملة لشبكة جواسيسها في تلك البلاد ـ جنوب إفريقيا.
كذلك سلّمهم وثيقة أخرى تشرح بأدق التفاصيل كيف قامت جنوب إفريقيا بأول تفجير ذرّي يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر 1979 في جنوب المحيط الهندي. لكن حكومة بريتوريا نفت باستمرار امتلاكها للقدرة النووية. وتصرّف رافائيل إيتان بطريقة قام من خلالها عملاء الموساد بتسليم حكومة جنوب إفريقيا جميع الوثائق الأميركية التي تخصّها، مما أدّى إلى تفكيك كامل مباشر لشبكة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فيها. وتوجب أن يغادر 12 عميلا البلاد بأقصى سرعة ممكنة.
سقوط بولارد
قام جوناثان بولارد خلال الأحد عشر شهرا التالية بتسليم الإسرائيليين أخطر المعلومات التي جمعتها الأجهزة السرية الأميركية. وتمّ هكذا تحويل أكثر من ألف وثيقة «سرّية للغاية« إلى إسرائيل، حيث كان رافائيل إيتان يدقق فيها بإعجاب قبل أن يسلمها بدوره إلى إدارة جهاز الموساد. وبالاعتماد على المعلومات المجمّعة قام ناحوم ادموني مدير الموساد بتقديم توصيات إلى الحكومة الائتلافية التي كان يتولى رئاستها آنذاك شيمون بيريز حول أفضل طريقة للتصرف حيال السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
وينقل المؤلف عن محضر للاجتماعات الوزارية الإسرائيلية آنذاك ما يلي: «عندما يتم الاستماع إلى ناحوم ادموني، يسود تقريبا الشعور أن المرء يجلس مع الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. ولم نكن على اطلاع فوري بآخر الأفكار التي تنبثق في واشنطن حيال القضايا التي تهمنا من قريب أو بعيد فحسب، ولكن كان لدينا أيضا الوقت من أجل التأمل والتفكير قبل اتخاذ أي قرار.
أصبح جوناثان بولارد عنصراً حاسماً في السياسة الإسرائيلية وفي اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وقام إيتان بتزويده بجواز سفر إسرائيلي تحت اسم داني كوهين وقرر له مرتباً شهرياً كبيراً. بالمقابل طلب منه معلومات وتفاصيل إضافية عن نشاطات التجسس الإلكتروني لوكالة الأمن القومي في إسرائيل وعن طرق التنصّت المستخدمة حيال السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وعلى البعثات الدبلوماسية الأخرى للدولة العبرية في الولايات المتحدة الأميركية.
لم يتمكن بولارد من تزويده بالمعلومات المطلوبة إذ جرى اعتقاله بتاريخ 21 نوفمبر 1985 أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبعد عدة ساعات فقط كان يوسف ياجور والعقيد سيللا والسكرتيرة ايريت ايرب في الطائرة بالطريق إلى إسرائيل قبل أن يسائلهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. أما بولارد فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد وصدر على زوجته حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
أطلق مؤتمر المنظمات اليهودية بالاشتراك مع أكثر من خمسين مجموعة أخرى في عام 1999 حملة مكثفة لإطلاق سراح بولارد. وروّج اللوبي اليهودي لفكرة تقول أنه لم يقترف جريمة الخيانة العظمى حيال الولايات المتحدة «ذلك أن إسرائيل كانت آنذاك ولا تزال اليوم حليفا قريبا». ودعمت المنظمات اليهودية الدينية تلك الحملة. وصرّح أستاذ القانون في جامعة هارفارد الان م. ديرشفيتز محامي بولارد أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الجاسوس قد مس «قدرة أجهزة استخبارات الأمة» أو «نشر معطيات حولها على الصعيد العالمي.
في مواجهة تلك الحملة المسيّرة من إسرائيل عرفت أجهزة الاستخبارات الأميركية مبادرة غير مسبوقة إذ خرج عدد من أعضائها إلى النور وحاولوا إثبات خيانة بولارد. وأدّى هذا إلى تعبئة أكبر من اللوبي اليهودي القوي. وخشيت الأجهزة السرية الأميركية أن يقوم بيل كلنتون في إحدى أزماته الدونكيخوتية، حسب تعبير أحد ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بإطلاق سراح بولارد قبل نهاية ولايته الرئاسية.
وقال جورج تينيت، رئيس الوكالة آنذاك، لكلينتون: «إن إطلاق سراح بولارد سيثبط من عزيمة الأجهزة السرية». وهذا ما أجاب عليه كلنتون بالقول «سنرى، سنرى».كان رافائيل إيتان يراقب كل ما يجري حول قضية بولارد بانتباه كبير لكنه كان مشغولا أيضا بقضية أخرى أكثر أهمية وتخص الملف النووي الإسرائيلي.
الإسرائيليون يخدعون المفتشين الأميركيين في صحراء النقب
*الحلقة الرابعة :
ينتقل المؤلف هنا إلى موضوعين على جانب كبير من الأهمية، أولهما مساهمة الموساد في تحويل مفاعل ديمونة من مشروع يحظى بحماس ديفيد بن غوريون إلى أمر واقع، والثاني توظيف عملاء الموساد للاغتيال كأداة للحركة السياسية، بما في ذلك اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير والمناضل فتحي الشقاقي والعالم الكندي جيرالد بول ومحاولة أغتيال خالد مشعل، ثم يفتح المؤلف الباب أمام حشد من علامات الاستفهام حول اغتيال اسحق رابين، تثير الشكوك في الرواية الرسمية لمقتل رابين.
شاعت لسنوات طويلة مقولة أن إسرائيل لديها ما وصف بأنه «أفضل جيش نظامي» في منطقة الشرق الأوسط. ولكن لم يكن ديفيد بن غوريون مكتفيا بذلك، وإنما أصدر الأوامر ببناء مفاعل ذري في صحراء النقب بالقرب من ديمونة.عمل في ذلك المفاعل 2500 عالم وتقني. وصمم المهندسون منشأة على عمق 25 متراً تحت الأرض لوضع المفاعل في قلب مختبر هائل «ماخون-2». ويقوم عمل هذا المختبر على نظام فصل وإعادة معالجة المواد المشعّة، وكان قد جرى استيراده من فرنسا تحت تسمية رسمية هي «آلات لصناعة النسيج».
لم يكن مفاعل ديمونة وحده كافياً لتزويد إسرائيل بالقنبلة النووية، بل كان لابد من توفير المادة الانشطارية، أي اليورانيوم المخصّب أو البلوتونيوم. لكن القوى النووية القليلة آنذاك وقّعت معاهدة التزمت من خلالها بعدم تزويد أي بلد بغرام واحد من المواد القابلة للانشطار التي كان مفاعل ديمونة بدونها منشأة غير عملية.بعد ثلاثة أشهر من نصب المفاعل ف1تحت مؤسسة صغيرة لإعادة معالجة المواد المشعّة أبوابها في معمل قديم للحديد في ابوللو ببنسلفانيا.
حملت هذه المؤسسة اسم شركة نوميك للمواد النووية وتجهيزاتها. كان مديرها العام هو سلمان شابيرو الذي كان اسمه على القوائم التي أعدّها رافائيل إيتان لليهود الأميركيين الأكثر نفوذا في المجال العلمي، كما كان اسمه موجودا على قائمة دافعي الأموال «الأكثر كرماً» لإسرائيل. كان ذلك إذن هو المدخل إلى الصناعة النووية الأميركية عن طريق شابيرو هذا، ابن الحاخام، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة جون هوبكنز.
لم يبد أن الإدارة الأميركية كانت متحمسة آنذاك لحصول إسرائيل على السلاح النووي. وينقل المؤلف أن رسالة وجهها الرئيس الأميركي جون كنيدي في فبراير 1961 إلى دافيد بن غوريون يطلب فيها وضع مفاعل ديمونة في خطط التفتيش المنتظمة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما اعتبره بن غوريون بمثابة «ضغط أميركي» بل وقال: «إن وجود كاثوليكي في البيت الأبيض ليس أمرا جيدا بالنسبة لإسرائيل». وطلب بن غوريون بعدها مساعدة رجل يثق به في واشنطن هو أبراهام فينبيرغ، الصهيوني المتزمت والمؤيد للتطلعات النووية لإسرائيل.
كان فينبيرغ من أغنى اليهود في الحزب الديمقراطي. ولم يكن يخفى القول أنه إذا كان قد تبرع بمليون دولار لحزب كنيدي، فإنما كان ذلك من أجل الدفاع عن قضايا إسرائيل في الكونغرس. وكانت طريقته المفضلة في العمل هي ممارسة الضغط السياسي المباشر، وقد قال صراحة لكنيدي عندما كان مرشحا: «نحن مستعدون لدفع قيمة فواتيرك إذا تركتنا نشرف على سياستك في منطقة الشرق الأوسط»، يومها اكتفى كنيدي بوعد «منح إسرائيل جميع التنازلات الممكنة».
فدفع فينبيرغ 000 500 دولار ك«بداية». كان العرض واضحا وهو أنه إذا كان الرئيس الأميركي يصر على متابعة المطالبة بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمفاعل «ديمونة» فإنه «عليه أن لا يعتمد على الدعم المالي لليهود خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة». ووجد فينبيرغ دعما مهما لدى وزير الخارجية الأميركي آنذاك روبت مكنمارا الذي قال للرئيس أنه يتفهم «رغبة إسرائيل في امتلاك القنبلة الذرية».
أصرّ كنيدي على موقفه وتوجب على بن غوريون قبول مبدأ القيام بجولة تفتيشية. لكن كنيدي قدّم في الدقيقة الأخيرة تنازلين مهمين. فمقابل السماح بالدخول إلى مفاعل ديمونة تقوم الولايات المتحدة ببيع الدولة العبرية صواريخ أرض ـ جو من طراز هاواك. أي سلاح الدفاع الأميركي الأكثر كفاءة في عصره. ثم إن عملية التفتيش لن تجري من قبل تقنيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنما من قبل فريق أميركي حصرا وبعد برمجة الزيارة بعدة أسابيع مقدّما.
لقد خدع الإسرائيليون المفتشين الأميركيين وبنوا فوق مفاعل ديمونة الحقيقي مركزا للمراقبة كي يدفعوا أولئك المفتشين للاعتقاد أن الأمر يتعلق فعلا بمفاعل يرمي إلى تحويل صحراء النقب إلى فردوس أخضر. أمّا القسم الذي كان يتم تزويده ب«الماء الثقيل» الآتي من فرنسا والنرويج فلم يسمحوا بتفتيشه ل«أسباب أمنية». وكان يكفي للتقنيين أن يلقوا نظرة على محتوى الأوعية كي يفهموا ما فيها. وعندما وصل الأميركيون اكتشف الإسرائيليون أنه ليس فيهم من يتحدث اللغة العبرية، مما كان يقلل من حظوظ إمكانية اكتشافهم للأهداف الحقيقية لمفاعل «ديمونة».
في تلك الأثناء وافقت السلطات الأميركية على طلب تقدّمت به السفارة الإسرائيلية في واشنطن للجنة الطاقة الذرية من أجل السماح ل«مجموعة من العلماء بزيارة شركة نوميك من أجل أن يفهموا بشكل أفضل أسباب قلق المفتشين الأميركيين في ميدان معالجة النفايات النووية». ومع الموافقة على ذلك الطلب أخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ما ينبغي للمراقبة ولمعرفة إذا كان سلمان شابيرو، رئيس الشركة، يتعاون أولا مع الأجهزة السرية الإسرائيلية.
قرر رافائيل إيتان أن يقوم هو شخصيا بزيارة شركة نوميك برفقة فريق يضم عالمين كانا يعملان في مفاعل ديمونة كاختصاصيين في معالجة النفايات المشعة. كانت مهمة هذين العالمين هي إيجاد السبل لسرقة المادة القابلة للانشطار من شركة نوميك. كان رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يراقبون عن قرب الزيارة. وبدا أن تقارير المكتب تحمل الكثير من الشكوك فيما يتعلق بما كان يعرفه شابيرو عن الأسباب الحقيقية لزيارة رافائيل إيتان وأصحابه.
وأشار أحد تلك التقارير بعد شهر من تلك الزيارة إلى أن شركة نوميك قد وقعت عقد شراكة مع الحكومة الإسرائيلية من أجل تطوير «عمليات تعقيم الأطعمة والعينات الطبية بواسطة الإشعاع». بل وأشار تقرير آخر إلى «التحذير الملصق على الحاويات المعدنيّة والذي يدل على وجود مواد مشعّة خطيرة». ثم أضاف: «بسبب هذا التحذير لم يرد أحد فتح تلك الحاويات لتفحص ما بداخلها، ومنعونا نحن من عمل ذلك».
كانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد أفهمت وزارة الخارجية الأميركية أن أية محاولة لفتح حاوية من الحاويات سيترتب عليه وضعها في مصاف الحقيبة الدبلوماسية التي لا يحق للسلطات في بلدان التمثيل الدبلوماسي فتحها. هكذا وباسم الحصانة رأى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الحاويات التي يجري تحميلها في طائرة شحن تابعة لشركة العال الإسرائيلية أمام أعينهم دون أن يستطيعوا فعل أي شيء.
أحصى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تسع إرساليات تمّت بتلك الطريقة خلال الأشهر الستة التي تلت زيارة رافائيل إيتان لشركة سلمان شابيرو. ورأى المسؤولون عن المكتب أن كمية كافية من المواد الانشطارية لصناعة قنبلة ذرية قد وصلت إلى مفاعل ديمونة . نفى شابيرو أن يكون قد زوّد إسرائيل بأية مواد منها، لكن مكتب التحقيقات وجد «عجز» في كمية المواد الانشطارية التي تعاد معاملتها في شركته. قال شابيرو ان ضياع اليورانيوم يعود إلى «تسربه داخل الأرض« أو «تبخره في الهواء». مثّلت الكمية المفقودة 50 كيلوغراماً ولم يتم توجيه أية تهمة لشابيرو. لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن إسرائيل كانت بطريقها إلى تصنيع السلاح النووي.
الهدف أبو جهاد
ينقل مؤلف هذا الكتاب عن عميل أمضى ربع قرن من حياته في خدمة الموساد قوله: «كان لي الحق في أن أكذب لأن الحقيقة لم تكن تشكل جزءا من علاقتي مع الناس. كان هناك شيء واحد يهمني هو أن أستخدمهم لصالح إسرائيل». على هذا الأساس تربّى عملاء الموساد الذين كانوا يستهلون نشاطاتهم التجسسية في مهمات بالخارج. أما عدد عملاء الموساد فهو غير معروف، لكن عميل سابق للموساد هو فكتور اوستروفسكي كتب عام 1991 أن عددهم هو «حوالي 000 35 شخص في مختلف أنحاء العالم بينهم 000 20 يقومون بعمليات و000 15 نائمون، لا يقومون بأي نشاط» بينما يقوم العاملون بكل أنواع العمليات وفي مقدمتها التجسس والاغتيال.
وفي عام 1988 تولى إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، شخصيا عملية تخطيط وتنفيذ اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير، أبو جهاد. لقد قام عملاء الموساد طيلة شهرين بالرقابة المستمرة للفيلا التي كان يسكنها في ضاحية سيدي بوسعيد بالقرب من مدينة تونس. لقد راقبوا وعاينوا كل شيء من المداخل وعلو السور المحيط بها والمواد المتكون منها والنوافذ والأبواب والأقفال ووسائل الدفاع ومكان وجود الحرّاس الشخصيين ومسار حركتهم.
لقد راقبوا كل شيء وبأدق التفاصيل. وتلصصوا كذلك على زوجة أبوجهاد عندما كانت تلعب مع الأطفال وتبعوها عندما كانت تذهب للتسوق أو إلى صالون الحلاقة. والتقطوا الاتصالات الهاتفية التي كان يقوم بها زوجها. وحسبوا المسافة بين الغرف ودرسوا ساعات ذهاب وإياب الجيران وسجّلوا أرقام السيارات التي كانت تتردد إلى المنزل وأنواعها وألوانها. لقد طبّق القتلة القاعدة التي كان قد أرساها مائير أميت «عندما كان رئيسا لجهاز الموساد والقائلة إنه أثناء عمليات الاغتيال «ينبغي التفكير مثلما يفكر الهدف وعدم التوقف عند التشابه معه إلى اللحظة التي يتم فيها الضغط على الزناد».
كان عملاء الموساد قد خططوا لمهمتهم السوداء خلال شهر كامل في موقع للموساد في حيفا، وبتاريخ 16 أبريل 1988 أُعطي الضوء الأخضر للانطلاق بالعملية. وفي تلك الليلة أقلعت عدة طائرات إسرائيلية من طراز بوينغ 707 من قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب. وكان في الأولى إسحاق رابين وعدد من كبار الضباط الإسرائيليين.
كانوا على اتصال دائم مع فريق القتلة الذين أخذوا مواقعهم بالقرب من الفيللا التي كان يسكنها أبوجهاد وأسرته. قاد العملية عميل اسمه المستعار هو «سورد». وكانت الطائرة الثانية محشوة بآلات الالتقاط والتنصت والتشويش. أما الطائرتان الأخريتان فقد كانتا للدعم اللوجستي والتزويد بالوقود.
كانت الطائرات كلها تدور على ارتفاع عالي جدا فوق «فيللا» أبوجهاد في ضاحية سيدي بو سعيد قرب تونس وكانت على اتصال مع فريق سورد على الأرض بواسطة تردد لا سلكي خاص. وبعد منتصف ليلة 17 أبريل بقليل علم إسحق رابين ومن معه أن أبوجهاد قد عاد إلى منزله. بل أكد «سورد» أنه يسمع وقع خطوات القائد الفلسطيني وهو يصعد الدرج إلى الطابق الثاني حيث توجد زوجته ثم توجه إلى الغرفة المجاورة كي يقبل ابنه النائم ثم عاد إلى الطابق الأول حيث يوجد مكتبه.
وبعد 17 دقيقة من منتصف ليلة 17 أبريل 1988 أعطى إسحاق رابين الضوء الأخضر للشروع بعملية الاغتيال. كان سائق أبوجهاد ينام داخل سيارة المرسيدس خارج المنزل حيث كان الهدف الأول لأحد العملاء الذي أطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كاتم للصوت. ثم قام سورد وقاتل آخر بوضع عبوة ناسفة تحت البوابة الحديدية للفيللا.
اقتلعت هذه العبوة المتفجرة الجديدة المسماة «صامتة» البوابة دون أن تحدث أية ضجة تذكر. بعد ولوج المنزل قاما بقتل الحارسين الشخصيين، ثم دخل سورد إلى مكتب أبوجهاد الذي كان بصدد مشاهدة شريط فيديو يخص منظمة التحرير الفلسطينية. همّ أبوجهاد بالوقوف فأطلق عليه سورد رصاصتين استهدفتا صدره.
ثم اتجه القاتل نحو الباب للخروج فوجد بمواجهته أم جهاد فصرخ بوجهها باللغة العربية: ادخلي إلى غرفتك. كان ابنها بين ذراعيها. ثم «تبخر» سورد وفريق القتلة الذي رافقه وسط الظلام. استغرقت العملية ثلاث عشرة ثانية. لاقى اغتيال أبوجهاد صدى عالميا كبيرا بل ينقل المؤلف عن عزرا وايزمان، الوزير الإسرائيلي قوله: «ليس باغتيال الناس يمكن لمسيرة السلام أن تتقدم».
المسلسل يتسارع
لكن مسلسل الاغتيالات لم يتوقف، بل تسارع إيقاعه إلى هذا الحد أو ذاك. ذات مساء من أكتوبر 1995 جرى اجتماع على مستوى القيادة الإسرائيلية، وتحدد فيه الهدف الفلسطيني المقبل المطلوب اغتياله، لقد كان فتحي الشقاقي، المرجعية الدينية لتنظيم الجهاد الإسلامي. كان يومها في دمشق، وعلى أهبة التوجه إلى ليبيا. وكان يُفترض أن يمضي في طريق عودته يوما في جزيرة مالطة.
وكان «شابتاي شافيت» قد أرسل في آخر عملية له كرئيس للموساد، عميلا أسود» - كما يطلق على المخبرين من العرب في أوساط الموساد ـ إلى دمشق. وكانت مهمته هي تنشيط الرقابة الإلكترونية على منزل زعيم الجهاد الإسلامي وذلك بمساعدة أجهزة أميركية جديدة من الأكثر تقدما وذلك للتمكن من التنصت على منظومة الاتصالات التي كان يستخدمها وهي من صنع روسي. وبواسطة عمليات التنصت جرت معرفة تفاصيل رحلة فتحي الشقاقي إلى ليبيا عبر مالطة. وبالتالي لم يكن من الصعب التحضير لعملية اغتياله وتنفيذها.
فبتاريخ 24 أكتوبر 1995 سافر عميلان من جهاز الموساد إلى روما. وعند وصولهما إلى المطارين سلمهما عملاء محللون جواز سفر بريطانياً جديداً لكل منهما. ثم توجها إلى مالطة ونزلا عند وصولهما في غرفتين بفندق ديبلومات على مرفأ فاليتا. استأجر أحدهما دراجة نارية للاطلاع على معالم الجزيرة، كما قال. ولم ير أي عامل من عمال الفندق العميلين الإسرائيليين وهما يتبادلان الحديث. وعندما أشار أحد خدم الفندق لأحدهما أن حقيبته ثقيلة الوزن أجابه بغمزة عين أنها تحتوي على سبائك ذهبية.
في المساء نفسه أخطرت سفينة شحن إسرائيلية السلطات المالطية أنها تتجه إلى إيطاليا ولكنها أصيبت بعطل فني سيرغمها على البقاء في عرض البحر بمواجهة الجزيرة بانتظار القيام بإصلاح الخطأ الطارئ. كان على متن تلك السفينة شابتاي شافيت، مدير جهاز الموساد مع فريق من التقنيين المختصين بمجال الاتصالات. هكذا تم تبادل المعلومات بين الموجودين على السفينة وبين العميلين اللذين كان ثقل حقيبة أحدهما يعود إلى وجود جهاز إرسال بداخلها.
وفي الفندق نفسه قام فتحي الشقاقي بحجز غرفة له. وفي صباح اليوم التالي أطلق عليه عميلا الموساد عدة رصاصات، بعد أن كانا قد أوقفا الدراجة المستأجرة بمحاذاته وهو في طريقه للمطار عائدا إلى دمشق. بعد ساعة واحدة فقط من عملية الاغتيال انطلق من مرفأ فاليتا قارب صغير وعندما وصل إلى محاذاة سفينة الشحن الإسرائيلية «المعطلة» أخبر قبطانها السلطات المالطية أنه قد جرى إصلاح الخلل الميكانيكي «مؤقتا» ولذلك ينبغي عدم إكمال الطريق إلى إيطاليا والعودة إلى حيفا لإجراء عملية صيانة كاملة.
بعد عدة أيام فقط من اغتيال فتحي الشقاقي اغتيل إسحاق رابين، ذلك «الصقر» الذي تحول إلى «حمامة». لقد قتله يهودي متشدد اسمه إيغال أمير، وفي موقع ليس بعيدا عن مقر الموساد.لم يقتصر عملاء الموساد على استهداف القيادات الفلسطينية وإنما استهدفوا أولا الذين اعتبروهم في صفوف أعدائهم. كانت تلك هي حالة الدكتور «جيرالد بول»، العالم الكندي والخبير المعروف عالميا في ميدان صناعة المدافع.
كانت إسرائيل قد حاولت مرّات عديدة استمالته للتعاون معها لكنه رفض ذلك باستمرار، بل وقبل التعاون مع نظام صدام حسين من أجل تزويده بمدفع هائل يبلغ طوله 148 مترا ويزن 32 طنا من الأنابيب الفولاذية القادمة من شركات بريطانية. وأسس بول لهذا الغرض شركة في بروكسل ببلجيكا. جعل عملاء الموساد في هذه البلاد من التجسس على نشاطات الشركة إحدى مهامهم الرئيسية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك هو إسحاق شامير ذو الكفاءات العالية في عمليات الاغتيال المخططة منذ أن كان عضوا فاعلا في جماعة «الهاجاناه» التي مارست الكثير من العمليات الإرهابية في فلسطين قبل قيام الدولة العبرية. وأصدر شامير تعليمات لناحوم ادموني، مدير الموساد، باغتيال العالم الكندي .
بعد يومين من ذلك القرار وصل عميلان للموساد إلى بروكسل قادمين من تل أبيب، واستقبلهما عميل مقيم. كان يراقب تحركات «بول» منذ أسابيع. وفي 22 مارس 1990 توجّه العملاء الثلاثة إلى حيث كان يقطن هدفهم والذي أصبح ضحيتهم في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه. كان عمره آنذاك 61 سنة.
أكّد «مايكل» ابن العالم الكندي مرارا بعد ذلك أن والده كان على اقتناع تام أن عملاء الموساد يلاحقونه، لكن ما إن عاد القتلة الثلاثة إلى تل أبيب حتى بدأت إدارة الحرب النفسية في جهاز الموساد بنشر إشاعات، استخدمت فيها وسائل الإعلام، مفادها أن جيرالد بول قد اغتيل لأنه أراد أن يضع حدا لتعاونه مع نظام صدام حسين.
استهداف مشعل
لكن إذا كان شامير قد وسّع من دائرة الاغتيالات فإن بنيامين نتانياهو حدد أعداءه الرئيسيين الذين ينبغي قتلهم في قادة حركة حماس وينقل عنه المؤلف، كما قال عضو مهم في الأجهزة السرية الإسرائيلية، تصريحه: «أريد رأس هؤلاء الحاقدين في حماس، ولو كلّفني ذلك منصبي». ويضيف المسؤول في جهاز الموساد: «كان نتانياهو يريد نتائج فورية مثلما هو الأمر في ألعاب الفيديو أو في أفلام المغامرات القديمة التي يعشقها».
وكان الهدف الأول الذي حدده الموساد هو خالد مشعل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس والذي كان عملاء الموساد في العاصمة الأردنية عمّان قد حددوا وجوده منذ فترة. قال نتانياهو على الفور: هيا ابعثوا إلى عمّان «من يصفّي حسابه«. ذلك دون أن يأبه أبدا لما يمكن لمثل تلك العملية أن تجلبه من تدهور في العلاقات مع الأردن بعد أن كان سابقه «رابين» قد نجح في إقامتها مع الملك حسين. هذا بالإضافة إلى ما قد يحرم إسرائيل من معلومات مهمة حول سوريا والعراق.
جرى سرّا تحضير فريق كوماندوز من ثمانية عملاء للموساد. كانت المهمة محددة لكل منهم بحيث يعود الجميع بعد تنفيذ الاغتيال عبر جسر «اللنبي» بالقرب من القدس. وكان السلاح المستخدم غير اعتيادي، أي ليس مسدسا كاتما للصوت، وإنما كان غازا ساما. كانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل ذلك السلاح من قبل الموساد، حيث كان علماء روس هاجروا إلى إسرائيل وراء تصنيعه.
وفي 24 سبتمبر 1997 وصل أعضاء فريق الدعم إلى عمان من أثينا وروما وباريس حيث كانوا قد أمضوا عدة أيام واستلموا جوازات سفر كمواطنين في تلك البلدان، بينما كان القاتلان المكلّفان بتنفيذ خطة الاغتيال يحملان جوازات سفر كندية ، وكانا قد شرحا للعاملين في فندق «انتركونتيننتال» أنهما قد جاءا بقصد السياحة، أما أعضاء فريق الدعم فقد نزلوا في السفارة الإسرائيلية غير البعيدة.
في اليوم التالي قام القاتلان باستئجار سيارتين بواسطة موظفي الاستقبال في الفندق بزعم أنما سيقومان برحلة إلى جنوب البلاد. كان ذلك عند الساعة التاسعة، وعند الساعة العاشرة كان خالد مشعل في طريقه إلى مكتبه. كان يركب قرب سائقه بينما كان ثلاثة من أطفاله يجلسون في المقعد الخلفي. وعندما وصلت السيارة إلى منطقة الحدائق أنذر السائق خالد مشعل بأنهم ملاحقون. قام مشعل فورا بالاتصال مع الشرطة وأعطاهم رقم سيارة عميلي الموساد. لكن رجال الشرطة أخبروه بعد دقائق أن السيارة المعنية مستأجرة من قبل «سائح كندي».
قام خالد مشعل بتقبيل أطفاله الثلاثة قبل النزول من السيارة أمام مكتبه كي يتابعوا هم طريقهم إلى المدرسة برفقة السائق. كان القاتلان ينتظران مع حشد أمام مكتب حماس في شارع وصفي التل. تقدم أحدهما نحو مشعل ورشّ الغاز القاتل في وجهه. ثم هرب مباشرة باتجاه السيارة التي كانت تنتظر. لكنهما لم يستطيعا الفرار إذ انطلقت عدة سيارات وراء سيارة القاتلين، وأخبر أحدهم الشرطة كي تغلق طرق الحي.
حاولت سيارة ثانية تابعة لفريق الدعم الإسرائيلي التدخل وتهريب القاتلين، لكن إحدى السيارات اعترضت طريقها وأحاط رجال مسلحون فجأة بعملاء الموساد وأرغموا القاتلين على الانبطاح أرضا. وصلت الشرطة في الحال أيضا بينما نقلت سيارة إسعاف خالد مشعل إلى أحد المستشفيات. اقتيد القاتلان إلى مركز الشرطة حيث أبرزا جوازي سفريهما الكنديين وأكّدا أنهما ضحية «مؤامرة كبيرة». لكن رئيس جهاز مكافحة الجاسوسية الأردني وضع حدا ل«مهزلتهما» وأخبرهما أنه يعرف من هما.
وقد صرّح فيما بعد قائلا إن المسؤول المحلّي للموساد «أفرغ ما في جعبته واعترف أن الرجلين تابعين له وأن إسرائيل سوف تفاوض مباشرة مع الملك حسين». وينقل المؤلف عن أحد عملاء الموساد قوله عن اتصال هاتفي جرى بين الملك الأردني ونتانياهو: «لم يطرح الملك حسين على نتانياهو سوى سؤالين. بماذا يلعب؟ وهل يمتلك دواء ناجعا ضد الغاز السام المستخدم»؟. أراد نتانياهو أن ينكر في البداية كل شيء، لكنه لم يكن يعرف أن عميليه قد اعترفا بكل شيء أمام عدسة الكاميرا وأن شريطا مسجلا كان بطريقه إلى واشنطن».
سقوط الرواية الرسمية
إثر الفشل الذريع الذي عرفته تلك العملية استقال «داني ياتوم» مدير جهاز الموساد من منصبه في شهر فبراير من عام 1998، ولم يبعث له بنيامين نتانياهو الرسالة التقليدية التي تعوّد رؤساء الوزراء الإسرائيليون إرسالها إلى مدريري الموساد عند مغادرتهم الوظيفة من أجل «شكرهم على الخدمات التي قدّموها».
وكانت مواقع «ياتوم» قد اهتزت منذ اغتيال إسحق رابين، خاصة بعد أن قام الصحافي «باري شاميش» بتحقيق شخصي اعتمد فيه على تقارير طبية وعلى شهادات العديد من الحرّاس الشخصيين لرابين؛ ثم نشر في عام 1999 نتائج تحقيقه على شبكة الانترنت. وكانت تلك النتائج تشابه إلى حد كبير ما كان قد تمّ التوصل إليه من نتائج بعد مقتل الرئيس الأميركي جون كنيدي عام 1963.
وجاء في نتائج تحقيق شاميش قوله: «إن نظرية القاتل المعزول التي قبلت بها اللجنة الحكومية حول اغتيال رابين تخفي ما ربما كان محاولة اغتيال فاشلة ترمي إلى إنعاش الشعبية المترنحة لإسحاق رابين لدى الناخبين. لقد قبل إيغال أمير أن يلعب دور القاتل تنفيذا لتعليمات مسؤوله في الأجهزة السرية الإسرائيلية».
وأضاف: «لقد أطلق أمير رصاصة خلّبية لا تقتل. وقد أطلق رصاصة واحدة وليس ثلاث رصاصات كما أُعلن. وأظهر فحص مختبرات الشرطة على غلاف الرصاصة الذي وجدوه في مكان وقوع الجريمة أنه لا يتناسب مع صفات السلاح الذي استخدمه أمير. ولم يكن هناك من شاهد رابين وهو ينزف دما .
وسرّ آخر هو: كيف أضاعت السيارة التي أقلّت رابين إلى المستشفى ما بين ثمانية إلى اثنتي عشر دقيقة بينما كان يُفترض ألا يستغرق نقله سوى 45 ثانية عبر الشوارع المقفرة حيث كانت الشرطة قد منعت السير من أجل الاجتماع الشعبي لنصرة السلام الذي كان رابين يشارك به؟».
لكن يبقى السر الأكثر خطورة فيما قال به شاميش هو التالي: «خلال ذلك المسار الغريب الذي سلكه سائق مدرّب إلى المستشفى أُصيب رابين برصاصتين حقيقيتين انطلقتا من مسدس حارسه الشخصي يورام روبين. هذا السلاح اختفى في المستشفى ولم يعثر له على أثر بعد ذلك. وظلّت الرصاصتان اللتان تمّ استخراجهما من جسد إسحاق رابين مفقودتين مدة إحدى عشرة ساعة. ثم انتحر حارسه روبين بعد ذلك«.
لم تكن النتائج التي توصل لها شاميش هي وحدها التي ألقت الشكوك حول الرواية الرسمية لمقتل رابين؛ بل إن شهادات «تحت القسم» أكّدت «أن شيئا ما خطيرا قد حدث وله مواصفات المؤامرة». أما أمير نفسه فقد قال للمحكمة أثناء قراءة قرار الاتهام: «إذا قلت الحقيقة، فإن النظام كله سينهار، ولدي ما يكفي كي أبيد هذه البلاد».
ما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو أن شاميش ليس «مأخوذا بفكرة المؤامرات« بل إنه متعقل عامة فيما يكتب.
هكذا ألقى الموساد شباكه على فانونو في روما
* الحلقة الخامسة :
لا تزال العديد من علامات الاستفهام تدور حول قصة التقني النووي الإسرائيلي مردخاي فانونو وكشفه إنتاج إسرائيل للقنابل النووية، قبل اختطافه من أوروبا وإيداعه السجون الإسرائيلية، والغموض نفسه سيلف مصير روبرت ماكسويل الذي لقي مصرعه في عرض البحر، لكن غموضاً أشد سيفرض نفسه عندما يتعلق الأمر بمحاولة الموساد مد الجسور إلى مدينة الفاتيكان.
ردخاي فانونو هو يهودي مغربي من مواليد 13 أكتوبر 1954 في مراكش، حيث كان أهله يملكون متجراً صغيراً. هاجرت أسرته إلى إسرائيل عام 1963 وأقامت في بئر السبع بالنقب، أمضى خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ووصل إلى رتبة رقيب في صفوف وحدة لنزع الألغام كانت منتشرة في هضبة الجولان.
في صيف عام 1986، بعد تسريحه من الجيش وفشله في دراسة الفيزياء بالجامعة، تم قبوله كموظف في مفاعل ديمونة. ثم جرى تسريحه من هذا العمل، حيث حمل ملفه الأمني العبارة التالية:
«له أفكار موالية للعرب وفوضوية». غادر إسرائيل إلى أستراليا عام 1986 وهو يحمل حقيبة سفر على ظهره، ووصل إلى سيدني في صيف العام التالي. وأجمعت التقارير التي وصلت عنه لمدير الموساد، ادموني، أنه لم يقم أية صداقات أثناء وجوده في ديمونة وكان يمضي وقته منعزلا في منزله وهو يقرأ كتب السياسة والفلسفة. أشار علماء النفس في جهاز الموساد إلى أن مثل هذه الشخص يمكن أن يكون خطيراً أو متهوراً.
تعرّف فانونو في سيدني على الصحافي الكولومبي أوسكار جيريريو الذي أكد لأصحابه أنه يعرف عالماً نووياً إسرائيلياً هو بصدد أن يكشف للعالم بالتفاصيل الخطط النووية الإسرائيلية الإستراتيجية، وأنه بالتالي يحضر «سبق القرن الصحافي». لم تعجب تلك التصريحات الملتهبة فانونو الذي كان مؤيدا حقيقيا للسلام ويتمنى نشر قصته في صحيفة جدّية من أجل إنذار العالم حيال التهديد الذي تمثله إسرائيل.
لكن كان جيريرو قد سبق واتصل بمجلة «صانداي تايمز» اللندنية الأسبوعية التي أوفدت أحد صحافييها إلى سيدني من أجل إجراء مقابلة مع فانونو. وقد أصرّ هذا الصحافي على اصطحاب الإسرائيلي إلى لندن من أجل مواجهة أقواله مع آراء أحد كبار الاختصاصيين النوويين في بريطانيا.
كان فانونو يمتلك في الواقع ستين صورة مأخوذة داخل مختبر ماخون-2 في مفاعل الديمونة بالإضافة إلى مخططات ورسوم ومذكرات، أي ما يكشف على أن إسرائيل قد أصبحت قوة نووية حقيقية.
حاول جيرورو بعد أيام من سفر فانونو إلى لندن نشر صور بعض الوثائق التي كان قد حصل عليها وصورها، لكن الصحف الأسترالية رفضت بحجة أنها وثائق مزوّرة. فسافر الصحافي الكولومبي مقتفيا آثار فانونو في لندن، وقدّم ما لديه من صور لصحيفة «صاندي ميرور» مرفقة بصورة لفانونو كان قد التقطها له في أستراليا.
بعد ساعات فقط استطاع نيكولا ديفيس، رئيس التحرير، العثور على فانونو والصحافي في مجلة «صانداي تايمز» برفقته. قام بإخطار ماكسويل، صاحب إمبراطورية الصحافة البريطانية، الذي اتصل بدوره هاتفيا في الحال برئيس الموساد «ادموني».
ألغام نووية للجولان
أخدت صحيفة «الصنداي تايمز» قصة فانونو على محمل الجد، وبدأ الإسرائيليون يفكرون بالرد، وأوفد الموساد إلى لندن أحد الذين تعوّد الاعتماد عليهم في الأزمات الصعبة المدعو آري بن ميناش، الذي روى فيما بعد للصحافي الأميركي سيمور هيرش ما يلي:
«نجح نيكولا ديفيس بإقناع جيريرو بلقاء صحافي أميركي - بن ميناش - وعرض الصحافي الكولومبي أثناء اللقاء عدة صور كان فانونو قد التقطها. كان لا بد من أن يقوم الخبراء الإسرائيليون بتفحصها. فشرحت له أنني بحاجة لنسخة عنها لمعرفة قيمتها قبل الدفع».
أرسلت النسخ المسلّمة فورا إلى إسرائيل حيث أكد عدد من الرسميين العاملين في مفاعل الديمونة أنها تخص فعلا مختبر ماخون-2. وكانت إحدى الصور تبيّن القاعة التي جرى فيها تصنيع الألغام النووية التي كان يفترض وضعها في الجولان على الحدود السورية. وبالتالي لم يكن هناك أي مجال للتشكيك بمصداقية فانونو، ويكفي لأي فيزيائي نووي أن يحدد بلحظة عين عمل منشأة من هذا الطراز.
استدعى شيمون بيريز، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، كبار المسؤولين في الحكومة والموساد لمعالجة الأزمة. كان المطلوب أولا معرفة كيف حصل فانونو على الصور وهل كان وحده أم مع آخرين. وفي لندن فهمت «الصنداي تايمز» أن إسرائيل مستعدة لفعل أي شيء من أجل نزع مصداقية فانونو، ولذلك واجهته مع الدكتور فرانك بارنابي، الخبير النووي فوق الشبهات، الذي أكّد صحة صور ووثائق التقني الإسرائيلي.
التقى بن ميناش من جديد مع ماكسويل الذي قال له بوضوح إنه يعرف ما ينبغي عمله وأنه قد تحدث مع مدير الموساد. وفي اليوم التالي نشرت في «الصنداي ميرور» صورة كبيرة لمردخاي فانونو مرفقة بمقال أثار جنون فانونو والصحافي الكولومبي - الذي وصفه المقال أنه كذّاب ومحتال- ووصف اتهاماتهما أنها مجرد هراء مبتذل، كان ماكسويل هو الذي أملى المقال وأشرف على مكان نشر صورة فانونو. كانت حملة التضليل الإعلامي قد انطلقت.
بعد نشر المقال تمت تعبئة جميع المتعاونين مع الموساد في لندن للبحث عن مكان فانونو. وتلقى العشرات من المتطوعين اليهود قوائم الفنادق المطلوب الاتصال بها.
وفي كل مرة كان المتحدّث يطلب من العاملين في الفندق إذا كان بين النزلاء أحد بمواصفات فانونو - كما نشرتها المجلة البريطانية- لأنه من أقاربه ويرغب اللقاء به. وبتاريخ 25 سبتمبر وصل إلى علم ادموني أنه قد جرى تحديد مكان تواجده. وبالتالي ينبغي الانتقال إلى المرحلة التالية.
أقدم مهنتين
من المعروف أن العلاقة بين التجسس والجنس قديمة قدم الجاسوسية نفسها، إنهما أقدم مهنتين في التاريخ. وجهاز الموساد يعرف جيدا استخدام الجنس كطعم، وهذا ما عبّر عنه مائير أميت بالقول: «إنه سلاح فعّال. فالمرأة تملك مواصفات لا يمتلكها الرجل. إنها تعرف كيف تستمع. والأسرار تصل إلى أذنيها بشكل طبيعي.
ثم إن تاريخ الاستخبارات الحديثة زاخر بقصص النساء اللواتي استخدمن سحرهن من أجل خدمة بلادهن.. لكن نساءنا شجاعات ويعرفن مخاطر ذلك. وهذا العمل يتطلب شجاعة خاصة، إذ ليس المقصود هو مضاجعة رجل وإنما أن يُدخل في روعه استعداد المرأة لفعل ذلك إذا قدّم لها بعض الأسرار».
اختار ناحوم ادموني كطعم يجذب فانونو شيريل بن توف ابنة أسرة يهودية غنية في أورلاندو بفلوريدا. كان أبواها قد طلّقا فمالت هي إلى التدين وقدمت إلى إسرائيل حيث تزوجت من أوفر بن توف الذي يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ويوم العرس تحدث معها أحد ضباط الموساد عن المستقبل وانتهت عميلة له.
كان قد تمّ تحديد مكان وجود فانونو وكان عليها أن تجذبه إلى خارج بريطانيا. لقد قدّمت نفسها له كسائحة أميركية تقوم برحلة في أوروبا بعد قصة طلاق مؤلمة. ووصفت قصة طلاق والدتها ووالدها على أنها قصتها الشخصية ثم أضافت أن لها أختا في روما، كما زعمت. كان الهدف النهائي لمهمتها هو أن تجذب فانونو إلى العاصمة الإيطالية.
وفي 23 سبتمبر 1986 انضمت إلى فريق من تسعة عملاء كانوا يعملون في لندن تحت أمرة مدير عمليات الموساد بيني زيفي. حذّر صحافيو «الصنداي تايمز» فانونو من أن اللقاء مع الأميركية الجميلة يبدو صدفة مدروسة وليس عفوية.
كان قلبه قد مال لها ولم يعد يسمع صوت العقل، إذ أصرّ على الاتفاق معها على لقاء بعيد عن الأنظار في روما وفي منزل «أختها».
وصل «بيني زيفي» وأربعة آخرون من عملاء الموساد على نفس الرحلة من لندن إلى روما برفقة شيريل وفانونو. استقل الاثنان سيارة أجرة للذهاب إلى شقة في روما حيث كان ينتظرهم ثلاثة من عملاء الموساد. لقد قيدوا فانونو وزرقوه بمادة مشلّة. وصلت في الليل سيارة إسعاف لنقل «المريض» واخترقت روما باتجاه الجنوب حيث كان طراد ينتظر فانونو كي ينقله إلى حيفا.
بقي فانونو إحدى عشرة سنة في زنزانة منفردة حتى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. كانت ظروف اعتقاله شديدة الصعوبة، لكن إسرائيل خففت منها عام 1998 أمام ضغط دولي قوي ودافعت عنه منظمة العفو الدولية واسهبت الصاندي تايمز بالحديث عن وضعه المؤلم خاصة أنه لم يتقاض منها أي مبلغ مقابل السبق الصحافي الذي سلمه لها.
الخلاص من ماكسويل
في لندن هدد روبرت ماكسويل، كما فعل غالبا في الماضي، بأنه سيقدم شكوى قضائية ضد كل من يتجرأ ويعيد ما كتبه الصحافي بن ميناش من أقوال ضده. ولم يتجرأ أي ناشر بريطاني أن يتحدى صاحب إمبراطورية الصحافة ولم تمتلك أية صحيفة شجاعة أن تطلب من صحافييها استقراء الاتهامات الموجودة في الكتاب.
كان ماكسويل، مثل بن ميناش سابقا، على اقتناع بأنه محمي لسبب بسيط أنه كان «يطير» لحساب الموساد. ولم يكن يتردد في تكرار القول أنه كان هو أيضا يعرف «مكان وجود الجثث»، وكان جهاز الموساد يدرك تماما ماذا يريد قوله.
ما يؤكده المؤلف هو أن روبرت ماكسويل، الذي كان قد صرف من الخدمة أحد الصحافيين العاملين معه لأنه بالغ قليلا في فاتورة مصاريفه، كان هو نفسه يختلس سراً أموال هؤلاء العاملين كي يساعد أصدقاءه في الموساد.
وكان هو شخصيا الذي ينظم عملية السرقة تلك عبر مجموعة من عمليات التزوير المالية وعبر المرور بعدة بنوك وصولا إلى حساب خاص للموساد في بنك إسرائيل بتل أبيب. لذلك كان يتم الاحتفاء بماكسويل في إسرائيل وكأنه رئيس دولة.
لكن الموساد، وعلى قاعدة معرفته بالشهية الجنسية لدى «إمبراطور» الصحافة البريطانية، كان يقدم له في كل مرة عاهرة مدفوعة الأجر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مع الاحتفاظ بأشرطة فيديو ل«الابتزاز» إذا دعت الضرورة.
وكان عميل الموساد السابق ما بين 1984 و1986 فكتور أوستروفسكي، اليهودي المولود في كندا، قد كشف حقيقة أن «الموساد قد موّل العديد من العمليات في أوروبا من الأموال التي اختلسها ماكسويل من مرتبات موظفيه».
وما أكّده اوستروفسكي، وآخرون، هو أن الموساد رأى بعد سنوات من الخدمات والأموال التي قدمها روبير ماكسويل له ولإسرائيل انه قد أصبح خارج إطار السيطرة بل و«خطير».
وذلك في الوقت الذي كانت مصلحة الضرائب قد بدأت بتحقيقات حول سلوكه المالي مع موظفيه، كما كان البرلمان ووسائل الإعلام قد اعتبروا أن هناك علامات استفهام حول ثروته.
وأدّى هذا كله إلى تعرضه لأزمة مالية حقيقية فطالب الموساد بأن يعيد له مبالغ كان قد «أقرضها» له وإلا فقد يكشف عن اللقاء الذي جرى في يخته ببحر الأدرياتيكي بين رئيس الموساد «ادموني» وفلاديمير كريشكوف، الرئيس السابق لجهاز كي.جي.بي السوفييتي لحبك مؤامرة ضد غورباتشوف.
وكان الموساد قد وعده باستخدام نفوذه لدى الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية للاعتراف ب«النظام الجديد» في روسيا في حالة نجاح الانقلاب - الذي فشل- وبالمقابل وعد كريشكوف بتسهيل هجرة جميع اليهود في الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل.
في تلك اللحظة، وكما يؤكد أوستروفسكي «اجتمع الجناح اليميني في الموساد في إطار لجنة مصغّرة وقرر الخلاص من ماكسويل». وإذا كان هذا التأكيد دقيقا - لم تكذبه إسرائيل أبدا بشكل قاطع- فإنه لا يبدو من المعقول أن تتصرف تلك «اللجنة المصغّرة» من دون موافقة أعلى المستويات، بل ربما الموافقة الشخصية لرئيس الوزراء آنذاك إسحق شامير.
وزاد من تعقيد الأمر نشر كتاب في ذلك السياق للصحافي الأميركي سيمور هيرش عن «إسرائيل وأميركا القنبلة»، والذي تعرض لموضوع دخول إسرائيل إلى نادي القوى النووية. وقد قدّم هيرش العديد من البراهين على وجود روابط جديدة بين ماكسويل والموساد وخاصة الطريقة التي غطت فيها مجموعة «الميرور» قضية فانونو.
ويؤكد اوستروفسكي أن خطة الموساد للخلاص من ماكسويل كانت تتعلق بقدرته على جذبه بعيدا عن بريطانيا حيث يمكن لعملاء الموساد أن يضربوا ضربتهم.
وبتاريخ 29 أكتوبر 1991 تلقى ماكسويل اتصالا هاتفيا من عميل للموساد في السفارة الإسرائيلية بمدريد يدعوه فيها للقدوم إلى إسبانيا في اليوم التالي ووعده بإيجاد تسوية. وطلب منه التوجه إلى جبل طارق ثم يأخذ يخته ويأمر قبطانه بالتوجه نحو جزر الكاناري و«ينتظر رسالة».
وقد اقترف ماكسويل خطأ قبول الدعوة.
وفي 30 أكتوبر وصل أربعة إسرائيليين إلى مرفأ الرباط في المغرب وقدّموا أنفسهم كسائحين من هواة الصيد البحري. هكذا استأجروا مركبا لمواجهة أمواج الأطلسي واتجهوا صوب جزر الكاناري.
وفي 31 أكتوبر، بعد رسو اليخت في مرفأ سانتا كروز، تناول «إمبراطور» الصحافة البريطانية طعام العشاء وحيدا في فندق «مينسي». وعندما انتهى اقترب منه رجل لفترة قصيرة، لم تُعرف هويته ولا ما قال له. لكن ماكسويل عاد مباشرة إلى اليخت وطلب من قبطانه أن يرفع المرساة. وبقي المركب في البحر طيلة ستة وثلاثين ساعة بعيدا عن الشاطئ.
كتبت مجلة «بزنس ايج» البريطانية تحت عنوان «كيف ولماذا اغتيل روبير ماكسويل» إن قاتلين قد صعدا إلى اليخت بعد أن وصلا إليه بواسطة قارب مطاطي بمحرك. ووجدا ماكسويل على ظهر اليخت فقيّداه و«وحقنه أحدهما بفقاعة هواء مات بعدها خلال عدة ثوان فقط». وحددت المجلة القول إن جثته قد ألقيت بعد ذلك في البحر ولم يتم اكتشافها إلا بعد إحدى عشرة ساعة مما أخفى آثار الحقن.
جسور إلى الفاتيكان
إن مؤلف هذا الكتاب يتوقف طويلا عند علاقة الموساد بالفاتيكان، ويؤكد بداية أن جميع رؤساء وزراء إسرائيل أبدوا إعجابهم الكبير بمفهوم البابوية، وذلك على اعتبار أن البابا يمثل سلطة روحانية وسياسية لا تقدم حسابا لأحد وليست خاضعة لمساءلة أية سلطة قضائية أو تشريعية. ثم إن الفاتيكان هو عالم محاط بالسرية التي تحكم آليات عملها من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا.
وكان رؤساء الموساد جميعهم قد تساءلوا عن كيفية التمكن من رفع الغطاء عن هذا العالم «المجهول»، لكن جميع المحاولات التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية والأجهزة السرية لإقامة علاقات جيدة مع الفاتيكان باءت بالفشل.
وبقيت السياسة الخارجية للحبر الأعظم تتحدث عن «الأراضي المحتلة» في الضفة الغربية وقطاع غزّة وعن هضبة الجولان باعتبارها أرضاً سورية ضمّتها إسرائيل. وكان الكرادلة والقساوسة يتحفظون في تصريحاتهم حول هذا الموضوع على خلفية اعتقادهم أن إسرائيل قد نشرت جواسيسها في كل مكان من أجل رصد حركاتهم وسكناتهم.
لكن الأمر تغيّر بعد وصول يوحنا بولس الثاني إلى منصب البابوية عام 1978 وأصبحت لإسرائيل مكانة دبلوماسية حقيقية في الفاتيكان. وكان سابقه بولس السادس قد استقبل غولدا مائير عام 1973 دون أن يؤدي ذلك إلى تغير جوهري في سياسة الفاتيكان التي استمرت بالمطالبة في قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفي ظل رئاسة رونالد ريغان للولايات المتحدة الأميركية تعززت كثيرا العلاقات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والبابا يوحنا بولس الثاني وتكررت زيارات «وليم كيسي» رئيس الوكالة آنذاك، إلى الفاتيكان. وقد عبّر ريتشارد آلن الكاثوليكي والمستشار الأول للأمن القومي لدى رونالد ريغان عن قوة تلك العلاقة بالقول:
«ترمز العلاقات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والبابا إلى أحد أروع التحالفات في جميع الأزمنة. وكان ريغان على اقتناع كبير بأنهما، هو والبابا، سيغيران وجه العالم». وفي الوقت نفسه لم تنس وكالة الاستخبارات المركزية أن تضع أجهزة للالتقاط والتنصت في مكاتب كرادلة وقساوسة أميركا الوسطى المؤيدين لما سمي ب«لاهوت التحرير».
طلب ناحوم ادموني، مدير الموساد، من صديقه الكسندر هيغ، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، تزويده بنسخة عن الدراسة النفسية التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للبابا يوحنا بولس الثاني.
لقد ركزت الصورة (النفسية) المرسومة له على أنه ورع جدا دينيا لكنه شديد الغضب أحيانا ويمكن أن يفقد برودة أعصابه، ويتحلّى بحس جيوسياسي كبير وقد يحصل ويكون متشددا مثل أي دكتاتور. وينتهي التقرير الأميركي إلى القول أن يوحنا بولس الثاني «ضليع جدا في ميدان السياسة ويرغب في لعب دور على الصعيد العالمي».
توصل ادموني وقيادة الموساد إلى الاقتناع بأن الاستخبارات الأميركية قد أقنعت البابا بأن محاولة اغتياله من قبل التركي محمد علي أقجا بتاريخ 13 مايو 1981 كان من تدبير السوفييت. فقرر الإسرائيليون لعب ورقة «فرّق تسد» وذلك عبر تقديم رواية أخرى لمحاولة اغتيال البابا وأن إيران كانت وراءها».
جوازات السفر المفقودة
لكن تبقى أوروبا إحدى ساحات النشاط الرئيسي لعملاء الموساد إلى جانب الولايات المتحدة. وذات يوم من أيام يوليو 1986 عثروا على كيس بلاستيكي في إحدى مقصورات الهاتف بشارع في مدينة بون الألمانية.
لحظته دورية للشرطة فوقفت لمعرفة ما فيه. لقد وجدت ثمانية جوازات سفر بريطانية غير مستخدمة جرى تسليمها للسفارة البريطانية. حامت الشكوك حول الفلسطينيين والجيش الجمهوري الإيرلندي لكن جهاز مكافحة الجاسوسية البريطاني ركّز شكوكه على جهاز واحد يمكنه أن يصنع بمثل تلك الدقة جوازات السفر التي تبيّن أنها مزورة، وهو جهاز الموساد.
نفى ناحوم ادموني ذلك وأشار إلى إمكانية أن تكون الأجهزة السرية الألمانية الشرقية - ستازي- قد شرعت ببيع جوازات سفر مزوّرة لليهود الراغبين في السفر إلى إسرائيل، مع ذلك «كان ادموني يعرف جيدا أن تلك الجوازات كانت من صنع مزوري الموساد وأنه كان مفترض منحها لعملائه من أجل تسهيل دخولهم وخروجهم من بريطانيا».
وذلك رغم «التفاهم» الذي كان قد تمّ الوصول إليه بين الموساد والاستخبارات الخارجية البريطانية ونصّ على إطلاع البريطانيين على كل العمليات الإسرائيلية في بريطانيا.
ولم يتردد الموساد في إدخال بعض عملائه سرا إلى لندن في أفق القيام بعمليات اغتيال للفلسطينيين وكبح الجهود التي كان ياسر عرفات يقوم بها من أجل ربط صلات مع حكومة مرجريت تاتشر التي كانت «بدأت بالاقتناع شيئا فشيئا أن الرجل كان قادرا على المساهمة في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يعترف بنفس الوقت بالحق المشروع للشعب الفلسطيني بأرضه وبحق الأمن بالنسبة لإسرائيل».
رأى شيمون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أن قضية جوازات السفر المزورة تلك قد تخرّب العلاقات مع حكومة تاتشر وقال إنه من الأفضل لعب ورقة الصراحة إذ «بمقدار ما يتم الاعتراف مبكرا بالخطأ يمكن تسوية الأمور بسرعة».
رفض ادموني الفكرة، ذلك أنها ستقود جهاز مكافحة الجاسوسية وسكوتلانديارد إلى التحقيق حول نشاطات الموساد في بريطانيا. وقد يؤدي ذلك إلى الكشف عن عميل سري كان يرى به الموساد «منجما للمعلومات». هذا فضلا عن الاعتراف أن الموساد مؤهل للقيام بمثل تلك الأعمال المشبوهة.
كانت تلك الجوازات مرسلة للسفارة الإسرائيلية في بون وكان يحملها عميل مبتدئ ولا يعرف العاصمة الألمانية جيدا. بعد الدوران كثيرا في الشارع دخل إلى المقصورة الهاتفية لإخطار السفارة الإسرائيلية أنه قد ضلّ العنوان تماما، ونسي هناك الجوازات. كلّفت تلك القضية ناحوم ادموني منصبه إلى جانب قضية الجاسوس اليهودي الأميركي جوناثان بولارد خلفه في إدارة الموساد «شابتاي شافيت» وورث عنه عواقب الفشل.
لم تشهد فترة «شافيت» على رأس الموساد الكثير من «الإنجازات» وذات يوم من ربيع عام 1996 استدعاه بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء آنذاك، إلى مكتبه وقال له باختصار إنه «معزول»، وعندما سأله من سيخلفه؟ أجاب: داني ياتوم.
كان ياتوم هذا صديقا حميما لبنيامين نتانياهو منذ فترة طويلة لكن علاقتهما تدهورت عندما فشلت محاولة اغتيال أحد قادة حماس الرئيسيين، أي خالد مشعل.
وزادت العلاقة سوءاً بعدما تكشّف في عام 1997 أن أحد ضباط الموساد الكبار «يهودا جيل» الذي كان يعمل في الجهاز منذ 20 سنة قد «اخترع» تقريرا مختلقا من ألفه إلى يائه بالاعتماد على جاسوس «وهمي» موجود في دمشق حول استعداد سورية للهجوم على إسرائيل، وحيث تقاضى ذلك الضابط أموالا طائلة من «الصندوق الأسود» للموساد بناء على وظيفة وتقرير مزورين.
لكن بالمقابل وجّه الموساد نشاطاته صوب إفريقيا، حيث قدّم معلومات للمتمردين في زائير بقيادة لوران ديزيري كابيلا لقلب نظام موبوتو، وعزز علاقاته مع الأجهزة السرية في جنوب إفريقيا، وفي أميركا نجح بإيصال أحد عملائه إلى أعلى دوائر إدارة كلنتون.
كما كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. لكن هذا كله لم يمنع من عزل داني ياتوم من إدارة الموساد ليخلفه «افراييم هاليفي» يوم 5 مارس 1998. وتحول ياتوم مباشرة للعمل في ميدان صناعة السلاح الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه الذي عيّن فيه نتانياهو افراييم هاليفي مديرا للموساد أصدر قرارا آخر هو ان نائبه اميرام لوفين سيخلفه في 3 مارس 2000. كانت تلك هي المرّة الأولى في تاريخ الموساد التي يتم فيها تعيين مدير لمدة محددة كي يخلفه بعد ذلك نائبه.
داجان لمساعديه: اقتلوا بكل الوسائل وفي جميع الاتجاهات
• الحلقة السادسة و«الأخيرة» :
مع ختام هذا الكتاب يضع مؤلفه يدنا على ثلاثة موضوعات رئيسية أولها استمرار جهود التجسس الإسرائيلية على أميركا بعد سقوط الجاسوس جوناثان بولارد، وثانيها مؤشرات تورط الموساد في مصرع الأميرة ديانا.
وثالثها وأكثرها أهمية دور الموساد في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده ليصل في الختام إلى طرح مجموعة بالغة الاهمية من علامات الاستفهام التي لا تزال تنتظر الإجابة عنها واجه العالم وجميع الأجهزة السرية واقعا جديدا بعد أكبر عملية تفجيرات يوم 11 سبتمبر 2001.
يقول مؤلف هذا الكتاب إنه على الرغم من الأطنان من المقالات والكم الكبير من الكتب المكرّسة لهذا الحدث في جميع أنحاء المعمورة يبقى هناك سؤال لا يزال من دون إجابة وهو: «ماذا كان يعرف الموساد قبل الأحداث التي أدت إلى تدمير برجي التجارة الدولية في واشنطن وانهيار البنتاغون جزئيا؟».
ويضيف: «إن بعض الضباط الكبار الذين كانوا يعملون في قسم العمليات بقيادة الموساد كانوا قادرين على الإجابة بعد مرور عام». ويشير المؤلف أنه قبل ثلاث سنوات من تفجيرات 11 سبتمبر 2001 أعدّت لجنة بقيادة نائب الرئيس الأميركي آنذاك آل غور تقريرا طالبت فيه بزيادة سريعة في الميزانية المكرّسة لأمن المطارات.
ويؤكد في هذا السياق أن جهاز الموساد قدّم العديد من المعلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والجهات الحكومية الأميركية لكن جرى إهمالها من قبل إدارة بيل كلنتون وخلفه جورج دبليو بوش.
أُثيرت أسئلة كثيرة بعد 11 سبتمبر حول أسباب قلّة عدد جواسيس الاستخبارات الأميركية في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط؟ ولماذا التركيز فقط على الرقابة الإلكترونية؟
ومن المعروف أن وكالة الأمن القومي الأميركي هي أقوى جهاز للتجسس في العالم، إذ أنها تستطيع انطلاقا من مقرها الرئيسي في ولاية ماريلاند التجسس على جميع المكالمات الهاتفية في العالم بواسطة أجهزة الكترونية متقدمة جدا.
وحواسيبها الضخمة تسجل أسماء المشبوهين والكلمات الحساسة وأرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية في العالم. ويتم بعد ذلك تحضير «قوائم مراقبة» مشفّرة يتم إرسالها عبر خطوط هاتفية محميّة إلى جميع هيئات الاستخبارات الأميركية.
لا أحد يعرف بالدقة كلفة عملية المراقبة هذه، لكن الكل يجمع على أنها تتجاوز عدة مليارات من الدولارات كل سنة. وتتمثل نقطة الضعف الكبيرة لهذا النظام في عدم الإلمام الكامل بمختلف اللغات في العالم.
ولا يكفي في نهاية المطاف إعداد قوائم وإنما ينبغي أيضا معرفة حل ألغازها. والإنسان وحده قد يكون قادرا على فهم أي حديث داخل سياقه ويعرف أدق التفاصيل التي قد تخفي حتى على أكثر أنظمة الرقابة الإلكترونية تقدما.
مغامرات طلبة الفن
في 9 مايو 2001 اقترب شابان بسيارتهما من موقع حراسة زتولك فيلدس، إحدى القواعد الجوية التابعة للحرس الجوي الوطني الأميركي، والتي كانت تضم داخلها متحفا صغيرا للطيران. كان حشد كبير من الزائرين بأتي كل عام لزيارة هذا المتحف.
وعندما طلب الحرس من الشابين إبراز هويتهما الشخصية أخرجا جوازي سفر إسرائيليين. وقدّما نفسيهما على أنهما طالبان في دراسة الفنون بجامعة القدس. سُمح لهما بالدخول لكن ضُبطا وهما يصوران الطائرات وقالا عندما جرى توقيفهما أنهما كانا يجهلان أن التصوير كان ممنوعا.
أرسلت القيادة العسكرية للمنطقة تقريرا لوزارة الدفاع الأميركية التي أرسلته بدورها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كانت المفاجأة كبيرة عندما عُلم أن «طلابا» إسرائيليين يدرسون «الفن» قد قاموا بأعمال شبيهة في العديد من الولايات الأميركية الأخرى.
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من السفارة الأميركية في إسرائيل التحقق من حكاية «طلبة الفن» هؤلاء، وكانت الإجابة هي أن «جامعة القدس» غير موجودة أصلا، وأقرب هيئة علمية منها قد تكون الجامعة العبرية، ولكن أسماء «الطلبة» المعنيين ليست موجودة في قوائمها. واكتشف الأميركيون، بعد التحقيق، أن الهواتف النقالة التي كانت مع «الطلبة» اشتراها دبلوماسي إسرائيلي في واشنطن قبل أن يعود إلى تل أبيب.
اتصل جورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بأفراييم هاليفي، مدير الموساد مستوضحا، فأكد له الإسرائيلي أنه ليس هناك أية عمليات جارية آنذاك. «لقد كان يكذب».
كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب، إذ كانت تلك العملية من بنات أفكاره. وأن «طلبة الفنون» لم يكونوا سوى طلبة في السنة الأخيرة من مركز تدريب الموساد كان قد جرى اختيارهم للقيام بمهمات في الولايات المتحدة الأميركية. ولم تكن تلك هي المرّة الأولى التي يتم فيها إرسال طلبة للتدرب على مثل تلك المهمات.
جرت تسريبات للصحافة، وكانت المقالات الأولى بعيدة تماما عن الواقع إذ أجرى الحديث عن «طلبة في الفن قدموا من الشرق الأوسط» وأنهم «يتحدثون اللغة العربية»، بل وجرى التأكيد أنهم ينتمون إلى «منظمة إرهابية مجهولة». وكان صحافي التحقيقات المعروف كارل كاميرون هو أول من أشار إلى أن جهاز الموساد قد يكون وراء تلك العملية.
لقد تحدث هذا الصحافي عن ذلك عبر قناة فوكس نيوز الأميركية وجوبه مباشرة بحملة عنيفة من اللوبي اليهودي في واشنطن وعلى رأسه لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية ذات الباع الطويل لدى الكونجرس وفي أوساط الاستخبارات وحتى لدى البيت الأبيض.
وعندما أطلقوا الرشقة الأولى على كاميرون أكّد في مقال آخر أن العديد من الإسرائيليين قد أخفقوا عندما تعرضوا لجهاز الكشف عن الكذب عندما سئلوا عن احتمال مراقبة النشاطات الأميركية.
وكتبت صحيفة «لوموند» في باريس أن شبكة واسعة للتجسس الإسرائيلي جرى الكشف عنها في الولايات المتحدة، وهي أكبر عملية من هذا النوع منذ عام 1985 عندما ضُبط جوناثان بولارد وهو يبيع معلومات سرية للغاية إلى جهاز الموساد.
ضاعف اللوبي اليهودي في أميركا من شراسته. ووجه اليكس سافيان، أحد مدراء لجنة دقة المقالات حول الشرق الأوسط في أميركا، الموالية لإسرائيل، للصحافي كاميرون تهمة أن له مشكلة شخصية حيال إسرائيل. فهو ترعرع في الشرق الأوسط (...). ومن الممكن أن يكون متعاطفا مع العرب.
فأجاب كاميرون: لقد عشت وترعرعت في إيران خلال عدة سنوات ذلك أن أبي كان يعمل في حقل الآثار. فهل هذا يجعل مني مناهضا لإسرائيل؟. كانت في الواقع تلك هي المرّة الأولى التي يجد كاميرون نفسه متهما بالتحيّز في أحد تحقيقاته.
وجاء على لسان مايكل ليند، أحد أهم أعضاء المؤسسة الأميركية الجديدة - هي مختبر للأفكار- ورئيس التحرير السابق لصحيفة ناشيونال انتيرست قوله: عندما يتعلق الأمر بضباط متخصصين في الشؤون الخارجية أو بتطبيق القانون أو بمسائل عسكرية، يبدو أنه من المستحيل المساس بإسرائيل من دون التعرض للتشهير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل القول بالموالاة للعرب.
وأخيرا، عندما كان طلبة الفن في طائرة تابعة لشركة العال تقلهم في طريق العودة إلى تل أبيب، اختفى كل أثر للتحقيق الذي قام به كارل كاميرون من موقع الانترنت التابع لقناة فوكس نيوز الأميركية.
ووضع مكانه تنبيها يقول إن هذه القضية قد حظر الإطلاع عليها، وصرح ناطق رسمي باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لقد طوينا الصفحة حول هذا التحقيق. وبعد فترة قصيرة أقصى أفراييم هاليفي عن إدارة الموساد.
تحذير لأميرة القلوب
كان هاليفي قد ترك ذكرى أخرى مثيرة من فترة إدارته للموساد، إذ كان قد قرر إعادة دراسة ملف وفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد في باريس. وبعد قراءته للملف الأول للموساد حول الحادث طلب من موريس العميل الإسرائيلي الذي شارك في تجنيد هنري بول، سائق السيارة التي تعرّضت للحادث القاتل، تقديم محضر عن اليوم الأخير لديانا ودودي.
ويؤكد الذين قرأوا هذا المحضر الجديد أنه يحتوي على العديد من الأقوال الدقيقة الجديدة بالقياس إلى الملف الأصلي للموساد؛ مثل القول أن محمد الفايد، والد عماد - دودي- كان مسكونا باستمرار بفكرة أن ديانا كانت حاملاً وأن المخابرات الأميركية والبريطانية والفرنسية كانت تراقب الثنائي العاشق منذ وصولهما إلى باريس.
ويشير المحضر أيضا إلى عدة محادثات هاتفية تضمنت احداها إنذارا من الحارس الشخصي لديانا، العامل سابقا في سكوتلانديارد، يقول لها انتبهي. ويركز تقرير موريس الجديد كثيرا على سيارة الفيات اونو البيضاء التي كانت تقف بالقرب من فندق ريتز.
وقد أكّد عدد من المصوّرين الصحافيين بعد ذلك أنها كانت تعود لجيمس اندرسون الذي تخصص بالتقاط صور لديانا وكسب من ذلك ثروة كبيرة. لكن موريس يؤكد أن اندرسون لم يكن موجودا تلك الليلة.
ويتحدث موريس عن سيارة فيات اونو بيضاء لاحقت بجنون السيارة المرسيدس التي كان يستقلها دودي وديانا ويقودها بول هنري. وبعد فترة من الحادث عُثر على سيارة من الطراز نفسه في مرآب لتصليح السيارات في باريس وقد أُعيد دهنها منذ فترة وجيزة باللون الأزرق.
وعندما كشطوا الدهان اكتشفوا أن لونها في الأصل هو الأبيض. لكن لم يذهب رجال الشرطة بعيدا في التقصّي بهذا الاتجاه. فهل كانوا يظنّون أن الأمر لا يتعلق بالسيارة التي يبحثون عنها؟
في هذه الحالة، لماذا لم يذهبوا إلى مقبرة للسيارات المحطّمة كانت موجودة في إحدى ضواحي باريس حيث كانت توجد سيارة فيات اونو بيضاء اللون محطمة إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، كانت قد تعرّضت لحادث بعد عدة ساعات من الحادث القاتل لديانا ودودي تحت نفق ساحة آلما بباريس؟
وجاء في محضر موريس قوله حرفيا: بعد أقل من أربع ساعات من وقوع الحادث طار جيمس اندرسون فجأة إلى كورسيكا. لم يكن هناك أي سبب مهني يدفعه للقيام بذلك.
ولم تكن هناك أية شخصية شهيرة في الجزيرة آنذاك. وفي مايو عام 2000 وُجدت سيارة محروقة في غابة بالقرب من مدينة نانت، وكان السائق محروقا بداخلها. وأظهرت فحوص الحمض النووي أن الجثة هي جثة جيمس اندرسون.
فلماذا ذهب اندرسون إذن إلى كورسيكا؟ هل من أجل تلقي مبلغ مالي كبير مقابل إعارته سيارته الفيات اونو البيضاء لأحدهم؟ لكن لمن؟ ما يقوله محمد الفايد هو أن سيارة اندرسون قد أُعيرت واستخدمت من أجل إرغام هنري بول على فقدان سيطرته على السيارة المرسيدس.
لكن هناك الكثير من الأسئلة الأخرى، مثل لماذا الإهمال الكبير في تحقيق الشرطة حول موت اندرسون؟ ولماذا لم تحاول معرفة أسباب سفره إلى كورسيكا والتفتيش بدقة في حساباته المصرفية؟ بكل الحالات لم يتم التحقيق عمّا إذا كان قد وضع مبلغا كبيرا من المال في أحد حساباته بعد الحادث.
ربما أن هاليفي لن يقول أبدا ما لديه حول هذه القضية. كان قد وصل من دون ضجيج إلى رئاسة الموساد وغادره بالطريقة نفسها، ليحل محله مائير داجان الذي كان قد شارك في قمع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1991.
لقد اختاره أرييل شارون الذي ربطته به صداقة حميمة بعد مشاركتهما معا في عمليات القمع ضد الفلسطينيين في لبنان، ومنذ اللحظات الأولى لاستلامه منصبه الجديد كانت تعليماته لعملائه واضحة وهي: اقتلوا بكل الوسائل... وبكل الاتجاهات.
ما بعد صدام .
في يناير 2003 كانت إدارة جورج دبليوبوش على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم على العراق، وفي ذلك الوقت الذي كانت تدق طبول الحرب قال الرئيس الأميركي لبعض المقرّبين منه أنه يتهيأ لرفع المنع المفروض على وكالة الاستخبارات المركزية من اغتيال صدام حسين.
وكانت قرارات المنع تلك التي أصبح ممنوعاً بموجبها على الوكالة قتل أي رئيس دولة تعود إلى الفشل الذريع الذي كانت قد عرفته محاولة اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو خلال سنوات السبعينات.
لم يتم إلغاء تلك القرارات رسميا أبدا بشكل رسمي، لكن في تلك الأيام الأولى من عام 2003 كان المحافظون الجدد الذين يحيطون بالرئيس بوش - وكان أغلبهم قد عمل مع بوش الأب - يرفعون الأنخاب للاحتفال بالموت القريب لصدام حسين.
وكان دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي، قد صرّح بأنه يحق شرعيا للولايات المتحدة اغتيال أي إنسان كان قد ساهم من قريب أو بعيد بالتحضير لتفجيرات 11 سبتمبر؛ ثم أضاف رامسفيلد قوله أن جرما آخر يقع على كاهل صدام وهو تخزينه لأسلحة الدمار الشامل.
ويشير مؤلف الكتاب هنا إلى أن كولن باول، وزير الخارجية، وجورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والمحللين قد ذكّروا بإلحاح أنه ليس هناك ما يثبت بطريقة قاطعة أن لصدام روابط مع تفجيرات سبتمبر أو أنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وكان رامسفيلد يجيبهم باستمرار بأن مصادر معلوماته تفيد غير ذلك.
اكتشف عميل الموساد المقيم في السفارة الإسرائيلية بواشنطن أن المصدر الرئيسي الذي يزود رامسفيلد بالمعلومات هو أحمد الجلبي الذي كان قد ساهم في إنشاء المؤتمر الوطني العراقي. ويؤكد مؤلف هذا الكتاب أن أحمد الجلبي كان أحد مخبري الموساد في العراق بعد وصول صدام حسين إلى السلطة عام 1979.
وكان مدينا بمئات الملايين من الدولارات للذين أودعوا أموالهم في البنك الذي عمل بإدارته. وكان الموساد قد نجح في سحب ودائعه منه قبل إفلاسه. وبعد فترة وجيزة وجّه محمد سعيد النابلسي، مدير البنك المركزي الأردني، تهمة للجلبي بتحويل 70 مليون دولار إلى حساب خاص باسمه في أحد البنوك السويسرية.
وصل الجلبي إلى واشنطن لحظة انتخاب جورج دبليو بوش رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. ولم يكن حتى حرب الخليج الأولى سوى أحد الكثيرين من أمثاله الذين يبحثون عن مصالحهم.
لكن الحرب غيّرت المعطيات وتقرّب الجلبي باسم المؤتمر الوطني العراقي من أجواء المحافظين الجدد المحيطين بجورج دبليو بوش ومن بينهم ديك شيني وبول وولفويتز ودونالد رامسفيلد واتفق الجلبي مع هذا الأخير على القول أن صدام حسين قد يشكل خطرا على العالم كله.
والمثير للاستغراب أن الجلبي بدأ بالاطلاع على تقارير سرّية حول صدام حسين من إعداد وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. وأشار الجلبي إلى أن تقارير الوكالة بعيدة عن الواقع.
وفي نهاية صيف 2002، قبل عدة أيام من الذكرى الأولى لتفجيرات 11 سبتمبر، أمر رامسفيلد بإنشاء وحدة خاصة في البنتاغون من أجل إعادة النظر بالمعلومات التي يقدمها الجلبي وإعادة تقويم علاقات صدام حسين بالقاعدة وتطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق.
وضمن هذا الإطار أصبح أحمد الجلبي أحد مصادر المعلومات الرئيسية بالنسبة لرامسفيلد. وقد أثار ذلك غضب جورج تينيت، مدير الوكالة المركزية، الشديد إلى درجة أنه قدّم استقالته في أغسطس 2002، وحيث تدخل «تشيني» من أجل بقائه.
وجد مائير داجان الحظوة التي يتمتع بها الجلبي لدى رامسفيلد غريبة جدا، لاسيما وأن الملف الذي بيديه عنه يدل بوضوح على أنه لم يقدم سوى معلومات قليلة الأهمية عندما كان يتجسس لحساب الموساد في العراق. ثم إنه بعد عشر سنوات من مغادرته العراق، من المحتمل قليلا جدا أنه تكون له صلات حقيقية داخل نظام صدام حسين.
الديمقراطية والعضلات
تعرّف داجان خلال زياراته لواشنطن، كما فعل جميع مدراء الموساد، على أعضاء مهمين في إدارة بوش، وخاصة أولئك الذين ينادون بالديمقراطية ذات العضلات والذين كانوا يرددون في حديثهم ما يدل على تزمتهم الديني.
ويشير المؤلف في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه القس بيل غراهام، صديق عائلة بوش منذ فترة طويلة، في حث الرئيس بوش، بعد تفجيرات 11 سبتمبر، من أجل استئصال الإرهاب باسم «الغضب العادل»، بل وقام غراهام بإهداء جورج دبليو بوش إنجيلا صغيرا كي يضعه باستمرار في جيبه.
وعلى قاعدة مثل هذا الاعتقاد الديني تحدث بوش عن «محور الشر». ويضيف المؤلف: «إن إلحاح الرئيس بوش لشن هجوم على العراق كان مرتبطا، هو الآخر، بالاعتقاد الديني المتزمت للمحافظين الجدد الذين كانوا يحيطون به».
وفي الأيام الأولى من فبراير 2003، إثر محادثة هاتفية بين آرييل شارون والرئيس الأميركي بوش، أحاط شارون داجان علما أنه اقترح مشاركة الموساد النشطة باغتيال صدام حسين، وأن بوش قد قبل ذلك الاقتراح.
بدأ خبراء الموساد بتحليل محاولات الاغتيال السابقة لصدام حسين وأسباب فشلها وحيث كان الرئيس العراقي قد تعرّض خلال السنوات العشرالأخيرة إلى 15 محاولة اغتيال.
وكان وراء بعضها الموساد أو أجهزة الاستخبارات البريطانية. ولم يستطع أولئك الذين تمّ تجنيدهم للقيام بها من اختراق إجراءات الحماية الأمنية الممتازة لصدام أو لأنهم لم يستطيعوا بكل بساطة الاقتراب إلى درجة كافية من الهدف.
كان الموساد قد قام بمحاولة أولى في نوفمبر 1992، وكان عملاؤه في العراق قد خبروا أن صدام حسين سيقوم بزيارة إلى بلدة قرب تكريت وأنه سيصل قبل حلول الليل بقليل وسيزور في اليوم التالي قاعدة عسكرية في الجوار قبل أن يعود بالطائرة إلى بغداد. وبالتالي قد يكون هدفا ممكنا في فترة ال15 دقيقة التي يحتاجها للانتقال من البلدة إلى القاعدة العسكرية.
قام الجنرال أميرام لوفين، نائب مدير الموساد آنذاك، بالإشراف شخصيا على إعداد خطة الاغتيال، ووافق بنيامين نتانياهو عليها، وقام الفريق المكلّف بتنفيذها بالتدرب عليها في صحراء النقب. وكان مقررا أن يساند قتلة الموساد فريق من 40 عضوا من الفرقة 262 من القوات الخاصة التي كانت قد شاركت في قتل خاطفي طائرة العال إلى مطار أوغندي عام 1976.
كان مقررا أن يطير القتلة على ارتفاع منخفض بحيث لا تكشفهم الرادارات على متن طائرتين من طراز «هركيوليز سي - 130» وبحيث يتوزعون على الأرض إلى مجموعتين إحداهما تتمركز على بعد حوالي 200 متر من الفيللا التي كان صدام فيها بالقرب من تكريت وبجانب الطريق الذي يُفترض أن يسلكه إلى القاعدة العسكرية الجوية.
أما المجموعة الرئيسية فتكمن على بعد 10 كيلومترات ويتم تزويدها بصاروخ خاص يستخدمه الموساد ويتم توجيهه إلكترونيا. كان يُفترض أن يقوم فريق القتلة القريب بتصوير سيارة صدام وهو يطلق النار عليها، وفي اللحظة نفسها يعطي أحدهم الإشارة لفريق الصاروخ كي يطلقه تبعا للمعطيات المقدّمة بواسطة «الكاميرات» .
وبالتالي يتم تدمير السيارة. وما يؤكده المؤلف أن هذه العملية ألغيت باللحظة الأخيرة بدفع من آرييل شارون، وزير الخارجية، وإسحاق مردخاي، وزير الدفاع، على خلفية تقديرهما أن مخاطر فشلها كانت كبيرة جدا.
بعد عشر سنوات من تلك المحاولة، التي لم تتم، بدا أن الموساد، وبدعم من واشنطن، يتردد بدرجة أقل بكثير في محاولة اغتيال صدام حسين. وكانت خطة الموساد مستوحاة هذه المرة من محاولة الاغتيال التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو.
وكان العملاء قد حشدوا عددا كبيرا من الأصداف البحرية بالمتفجرات ووضعوها في قعر البحر حيث كان كاسترو يحب الاستحمام. لقد فشلت تلك المحاولة لأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أغفلت من حساباتها التيارات القوية التي جرفت القواقع بعيدا عن المنطقة.
لكن مثل هذه التيارات لم تكن تطرح أية مشكلة بالنسبة للنهر حيث يستحم صدام، وكانت المتفجرات مصممة هذه المرة للانفجار بمجرد قيام السابحين بأية حركة.
قبل أيام فقط من تنفيذ خطة الاغتيال الجديدة انفجرت حرب الخليج ثانية، وقدّم عملاء الموساد معلومات مهمة عندها قامت الطائرات الأميركية والبريطانية على أساسها بغارات قتلت الألوف من العراقيين.
ويؤكد المؤلف أن جورج تينيت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كان يتصل عدة مرّات يوميا بمائير داجان، مدير الموساد، ليسأله عمّا إذا كان جهازه قادرا على تأكيد حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل.
وكانت الإجابة دائما هي: «ليس بعد، ولكننا نبحث». لكن محللي الموساد كانوا قد شرحوا لداجان أنه لا يوجد هناك أي برهان قاطع على امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل.
رددت وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية، عند بداية الحرب، تحذيرات لإشاعة الاعتقاد بإمكانية قيام نظام صدام باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل أو ضد قبرص، حيث تتواجد أعداد كبيرة من القوات البريطانية، أو في منطقة الخليج حيث يرابط المارينز الأميركيون، أو حتى ضد الكويت، نقطة انطلاق الهجوم على العراق. «لكن لم يحصل شيء من هذا كله، ولم تنطلق قذيفة واحدة فيها أي أثر لسموم كيميائية.
ولم يعرف تاريخ الحرب كله مثل خيبة الأمل تلك». وبعد عشرين يوما من بداية الحرب كانت المعارك قد توقفت لتبدأ حرب أخرى، أكثر فتكا، تمتزج فيها الأحقاد الدفينة والمسائل البترولية والجشع المسيطر على النفوس...
وبدأت الدماء تنزف أكثر فأكثر في العراق. كان لا بد للعراق أن يغرق في الفوضى، وليصبح الوضع اعتبارا من مايو 2003 أكثر رعبا مما كان مرعبا في ظل دكتاتورية صدام حسين.
بعد السقوط
لم يكن الموساد، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب، بعيدا عن ملاحقة صدام بعد سقوط نظامه. وُضعت فرضيات كثيرة حول مكان وجوده، وليس أقلها غرابة إمكانية لجوئه إلى الأصدقاء الذين اعتمد عليهم في الماضي، أي روسيا والصين، هذا على الرغم من تأكيد البلدين رسميا أنهما لن يمنحاه حق اللجوء إليهما.
في الوقت نفسه كانت ألوف الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية تصل كل دقيقة إلى مقرات القيادات المختصة وكذلك آلاف المحادثات الهاتفية. أدركت عندها أجهزة الاستخبارات الأميركية المتنوعة مدى افتقارها إلى مترجمين يقومون ب«غربلة» تلك المحادثات. وكان بوش وبلير وشارون في حالة غضب متصاعد أمام فشل العثور على صدام أو معرفة إذا كان قد مات.
وقد كانوا يؤكدون في تصريحاتهم العلنية أن ذلك لم يكن يشكّل موضوعا ذا أهمية كبيرة فصدام لم يعد يمثل أي تهديد. لكن لم يكن هناك الكثيرون ممن يصدقون ذلك».
وكان اهتمام بوش وبلير منصبا أكثر على إيجاد أسلحة الدمار الشامل المزعومة. لكن الحقيقة تكشفت عن شيء آخر، هو أنها غير موجودة في العراق.
ولم يتردد روبن كوك، وزير الخارجية البريطاني السابق، وكلير شورت، الوزيرة السابقة في حكومة بلير التصريح أن رئيس وزراء بريطانيا قد كذب على البرلمان والشعب عندما أكد وجود مثل تلك الأسلحة في العراق.
وأثناء الأزمة كلها كان مائير داجان، لا يكف عن ترديد قوله أن الموساد «لا يزال يبحث» عن الأسلحة المزعومة، من دون إضافة شيء آخر. ولو كان يدرك حقيقة عدم وجودها.
وفي ديسمبر 2003 ألقي القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. يقول المؤلف: «لقد قبضوا عليه بسبب متطلبات المرأة الوحيدة التي كان لا يزال يثق بها أي سميرة شهبندر، الزوجة الثانية بين الزوجات الأربع».
ويضيف: «بتاريخ 11 ديسمبر اتصلت هاتفيا بصدام من مقهى للانترنت ببعلبك؛ حيث كانت تعيش في لبنان هي وابنها علي، الابن الوحيد الحي من أبناء صدام، تحت أسماء مستعارة منذ أن غادرا العراق قبل عدة أشهر من بداية الحرب». وفي بيروت تمّ رصدها ومراقبتها.
ويؤكد مؤلف هذا الكتاب أن مقرّبا من مائير داجان قد شرح له أنه «لأسباب سياسية لم تتم رسميا دعوة الموساد للمشاركة في العيد»، ويقصد ملاحقة صدام من قبل الأميركيين. وما يؤكده أيضا هو أن الموساد قد التقط يوم 11 ديسمبر 2003 مكالمة سميرة الهاتفية لصدام حسين وتمّ فيها تحديد موعد للقاء بالدقيقة والمكان.
وفي اللحظة نفسها التي كانت تستعد فيها للذهاب إلى موعدها جاءها صوت في الهاتف، ليس صوت صدام، يقول لها إن الموعد قد ألغي. وفي اللحظة نفسها أيضا كانت تلفزيونات العالم تبث صورا لاعتقال صدام في حجرةعلى عمق 5,2 متر في باطن الأرض قرب تكريت.
وعند رؤية تلك الصور طرح محللو الموساد أسئلة، لا تزال دون إجابات، مثل: من كان الرجلان المسلحان المجهولان ويقومان بالحراسة أمام الحجرة؟
هل كانا لحماية صدام أم لقتله إذا حاول الهرب؟ لماذا لم يستخدم صدام مسدسه للانتحار؟ هل منعه الجبن أم أنه كان يأمل في عقد صفقة؟ ثم لم يكن لمخبئه سوى مدخل واحد، فهل كان سجينا؟
ألم يكن وجوده حيث كان جزءاً من صفقة؟ وماذا كان يريد أن يفعل بال000 750 دولار التي وجدوها معه عند اعتقاله؟ ولماذا لم يكن معه أية وسيلة للاتصال بالخارج ولو حتى هاتف نقّال؟
الأولوية للتجسس
(هذه الحلقات هي عبارة عن أهم ما ورد في كتاب التاريخ السري للموساد ، من تأليف غوردون توماس)
يستمد هذا الكتاب أهميته من مؤلفه ومن منهاج تعامله مع موضوعه، أما المؤلف، غوردون توماس، فهو كاتب شهير يقيم في بريطانيا ويصل رصيده من المؤلفات الى 37 كتاباً، ترجمت إلى العديد من لغات العالم.
ومعظمها مكرس لعالم الاستخبارات، وهو في كتابه هذا يقدم تأريخاً لجهاز الموساد عقب لقاءات مع شخصيات عديدة لها صلة بشكل ما برصد أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلي فضلاً عن الوصول إلى الكثير من الوثائق والمصادر السرية، مما أتاح له الكشف عن أسرار لم تكن معروفة من قبل، ويلقي عليها الضوء في كتابه للمرة الأولى.
في عام 1917 أطلق اللورد بلفور وعده المعروف بإقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين. بدأت الحركة الصهيونية بعدها بالتحرك وشرع اليهود القلائل الذين كانوا في عين المكان بالتعبئة.
هكذا ذات يوم من أيام سبتمبر 1929 حاولوا التجمع علانية بالقرب من حائط البراق. رأى الفلسطينيون في ذلك تحديا لمشاعرهم ورشقوهم بالحجارة. وقال يومها أحد المسؤولين اليهود المشاركين بالتجمع: «قام بقاء شعبنا منذ الملك داؤود على النوعية الممتازة لاستخباراته».
كانت تلك الفكرة هي نواة قيام تنظيم استخباري وتجسسي يعد من أكثر الأجهزة ضراوة في العالم، أي الموساد. وكان الشكل الجنيني لهذا الجهاز قد تشكّل داخل منظمة «الهاغاناه» التي أنشأها اليهود في فلسطين من أجل ممارسة كل أشكال العنف لإرهاب الفلسطينيين العرب، وزودوها بجهاز مختص في التضليل وتزييف المعلومات بواسطة جواسيسهم. واعتبر ديفيد بن غوريون أن الأولوية المطلقة للهاغاناه ينبغي أن تتمثل في تعزيز شبكة استخباراتها.
وفي عام 1949 أي بعد قيام الدولة العبرية قرر بن غوريون، رئيس وزرائها آنذاك، إنشاء خمسة أجهزة سرية للعمل على صعيدي الداخل والخارج. واتخذت دوائر التجسس الأجهزة المناظرة لها في فرنسا وانجلترا نموذجا احتذت به لا سيما أن هذه الأجهزة قبلت التعامل مع الإسرائيليين الذين أقاموا علاقات أيضا مع الأجهزة السرية الأميركية.
لكن سرعان ما قامت الصراعات بين الوزراء والضباط الكبار في إسرائيل للوصول إلى المناصب العليا الحساسة، وكان كل منهم يريد أن يتولّى تنسيق الاستراتيجية العامة لإدارات الاستخبارات وتجنيد العملاء والوصول أولا إلى المعلومات المحصّلة كي يزوّد القيادات السياسية بها. وكان الصراع «مريرا بشكل خاص بين وزير الدفاع ووزير الخارجية إذ كان يريد كل منهما امتلاك حق الإشراف على أجهزة التجسس الخارجي».
منهاج العمل
في الثاني من مارس 1951 استدعى ديفيد بن غوريون رؤساء الأجهزة السرية الإسرائيلية الخمسة إلى مكتبه، وأعلن لهم قراره بجمع كل نشاطات التجسس الخارجي في جهاز واحد عمّده باسم «ها موساد لوتوم» أي «معهد التنسيق» كما أعلن في الوقت نفسه حصر مسؤولية «العمليات الخاصة» به شخصيا، بينما أشرف وزير الخارجية على الجهاز «إداريا وسياسيا».
وضمّ في الوقت نفسه ضباطا كبارا يمثلون هيئات الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى وخاصة شين بيت»، جهاز الأمن الداخلي، و«أمان»، جهاز الاستخبارات العسكرية وممثلين أيضا عن سلاحي البحرية والطيران. واحتفظت رئاسة الحكومة بدورها في حسم أي خلاف بين مختلف الأطراف. ولخّص بن غوريون الوضع بالصيغة التالية:
«تقدمون للموساد قائمة متطلباتكم وهو الذي يقوم بتأمينها. وليس عليكم الاهتمام بمعرفة أين سوف يتوجه ولا بالسعر الذي سيدفعه»، وجاء في نص المذكرة الأولى التي وجهها بن غوريون إلى «روفن شيلواه»، أول مدير للموساد، قوله: «سيعمل الموساد تحت إمرتي، وسوف يتبع تعليماتي ويقدم لي باستمرار تقريرا عن نشاطاته».
في مايو 1951، أي بعد عدة أسابيع فقط من تأسيس الموساد رسميا، تمّ الكشف عن الشبكة التي كان قد أنشأها في العراق.واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية عددا من الأشخاص بينهم عميلان إسرائيليان وعشرات من اليهود العراقيين ومن العرب.
ووجهت المحكمة العراقية تهمة التجسس لثمانية وعشرين شخصا وحكمت على العميلين الإسرائيليين بالإعدام وعلى 17 متعاملا معهم بالسجن مدى الحياة. خرج العميلان الإسرائيليان من السجن بعد فترة مقابل مبلغ مالي كبير جرى وضعه في حساب سويسري باسم وزير الداخلية العراقي، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب.
حلّت بعد فترة وجيزة كارثة أخرى، إذ أن العميل تيودور غروس لم يكن يعمل لحساب الموساد فقط وإنما أيضا لحساب الأجهزة السرية المصرية كما أكّد ايسر هاريل رئيس جهاز شين بيت مشيرا إلى امتلاكه لـ البرهان القاطع على خيانة غروس.
سافر هاريل إلى روما وأقنع غروس بالعودة معه إلى تل أبيب بعد أن وعده بمنصب رفيع في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية. حوكم غروس سرا وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، ويُفترض أنه مات قبل خروجه منه.
أدّت تلك القضية إلى استقالة روفن شيلواه وتولّي ايسر هاريل رئاسة الموساد لمدة أحد عشر عاما. وقد قوبل في البداية بقليل من الحماس من قبل ضباط الموساد، إذ كان قصير القامة، لا يتجاوز طوله مترا ونصف المتر مع أذنين منتصبتين مثل الرادار، هذا فضلا عن أنه كان يتحدث اللغة العبرية بلكنة واضحة مثل يهود أوروبا الوسطى.
وكانت ثيابه مهملة باستمرار وكأنه قد نام بها. كانت كلماته الأولى لأركان قيادته هي: «الماضي هو الماضي. ولن تكون هناك أخطاء بعد اليوم. سوف نعمل معا. ولن نتحدث لأحد إلا فيما بيننا».
في اليوم نفسه أفهم المتعاونين معه ماذا يعني بذلك، إذ عندما سأله سائقه عن الوجهة التي يقصدانها أجابه أنه سر وأخذ هاريل مكان السائق ثم عاد بعد قليل ومعه علبة من الحلوى لفريق عمله. كانت الرسالة واضحة وهو أنه هو وحده من يحق له أن يطرح الأسئلة. كانت ايماءة بسيطة، ولكنها حاسمة، إذ وجدت التعاطف لدى مرؤوسيه الذين قابلوه بفتور في البداية.
وقام هاريل بزيارة عدد من البلدان العربية سرا كي يشرف بنفسه على تجنيد عملاء لشبكات الموساد. ولم يكن يخفي تفضيله لأولئك الذين كانوا قد عاشوا في «الكيبوتزات»، الأمر الذي فسّره بالقول: «يعيش هؤلاء بالقرب من العرب ولم يتعلّموا كيف يفكرون مثلهم فقط، وإنما أن يفعلوا ذلك بسرعة أكبر».
لقاء في واشنطن
يحدد مؤلّف هذا الكتاب أهم صفات هاريل أنه كان صبورا جدا وكان شديد الحرص على المقرّبين منه بينما كان ينظر بعيون الشك والريبة لكل من ليس في دائرة هؤلاء.
واستطاع أن يثبت مواقعه أكثر بعد زيارته إلى واشنطن عام 1954 حيث التقى بـ آلان دالاس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقدّم يومها الإسرائيلي ذو القامة القصيرة هدية نقش عليها العبارة التالية:
«لن ينام حارس إسرائيل أبدا ولن يدغدغ النعاس عينيه»، وهذا ما علّق عليه الأميركي بالقول: «يمكنك الاعتماد عليَّ كي تبقى عيوني مفتوحة معك».
توطدت منذ ذلك اللقاء العلاقات أكثر بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي قدّمت للجهاز الإسرائيلي كل الأعتدة والتجهيزات الضرورية من أجل التنصت وآلات التصوير الدقيقة وأجهزة عديدة أخرى اعترف هاريل يومها أنه لم يكن يعرف حتى بوجودها. بل أقام الرجلان بينهما خطا هاتفيا أحمر للتحدث مباشرة، بعيدا عن كل «الآذان الأخرى» بل وبعيدا عن مصالح وزارتي الخارجية الأميركية والإسرائيلية.
وفي عام 1961 أشرف رئيس الموساد على عملية استهدفت استقدام آلاف اليهود المغاربة إلى إسرائيل. وبعد عام انطلق «هاريل» إلى جنوب السودان من أجل دعم المتمردين الموالين لإسرائيل ضد النظام القائم. وساعد في السنة نفسها إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الصديق القديم لإسرائيل من أجل التغلب على محاولة انقلاب عسكري.
لكن في الوقت نفسه واجه هاريل غضبا متصاعدا في الداخل من قبل اليهود المتزمتين، بمن في ذلك أشخاص داخل حكومة ديفيد بن غوريون، إذ اتهموه أنه لم يعد يحسب أي حساب لحساسيتهم الدينية، بل اتهموه بالسعي سرا للوصول إلى أعلى المراتب السياسية. وسيطر الفتور على علاقات بن غوريون وهاريل، الذي وجد نفسه مضطرا لتقديم تقرير مفصل قبل الشروع بأية عملية بينما كان طليق اليدين قبل ذلك.
تزايدت حدة الشائعات في فبراير 1962 إثر عملية خطف «يوزيل شوماشير» ابن الثامنة من قبل فرقة يهودية متطرفة جدا، كان جدّه لأمه أحد أعضائها وكانت تدعى فرقة «حرّاس جدران القدس».
سجنت الشرطة الإسرائيلية الجد فقامت مظاهرات عنيفة من قبل اليهود المتزمتين شبّهوا فيها بن غوريون بالنازيين لأنه تجرأ وسجن «عجوزا طاعنا في السن». أنذر مستشارو بن غوريون رئيسهم أن تلك القضية قد تكون سببا في هزيمته خلال الدورات الانتخابية المقبلة، بل قالوا له إنه في حالة نشوب حرب مع العرب قد «تدعم بعض المجموعات المتطرفة العدو».
استدعى بن غوريون رئيس الموساد هاريل وطلب منه إيجاد الطفل فاعترض قائلا بأن مثل هذا العمل ليس من مهمة جهازه. وينقل المؤلف عن هاريل قوله: «انخفضت الحرارة فجأة عدة درجات، وشرح لي أن هذا أمرا ينبغي تنفيذه. فأجبت أنني أحتاج على الأقل إلى قراءة ملف الشرطة. وافق رئيس الوزراء على ذلك وأعطاني ساعة واحدة من أجل ذلك».
جنّد هاريل 40 من رجاله بعد قراءة الملف بغية تحديد مكان وجود الطفل. كانت المهمة شديدة الصعوبة، إذ فشل أحد عملاء الموساد - أصبح رئيسا لجهاز الشين بيت فيما بعد- في التغلغل إلى صفوف الفرقة المتطرفة. وتمّ اكتشاف عميل آخر بعد أيام من تكليفه بمراقبة مدرسة تلمودية.
وحاول ثالث أن ينخرط بين مجموعة من اليهود الذين كانوا في الطريق إلى القدس من أجل دفن أحد أقاربهم. لكن أُكتشف أمره سريعا ذلك أنه أخطأ في تلاوة الصلوات.
لم يثن هذا الفشل المتكرر عزيمة هاريل الذي أعلن عن اقتناعه أن الطفل موجود خارج إسرائيل وفي مكان ما بأوروبا. فأقام خلية عمل مكلّفة بالبحث عنه في باريس. ولم يتم العثور على الطفل فاتجه فريق من الموساد إلى أميركا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
ألقت الشرطة البريطانية على عشرة من عملاء الموساد كانوا قد تزيّوا بهيئة «متدينين» مع لحى مزيفة وشاركوا في الاجتماع الديني صباح يوم سبت في كنيس بضواحي لندن. لكن جرى الإفراج عنهم سرا وسريعا عن طريق تدخل السفارة الإسرائيلية لدى السلطات المعنية.
جرت في تلك الأثناء دعوة حاخام متشدد حقيقي إلى باريس للإشراف على عملية ختان أحد صبيان عائلة يهودية غنية، استقبله في المطار حاخامان بثياب سوداء على غرار أزياء المتطرفين اليهود، ولم يكونا في الحقيقة سوى اثنين من عناصر الموساد.
وقد جاء في التقرير الذي أرسلاه لمسؤولهما: «اقتيد الحاخام إلى أحد مواخير شارع بيغال من دون أن يعتريه أي شك حول طبيعة المكان. دخلت عاهرتان كنّا قد دفعنا لهما الأجر إلى غرفته وألقيتا نفسهما عليه. التقطنا له صورا ثم عرضناها عليه مع التهديد بنشرها إذا لم يخبرنا عن مكان الطفل. لكنه أقنعنا بعدم معرفته مكان وجوده فقمنا بتمزيق الصور أمامه».
هناك حاخام آخر هو شاي فراير اعترض عملاء الموساد طريقه عندما كان يقصد جنيف قادما من باريس. بدا أن هذا الاحتمال الجديد لا يؤدي إلى أية نتيجة. مع ذلك أصدر هاريل الأوامر باعتقال الحاخام في مقر الموساد بجنيف حتى نهاية التحقيق خشية أن يقوم بإخطار المجموعات اليهودية المتطرفة كلها.
هناك سبيل آخر بدا واعدا وتمثل في مادلين فراي ابنة الأسرة الأرستقراطية الفرنسية التي كانت أنقذت الكثير من الأطفال اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت تتردد بعد ذلك كثيرا نعلى إسرائيل حيث قابلت بعض أعضاء الفرقة المتطرفة، وكانت هي نفسها قد اعتنقت اليهودية. في شهر أغسطس 1926 حدد عملاء الموساد مكان إقامتها في إحدى ضواحي باريس.
قابلت مادلين عملاء الموساد بجفاء عندما قدّموا أنفسهم لها، فجاء هاريل نفسه لمقابلتها وشرح لها الظلم الكبير الواقع على والدي الطفل يوزيل. أكّدت مادلين أنها لا تعرف شيئا عن الأمر، فطلب منها هاريل رؤية جواز سفرها، كانت توجد تحت صورتها صورة لابنتها فأشار رئيس الموساد لأحد عناصره كي يعطيه صورة ليوزيل. كان الشبه كبيرا إلى حد التماثل بين الوجهين. فاتصل هاريل حالا بتل أبيب وقال:
«أعرف كل ما أحتاج معرفته عن مادلين من أبسط تفاصيل حياتها الغرامية عندما كانت طالبة إلى قرارها الالتحاق بالحركة اليهودية المتطرفة بعد تخليها عن مسيحيتها. لقد قلت لها، كما لو أنني أملك البرهان القاطع، إنها صبغت شعر الطفل يوزيل بغية إخراجه من إسرائيل. نفت كل شيء».
لكنها اعترفت أخيرا بكل شيء وكيف أنها سافرت كسائحة إلى حيفا بحرا. وبعد أسبوع خرجت أمام الشرطة قاصدة زيوريخ جواً بعد أن ألبست يوزيل ثياب طفلة وصبغت شعره.
أمضى يوزيل بعض الوقت في مدرسة تلمودية متطرفة في جنيف ثم اصطحبته مادلين إلى نيويورك. وعندما سألها هاريل عن مكان وجوده الراهن أعطته العنوان في بروكلين بنيويورك، وأن اسمه أصبح يانكال جيرتنر. عندها قال لها هاريل مبتسما:
«شكرا مادلين، وإنني أرغب عرض منصب عليك في جهاز الموساد. فموهبتك يمكنك أن تقدم خدمات كبرى لإسرائيل». ورفضت مادلين ذلك. طار عملاء الموساد إلى نيويورك حيث كان ينتظرهم فريق من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بطلب خاص من بن غوريون إلى وزير العدل الأميركي. وصل الجميع إلى العنوان.
فتحت السيدة «جيرتنر» لهم الباب، دخلوا فوجدوا الأب يصلي وبجانبه طفل شاحب وعلى رأسه القلنسوة اليهودية وخصلتا شعر طويلتان تتدليان على وجهه. فقال له أحد عملاء الموساد «مرحبا يوزيل. نحن هنا كي نعيدك إلى أهلك». هكذا مضت ثمانية أشهر منذ بداية البحث وأُنفق مليون دولار في العملية.
لم يمنع هذا النجاح الذي حققه هاريل من تقديمه استقالته بتاريخ 25 مارس 1963 بعد حملة شائعات وتشهير قادها مائير اميت، رئيس جهاز «أمان» وخلف «هاريل» على رأس الموساد. كان عمر هاريل آنذاك خمسين عاما. وانتهت باستقالته حقبة من تاريخ الجهاز الإسرائيلي.
الأولوية للتجسس
بعد عدة دقائق فقط من جلوسه خلف مكتبه الجديد استدعى أميت رؤساء الدوائر. لقد اصطفوا أمامه، ونظر إليهم بهدوء واحدا بعد الآخر، ليقول لهم بعد ذلك أنه لن تكون هناك بعد آلان مهمات البحث عن أطفال، وأعطى الأولوية للتجسس.
وبعد فترة قصيرة من استلام أميت منصبه حضر إلى السفارة الإسرائيلية بباريس شخص قدّم نفسه باسم «سلمان». وقال أنه يمكن أن يقدم، مقابل مليون دولار، إحدى الطائرات المقاتلة الأكثر مضاء آنذاك أي «الميغ-21». وختم سلمان حديثه بالجملة الغريبة التالية: «ما عليكم سوى إرسال أحدهم إلى بغداد. وهناك يقوم بالاتصال بهذا الرقم ويطلب جوزيف، ولا تنسوا تحضير المليون دولار».
عرض الدبلوماسي مضمون المحادثة على جاسوس إسرائيلي موجود في السفارة حافظ على موقعه رغم التغييرات التي قام بها مائير أميت. وأرسل الجاسوس بدوره المعلومات إلى تل أبيب مع رقم الهاتف الذي أعطاه «سلمان».
حيّرت القضية أميت، فمن جهة هناك خشية أن يكون سلمان عميلا مزدوجا جندته الاستخبارات العراقية من أجل نصب فخ للموساد. وهناك خطر الكشف عن عملاء الموساد في العراق. لكن كان إغراء الحصول على الميغ-21 كبيرا أيضا، إذ كان مسؤولو الطيران الإسرائيليون على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على المعلومات الخاصة بها.
قال أميت نفسه حول تلك القضية: «كنت أفكر بها قبل أن أنام وحالما أستيقظ، وكل الأوقات بينهما عندما تكون لديًّ دقيقة فراغ. فمعرفة السلاح المتقدم للعدو هي أولوية بالنسبة لكل جهاز استخبارات، والحصول على طائرة من هذا النوع أمر شبه مستحيل». اختار أميت للعميل الموفد إلى بغداد اسما وجواز سفر بريطانيين:
جورج بيكون الذي ذهب بصفة مدير مبيعات في شركة لندنية مختصة بتصنيع أجهزة التصوير الشعاعي الطبي. وصل إلى بغداد بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية ومعه عدة صناديق من العينات، بل وأظهر كفاءة عالية حيث باع عدة أجهزة لمستشفيات عراقية.
في بداية الأسبوع الثاني لإقامته اتصل بيكون بالرقم المعني. وينقل عنه المؤلف قوله: «اتصلت من هاتف مدفوع الأجر في بهو الفندق. ذلك أن خطر التنصت أقل مما هو في الغرفة. رفع أحدهم السماعة عند الرنّة الأولى وسأل بالفارسية عن المتحدّث.
فأجبت بالإنجليزية معتذرا بغموض وكأنني قد أخطأت بالرقم. فطلب مني المتكلم - بالإنجليزية هذه المرّة - الافصاح عمّن أكون. فقلت إنني صديق لجوزيف، وهل يعرف أحدا بهذا الاسم؟ فرجاني الانتظار. قلت لنفسي إنهم يحاولون الآن تحديد موقع الهاتف الذي أتحدّث منه وأنني ربما وقعت في الفخ. لكن شخصا ودودا قال لي أن اسمه جوزيف وأنه مسرور لاتصالي. وسألني إن كنت أعرف باريس. كان هو الشخص المقصود قلت لنفسي».
جرى اللقاء ظهر اليوم الثاني في أحد مقاهي بغداد. يقول بيكون عن اللقاء: قال لي جوزيف أنه مسرور لرؤيتي (...). وتحدث عن المطر والطقس الجميل (...). فهمت أنه ليس عميلا في جهاز مكافحة التجسس، فهدأت انفعالاتي، وقلت له أن أصدقائي مهتمون جدا بالسلعة التي تحدث عنها صديقه.
فأجابني: «سلمان ابن أخي. يعيش في باريس كنادل في مقهى. جميع الندل الجيدون غادروا». ثم اقترب من الطاولة وأضاف: «أنت هنا من أجل الميغ؟ أستطيع جلبها لك. لكن هذا كلفته مليون دولار».
ثم طلب العجوز عدم التحدث حيث هما، وحددا موعدا في أحد الأماكن العامة على ضفة الفرات في اليوم التالي. لم تغمض عينا «بيكون» تلك الليلة بسبب هاجس أن فخا قد نُصب له إمّا من قبل الاستخبارات العراقية وإمّا من قبل عصابة من المحتالين الدهاة.
قدّم له موعد اليوم الثاني إيضاحات أكثر عن شخصية جوزيف ودوافعه. إنه ينتمي في الأصل إلى عائلة يهودية فقيرة.
عمل عندما كان فتى لدى عائلة مارونية غنية صرفته من الخدمة بعد 30 سنة من العمل. فوجد نفسه في الشارع وعمره 50 سنة. واعتراه وهو بتلك الحالة الحنين إلى جذوره اليهودية.
عبّر عن رغبته تلك لأخته المدعوة مانو التي كان ابنها منير قائدا لطائرة مقاتلة في سلاح الطيران العراقي. فأخبرته مانو بأنها تحلم هي أيضا بالهجرة إلى إسرائيل. لكن كيف؟
بقيت الفكرة في ذهن جوزيف، وسمع منير يردد أمامه عدة مرّات أثناء الطعام أن رئيسه لا يكف عن القول بأن الإسرائيليين مستعدون لدفع مليون دولار من أجل إلقاء نظرة واحدة على طائرته. هكذا رسخ مبلغ المليون دولار في رأسه.
وفكر جوزيف بهجرة جماعية تترك الأسرة كلها في اطارها العراق دفعة واحدة. كان منير شديد التعلق بوالدته وعلى استعداد لفعل أي شيء من أجلها، وقد يقبل الفرار بطائرته. أما بقية أفراد العائلة فيتكفل العملاء الإسرائيليون بذلك، وهم أصحاب خبرة كبيرة في هذا الميدان. وضمن هذا الإطار ذهب «سلمان» إلى السفارة الإسرائيلية بباريس.
«ومنير؟ هل هو على اطلاع؟» هكذا سأل بيكون فأجاب جوزيف: «بالتأكيد. وهو موافق على الهرب. لكنه يريد نصف المبلغ حالا والنصف الآخر قبيل الرحيل». اندهش بيكون، فكل ما سمعه بدا ممكنا وقابلا للتحقيق. لكن ينبغي عليه أولا تقديم تقريره إلى مائير أميت. سأل هذا الأخير بعد لقاء استمر نصف يوم كامل مع بيكون عند عودته وشرح خطة جوزيف كاملة. «لكن، أين يريد أن يتم الدفع؟»، «في أحد البنوك السويسرية».
فأردف أميت: «يبدو أن جوزيف هذا لاعب ماهر، وعندما نضع المال على الحساب لن نراه بعد ذلك. فما الذي يدفعك للثقة به؟» «أثق به، إذ ليس هناك خيار آخر. فأمر «أميت» بوضع نصف مليون دولار في بنك سويسري «كريدي سويس».كان الرهان دقيقا، وليس فقط على الصعيد المالي، إذ كان يعرف أنه لن يبقى على رأس الموساد إذا تكشف أن جوزيف محتال كما يتوقع بعض العاملين معه.
الميغ التي اختفت
أخطر أميت كلاً من بن غوريون وإسحاق رابين رئيس الأركان، فأعطيا الضوء الأخضر. فأخبرهما أميت أنه سوف يسحب جميع عملاء الموساد في العراق.
قال: «في حالة الفشل، ستكون رأسي وحدها التي ستطيح. لقد شكّلت خمسة فرق. الفريق الأول مسؤول عن الاتصال بين بغداد وبيني. والتعليمات الموجهة له تنص على التزام الصمت الكامل إلا في حالة وقوع أزمة كبيرة. بتعبير آخر لم أكن أريد التحدث عن هذا الفريق تحت أية حجة كانت.
وكان على الفريق الثاني الذهاب إلى بغداد دون أن يكون أحد على علم بذلك، لا بيكون ولا عناصر الفريق الأول، فعلا لا أحد. وتمثلت مهمته في إخراج بيكون إذا حدث خلل وأيضا جوزيف إذا أمكن ذلك. والفريق الثالث مهمته أن لا تغيب عائلة جوزيف عن ناظريه. والفريق الرابع مهمته جلاء المعنيين. وكان على الفريق الخامس تأمين الصلات مع واشنطن والأتراك.
كان ينبغي على طائرة الميغ اختراق الأجواء التركية بعد مغادرة العراق قبل أن تحط عندنا. وكان ينبغي على الأميركيين الذين يمتلكون قاعدة في شمال تركيا، دفع الأتراك للتعاون عبر القول لهم أن الطائرة موجهة إلى الولايات المتحدة. وكان قد تمّ إخباري بأن العراقيين، بدافع خشية هروب أحد طياريهم، لم يكونوا يملؤون خزانات وقود طائرات الميغ إلا نصفها. وهذا ما كان باستطاعتنا أن نفعل شيئا حياله».
انطلقت العملية بعد ذلك. وحصل ابن عم جوزيف على السماح له بالخروج بحجة العلاج إلى جنيف. وعندما وصل إليها بعث ببطاقة بريدية إلى بغداد قال فيها: «المنشآت الصحية ممتازة، وأنا متأكد من أنني سوف أتوصل إلى الشفاء الكامل». كانت تلك هي الإشارة المتفق عليها للتأكيد أنه جرى ايداع مبلغ نصف المليون دولار الثاني في رقم الحساب المعني في سويسرا.
أعلن جوزيف، بعد أن اطمأن إلى وصول المبلغ كاملاً إلى الحساب السويسري، للعميل الإسرائيلي «بيكون» أن جميع أفراد أسرته جاهزين للسفر. فعشية المهمة الأخيرة التي كان منير سيقوم فيها للتدرب على طائرته المقاتلة قادهم جوزيف كلهم في موكب إلى أحد الجبال «للاستمتاع بعذوبة المناخ».
لم تعترض القوات العراقية المنتشرة على عدة حواجز في الطريق على ذلك، إذ كان من المألوف أن يهجر العديد من سكان العاصمة حرارتها الشديدة كل صيف للذهاب إلى الجبال.
استقبل فريق الاتصال الإسرائيلي الذي كان موجوداً في المناطق الكردية أفراد عائلة جوزيف الذين جرى اقتيادهم إلى منطقة أخرى حيث كانت تنتظرهم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش التركي. وكانت الطائرات تخترق الحدود من دون أية صعوبات عبر طيرانها على ارتفاع منخفض جدا بحيث لا يمكن لأجهزة الرادار أن تكتشفها.
اتصل أحد عملاء الموساد بمنير كي يخطره بأن أخته قد ولدت طفلة وأن كل شيء تم على ما يرام، كانت تلك رسالة مشفرة جديدة تعني أن عملية ترحيل أفراد العائلة قد اكتملت تماما.
في صباح اليوم التالي الذي صادف الخامس عشر من شهر أغسطس 1966، ومع شروق الشمس أقلع منير بطائرته في مهمة اعتيادية. وما إن ابتعد عن القاعدة حتى زاد قوة محركات طائرته الميغ إلى أقصى حد ممكن وبلغ الحدود التركية قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء ضده، بما في ذلك احتمال إسقاط طائرته.
ومع اجتيازه الحدود التركية رافقت طائرته عدة طائرات من طراز فانتوم تابعة للسلاح الجوي الأميركي. لقد حطّ منير بطائرته في إحدى القواعد التركية حيث جرى تزويدها بالوقود وأقلع من جديد، وعندها تلقى رسالة جديدة صريحة وغير مشفرة جاء فيها: «عائلتك في مكان آمن وسوف تلحق بهم بعد فترة قليلة». حطت طائرة الميغ-21 بعد ساعة في أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية.
هكذا نجح جهاز الموساد في أن ينال شهرة على صعيد التجسس. كانت تلك مرحلة مفصلية في مسيرة هذا الجهاز الذي كان قد غدا ذا باع طويل في عالم العمليات السرية.
إسرائيل تنشر الجواسيس في المطارات العربية قبيل النكسة
* الحلقة الثانية :
يجد القارئ نفسه هنا على موعد مع إضاءة لمنعطف بالغ الأهمية في مسيرة جهاز الموساد، بما في ذلك إعداد هذا الجهاز لحرب يونيو 1967 ضد العرب، وكيف أفلح في أن يجمع في آن بين التعاون الوثيق مع الأميركيين ومع مد الجسور نحو جهاز المخابرات السوفييتي العتيد، «الكي جي بي». وتبرز في الصورة أيضاً قصة سقوط عميلين بارزين من عملاء الجهاز هما إيلي كوهين وولفغانغ لوتز.
أمضى مائير أميت خمس سنوات على رأس جهاز الموساد (1963-1968) قام خلالها بزيارات سرية إلى العديد من العواصم العربية وغير العربية. ولم يكن هناك من يتجرأ على سؤاله عن مصادر معلوماته وموارده وطرق عمله.
استطاع الموساد في ظل إدارته جمع كمّ هائل من المعلومات، وجنّد الكثير من الجواسيس في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وفي العالم العربي، حيث استطاع عملاؤه اختراق جهاز الاستخبارات الأردني الذي كان يُنظر إليه كأفضل جهاز أمني عربي وكذلك جهاز الاستخبارات العسكرية السوري الذي يوصف بأنه الجهاز الأكثر انغلاقا.
وبعد وصول أميت بفترة قصيرة إلى إدارة الموساد أمر بتعميم مذكرة على مختلف أقسام جهازه كان قد سرقها أحد عملائه من مكتب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات.
ومما جاء فيها: «يمتلك الموساد ملفا عن كل منّا. إنه يعرف أسماءنا وعناويننا. وتوجد فيه صورتان إحداهما لنا ونحن حاسرو الرؤوس والثانية ونحن نلبس الكوفية. وبالتالي لا يجد جواسيس الموساد صعوبة في رصدنا في أي مكان ولو كنّا بالزي المدني».
ويشير مؤلف هذا الكتاب إلى الدور الذي لعبه المخبرون الذين جنّدهم مائير أميت في الارشاد إلى مخابئ أسلحة منظمة التحرير وعلى أعضائها. وتفيد المعلومات التي يقدمها أنه مع اقتراب حرب 1967 كان للموساد مخبرون في جميع القواعد الجوية والقيادات العسكرية العامة.
وكان أميت يهتم بأبسط التفاصيل مثل «معرفة المسافة التي يقطعها طيار من موقع عمله ومكان تناول طعامه؟ وكم من الوقت يمضي أحد ضباط الأركان مثلا كل يوم في ازدحام السير بمدينة القاهرة؟ وهل لهذا الضابط القيادي خليلة؟».
وكانت «خلية الحرب النفسية داخل جهاز الموساد» تعمل باستمرار من أجل جمع ملفات حول الطيارين العرب والفرق العاملة على الأرض وأعضاء القيادات وكفاءاتهم وآليات ترقيتهم وميلهم نحو الكحول ونزوعهم الجنسي.
وكان أميت يدرس تلك الملفات بعناية حتى ساعة متأخرة في الليل أحيانا بحثا عن «الأكثر هشاشة» أمام الضغوط أو الوعود. هكذا استقبلت العديد من العائلات رسائل مجهولة المصدر تتحدث عن عادات وممارسات ابن أو زوج. وبمقدار ما كان يتم زرع البلبلة كان فرح مائير أميت كبيرا.
حديث النكسة
يشير المؤلف إلى أن مائير أميت حدد، بالاعتماد على المعلومات التي جمعها خلال فترة طويلة، لمسؤولي الطيران الإسرائيلي الساعات الأفضل للقيام بغارات خاطفة على القواعد الجوية المصرية في عام 1967.
وشدد على أنه ما بين الساعة السابعة والنصف والسابعة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحا تكون وحدات رقابة الرادار في أقصى مستوى من حيث هشاشتها.
فالفريق الليلي يكون في غاية الإنهاك بعد ساعات العمل الطويلة والفريق النهاري لا يكون شديد الحذر فضلا عن تأخر أفراده غالبا في تناول الطعام. أما الطيارون فكانوا يتناولون إفطارهم ما بين الساعة السابعة والربع والسابعة وخمس وأربعين دقيقة. ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مواقع عملهم لارتداء زي الطيران.
تستغرق هذه العملية حوالي عشر دقائق، ويضيع أغلبهم عدة دقائق إضافية في الحمّام قبل الوصول إلى حيث توجد طائراتهم في ملاجئها. هكذا يكونون على استعداد للبداية «الرسمية» لعملهم عند الساعة الثامنة صباحا.
عندها تقوم الفرق الأرضية بإخراج الطائرات من الملاجئ لتزويدها بالوقود وتسليحها. وخلال ربع ساعة تتزاحم حول الطائرات شاحنات الصهاريج وعربات نقل الذخائر.
وبالطريقة نفسها جرى الاستخبار الدقيق عن ضباط القيادات العليا الذين لا يكونون في مكاتبهم إلا في حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا، أما الضابط المسؤول عن إصدار القرارات فلا ينكب جديا على مراقبة حركة العمل في القواعد إلا حوالي الساعة الثامنة والنصف.
ونتيجة هذه التوصيفات كلها شرح مائير أميت أن أفضل توقيت لقيام الطائرات الإسرائيلية بغارة خاطفة على القواعد المصرية هي ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا.
وفي صبيحة الخامس من يونيو 1967 قامت الطائرات الإسرائيلية بغاراتها على القواعد الجوية المصرية عند الساعة الثامنة ودقيقة واحدة وارتفعت أعمدة الدخان من شاحنات الصهاريج والطائرات التي انفجرت مع ذخيرتها. اعتبر «مائير أميت» أن عمل جهازه قد حدد وحده سير المعارك.
كان كل مجنّد جديد في صفوف الموساد يمضي ثلاث سنوات في تدريب مكثّف يخضع خلالها لمساءلات شديدة. وينتهي الأمر به ـ أو بها ـ في نهاية التدريب إلى استخدام الأسلحة وخاصة مسدس سباريتا عيار 22».
وكان العملاء يبدؤون عملهم عادة في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا. وكانت مهمتهم في نيويورك مثلا هي التغلغل في صفوف البعثات الدبلوماسية في منظمة الأمم المتحدة.
أما في واشنطن فقد كانت لهم مسؤولية إضافية هي «مراقبة» البيت الأبيض. وكان بعض العملاء يقومون بمهمات محددة في هذه المنطقة أو تلك حيث توجد توترات ثم يعودون بعد القيام بمهامهم.
وسّع مائير أميت كثيرا من مجال نشاطات الموساد إذ أضاف للجهاز إدارة لجمع المعلومات مكلّفة بالتجسس في الخارج وإدارة للعمل السياسي تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة «الصديقة» وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات البريطاني.
أمّا إدارة البحوث فقد جرى تقسيمها إلى 15 مكتبا يختص كل منها ببلد عربي. هذا بالإضافة إلى مكتب مختص بكل من الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وبريطانيا وأوروبا والاتحاد السوفييتي. ثم أضيفت لها بعد ذلك مكاتب مختصة بالصين وجنوب إفريقيا والفاتيكان.
سقوط كوهين
شكّل عملاء الموساد قوة جاهزة باستمرار لزرع الشقاق ومناخ عدم الثقة بين الدول العربية وبث إشاعات دعائية مشككة وتجنيد مخبرين تطبيقا لقاعدة «فرّق تسد» التي كان مائير أميت يؤمن بها تماما. وكان رجاله لا يترددون أحيانا في أن يتركوا خلفهم الدمار والموت.
ويفتخر أميت بعميلين إسرائيليين كان وراء نشاطهما، وهما إيلي كوهين وولفغانغ لوتز. وكوهين من مواليد مدينة الإسكندرية بتاريخ 16 ديسمبر 1924. كان متدينا جدا مثل أسرته، وخرج من مصر في شهر ديسمبر 1956 بعد أزمة ثم حرب السويس في تلك السنة. وصل إلى حيفا لكنه أحس بالغربة فيها.
وجنّدته مصلحة الجاسوسية العسكرية الإسرائيلية عام 1957، ولم يعجبه عمله كمحلل فحاول الدخول إلى جهازالموساد لكن طلبه قوبل بالرفض.
وينقل المؤلف عن أميت قوله له: «لقد جرحه رفضنا بعمق. فترك الجيش وتزوج من فتاة عراقية اسمها نادية». عمل كوهين بعدها لمدة عامين في أحد مكاتب التأمين بتل أبيب.
وفي عملية تفحص لملفات «المرشحين المرفوضين» إثر بحث مائير أميت عن «نموذج خاص لعميل من أجل مهمة خاصة جدا هي الأخرى» لم يجد الشخص المطلوب بين عناصره فأعاد النظر في ملفات المرفوضين. وبدا له أن «كوهين» يمثل أفضل الإمكانيات المتوفرة. فبوشرت مراقبته سرا في الحال.
أشارت تقارير جهاز الموساد الأسبوعية إلى رتابة عاداته وتعلقه بزوجته وأطفاله. وكان الرأي النهائي به من قبل أميت أنه «صالح للخدمة».
أمضى كوهين دورة تدريبية مكثفة لمدة ستة أشهر في مدرسة الموساد. وعلّمه خبراء كيف يتعامل مع المتفجرات والقنابل الموقوتة وصناعتها من أبسط الأشياء، وتحوّل إلى قناص جيّد. وتعلم فك رموز الرسائل المشفرة وأيضا كتابتها، واستخدام جهاز البث اللاسلكي. أظهر كفاءات عالية وذاكرة قوية.
ومع ذلك بقي مائير أميت مترددا وقال عن ذلك: «تساءلت مئة مرة إذا كان إيلي صالحا بالفعل للقيام بما كنت أنتظره منه. وكنت بالطبع أُظهر له باستمرار ثقتي الكاملة به.
ولم أكن أريد خاصة أن يلاحظ خلال مهمته أنه مهدد باستمرار. ثم قلت لنفسي أن أفضل العقول في الموساد قدّموا له معارفهم وخبراتهم، وقررت القيام بالمحاولة».
وتقرر بعد تحضيرات عديدة ومعمقة ذهاب إيلي كوهين باسم جديد هو كامل أمين ثابت إلى بيونس ايريس في الأرجنتين بصفة تاجر يجيد لغة المبادلات التجارية مع سورية.
وجاء على لسان مائير أميت: «لقد تفهّم بسرعة كل ما كان بحاجة إليه مثل الفرق بين الفواتير وبوالس الشحن وبين العقود والكفالات، الخ. لقد كان حرباء حقيقية. واختفى أمام ناظري إيلي كوهين ليبرز كامل أمين ثابت، ذلك السوري المقيم في الأرجنتين والذي لم يتخلّ أبدا عن حلمه القديم في العودة إلى دمشق.
تعززت ثقة إيلي بنفسه يوما بعد يوم واستعجل الدخول في العملية وإثبات نجاحه في لعب الدور المطلوب منه. لقد فعلنا أفضل ما نستطيع لتعليمه إيقاع حياته الجديدة. والباقي عليه. كنا نعرف ذلك جميعا. ورحل من دون ضجة تاركا إسرائيل بشكل سري مثل جميع الجواسيس».
وجد كوهين بسرعة مكانة مرموقة في عالم الأعمال بالعاصمة السورية، وبالتالي تعرّف على العديد من الأصدقاء في المراكز العليا بالحكومة. ولم يتردد في المزايدة بالقول ان سوريا لن تقهر في مواجهة «العدو الصهيوني»، هكذا جرى اصطحابه مع وفد من الزائرين إلى هضبة الجولان السورية للاطلاع على التحصينات العسكرية فيها.
وهناك رأى بأم عينيه المخابئ التي توجد فيها المدافع طويلة المدى التي زوّدت روسيا بها سورية. بل وسُمح له بالتقاط صور. وكان كوهين قد أخبر تل أبيب بوصول دبابات ت-54 إلى سوريا بعد عدة ساعات فقط من استلامها. بل استطاع التوصل إلى خطة كاملة للإستراتيجية السورية الخاصة بشمال فلسطين المحتلة. كانت تلك معلومات لا تقدّر بثمن.
كان كوهين يعادل بنظر مائير أميت فرقة مدفعية كاملة. لكنه أخذ عليه تهوره قليلا. فمثلا كان مولعاً جداً بكرة القدم وغداة هزيمة الفريق الإسرائيلي خرق القاعدة الأكثر حزما في الاتصالات السرية إذ بعث إلى المسؤول عن الاتصال به رسالة تقول: «ربما أنه قد آن الأوان لنتعلم كيف نكسب أيضا في ملاعب كرة القدم». ثم تبع ذلك برسالة أخرى جاء فيها: «أتمنى عيد ميلاد سعيد لزوجتي» ثم «أتمنى عيد ميلاد سعيد لابنتي».
أعرب مائير أميت عن غضبه من سلوك جاسوسه قبل أن يردف: «إنها إحدى الإساءات المؤقتة التي تبدو في بعض اللحظات حتى لدى الأفضل» ثم أضاف: «كنت أسعى كي أضع نفسي في مكانه.
فهل كان بصدد فقدان الأمل؟ وهل كان يحاول إظهار ذلك عبر التقليل من الحذر؟ لقد أعدت في رأسي الحكاية كلها. وأخذت باعتباري مئة عامل وعامل. لكن في النهاية كان هناك عامل واحد له قيمة حقيقية وهو: هل كان لا يزال مؤهّلا للاستمرار في القيام بمهمته؟
كانت إجابة مائير أميت هي «نعم». لكن ذات مساء من يناير 1965، كان إيلي كوهين في غرفته بدمشق يستعد للقيام بعملية اتصال عبر جهاز الإرسال. وفي لحظة البدء بالإرسال وجد نفسه محاطا برجال مكافحة الجاسوسية السوريين.
بعد أن كان قد جرى التقاط مراسلاته من قبل وحدة متحركة مجهّزة بأعتدة سوفييتية كانت هي الأكثر تقدما في العالم آنذاك. طلب منه رجال الأمن السوري بث رسالة محددة للموساد. لكن فهم «أميت» من تغير نبرة الصوت أن إيلي كوهين سقط بيد السوريين الذين أعلنوا الخبر بعد يومين.
قال أميت: «اعتراني الإحساس أنني فقدت أحد أفراد أسرتي. وفي مثل هذه الحالات يطرح الإنسان على نفسه أسئلة مثل: ألم يكن ممكنا إنقاذه؟ كيف أمكن رصده؟ هل ارتكب حماقة؟ هل أوشى به أحد المقرّبين؟ هل كان يتمنى اكتشاف أمره في لا وعيه؟ مثل هذا الأمر قد يحصل أحيانا، أم كان الأمر يتعلق بمجرد سوء حظ؟ تبقى الإجابات غائبة، لكن يبقى التساؤل وسيلة لتخطي الأزمات».
لم يبح إيلي كوهين بشيء. وحاول مائير أميت إنقاذ حياته. وكان وراء الحملة الدولية التي أطلقتها زوجته نادية كوهين للدفاع عن زوجها حيث قابلت بابا الفاتيكان وملكة بريطانيا وعدداً آخر من رؤساء الدول.
وسافر أميت إلى أوروبا حيث قابل رؤساء الأجهزة السرية الألمانية والفرنسية الذين لم يستطيعوا عمل شيء. بل وقام باتصالات غير رسمية مع الاتحاد السوفييتي. وتابع مساعيه حتى يوم 18 مايو 1965 عندما خرجت من سجن المزّة العسكري بالقرب من دمشق سيارة عند الساعة الثانية صباحا وعلى متنها إيلي كوهين. كانت الوجهة هي ساحة المرجة حيث نُصبت مشنقة علّقوا فيها إيلي كوهين أمام أنظار الآلاف من السوريين وعدسات التلفزيون.
حكاية لوتز
الجاسوس الآخر الذي استولى على اهتمام مائير هو وولفغانغ لوتز اليهودي الألماني الذي وصل إلى فلسطين خلال سنوات الثلاثينات من القرن العشرين.
اختاره الموساد في قائمة من المرشحين للقيام بعمليات تجسس في مصر التي دخلها بصفة ألماني شرقي كان قد خدم في صفوف القوات الألمانية في إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية ولذلك قرر العودة إلى مصر التي كان قد عرفها لممارسة العمل التجاري.
بعد عامين من النشاط التجسسي اكتشفت الأجهزة المصرية الجاسوس الإسرائيلي وحُكم عليه بالسجن ربما كي يتم تبادله مع أسرى مصريين في حالة قيام حرب. حاول أميت التمكن من إطلاق سراحه بشتى الطرق. واقترحت إسرائيل مبادلة لوتز وزوجته بجميع سجناء الحرب المصريين الموجودين في السجون الإسرائيلية.
لكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر رفض الاقتراح. فلجأ مائير أميت إلى ممارسة الضغوط النفسية. قال: «أفهمت السجناء المصريين أن بقاءهم في السجون الإسرائيلية يعود إلى رفض عبد الناصر إعادة شخصين إسرائيليين. وسُمح لهم بالكتابة إلى ذويهم، لكن هذا كله بقي دون أي صدى».
ثم تقدم أميت باقتراح آخر هو إظهار الأمر وكأنه انتصار علني للرئيس المصري من دون ذكر أية كلمة عن إطلاق سراح لوتز وزوجته.
رفض عبد الناصر هذا العرض الجديد. فلجأ الإسرائيليون إلى المسؤول عن عناصر الارتباط لدى الأمم المتحدة الذي سافر إلى القاهرة وحصل على وعد بـ «إطلاق سراح لوتز وزوجته» لاحقا. ثم بعد شهر «غادر لوتز وزوجته القاهرة إلى جنيف بأكبر قدر ممكن من السرية، وكانوا بعد ساعات في مكتبي»، كما صرّح أميت.
فهم مائير أميت سريعا أن عملاءه بحاجة إلى دعم لتنفيذ مهماتهم. هكذا شكل شبكة «سيانيم» أي المتطوعين اليهود للتعاون كل في مجاله. فمن يعمل منهم مثلا في وكالات للسفر يسهل تقديم سيارة لجواسيس الموساد من دون عراقيل؛ والمصرفي يقدم التسهيلات المالية المطلوبة؛ والطبيب قد يساهم بإخراج رصاصة من دون إعلام السلطات.
لم يكن مائير أميت يعترض، بالطبع، على محاولات التجسس لكنه كان يؤكد على ضرورة التخطيط الجيد لها. وكان قد أصرّ كذلك على إيجاد شبكة عالمية للصلات مع وسائل الإعلام التي كان يستخدمها ببراعة كبيرة.
فمثلا كان يتبع قيام أي اعتداء أو تفجير في أوروبا حدوث «تسريبات» إلى الصحافة بقصد إثارة مقالات في الاتجاه الذي يريده جهاز الموساد، بل والقيام بحملات التضليل الإعلامي إذا اقتضى الأمر ذلك.
وفي كل مرّة كان ينبغي «اختيار» أن تكون إسرائيل الهدف أو الضحية. وكان القرار يعود لاعتبارات سياسية محضة ترمي إلى تحويل الأنظار عن مناورة دبلوماسية تنوي إسرائيل القيام بها في الشرق الأوسط أو الحصول على التعاطف معها خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
بداية الانحطاط
ينقل مؤلف الكتاب عن مائير أميت قوله أن جهاز الموساد قد بدأ بالانحطاط منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في شهر نوفمبر من عام 1995، أثناء اجتماع جماهيري مؤيد للسلام.
ويؤكد أميت، أثناء لقائه مؤخرا مع المؤلف، أن المدير العام للموساد «شاباتي شافيت» كان قد أخطر المقربين من رابين بإمكانية اقتراف عملية اغتيال. وقد قال أحد هؤلاء المقرّبين أن الإنذار كان غامضا إلى درجة «لا يمكن أن ينبئ معها أنه كان هناك تهديد حقيقي».
ميدان عمل الموساد هو الخارج، وكل عميل فيه ينبغي عليه المرور في المدرسة الخاصة للجهاز الموجودة بالقرب من تل أبيب. ومن الممنوع على وسائل الإعلام الإسرائيلية الكشف عن وجودها، تحت طائلة العقاب.
وقد ثارت ضجة كبيرة في تل أبيب عام 1996 عندما أفصحت صحيفة إسرائيلية عن اسم المدير العام للموساد «داني ياتوم». طالب البعض بضرورة ايداع الصحافي السجن، وليس وحده وإنما رئيس تحرير الصحيفة معه. لكن لم يتم ذلك بعد أن لاحظ مسؤولو جهاز الموساد أنفسهم أن العديد من الصحف العالمية كانت قد نشرت اسم ياتوم. وكان رأي أميت هو:
«إن الإفصاح عن اسم مدير الموساد وهو على رأس عمله أمر خطير جدا. والجاسوسية نشاط سري غالبا وغير مريح. وليس مهماً ما يفعله جاسوس وإنما تنبغي حمايته. وتمكن معاملته بقسوة داخل الجهاز ولكن على مستوى الخارج يجب عدم المساس به بل ينبغي أن يبقى مجهولا».
كان اسم «مائير أميت» المتعارف عليه عندما كان رئيسا للموساد هو «رام». وكان على اقتناع بأنه ينبغي تحقيق مقولة «إسرائيل الكبرى». كان قد انخرط في صفوف الجيش وعمل قائدا لكتيبة مدة عامين في ظل قيادة موشي ديان.
ووصل بعد ذلك إلى مرتبة قائد عمليات الجيش، أي الشخصية الثانية في القوات المسلحة الإسرائيلية. ترك صفوف الجيش إثر خلل في عمل مظلته أثناء إحدى القفزات. فسافر إلى أميركا للدراسة في جامعة كولومبيا. وبعد عودته عرض عليه موشي ديان رئاسة الاستخبارات العسكرية، ثم خلف إيسر هاريل في رئاسة الموساد بتاريخ 25 مارس 1963.
ومائير أميت هو الذي شرع بانتهاج سياسة اغتيال أعداء الموساد. وهو الذي أقام علاقات سرية مع جهاز الكي.جي.بي السوفييتي وهو الذي زاد من إيقاع استخدام النساء في الجاسوسية وقيامهن بدور «الطعم» أحيانا، الأمر الذي لم يكن بعيدا عن ولوج العديد من الدوائر. وكان يصف دائما طريقة عمله بالقول: «هذا سر، إنه سرّي».
ترك مائير اميت إدارة جهاز الموساد عام 1968، ليعيش بعدها في أحد أحياء تل أبيب، ولا يعرف ماضيه سوى أفراد أسرته المقربين، وهو لا يزال يحرص على أن يبقى بعيدا عن الأنظار. وقد طبّق حتى بعد تركه لإدارة الموساد بسنوات طويلة نفس المبدأ الذي كان يردده وهو أن «الجاسوسية مسألة ذكاء وليست مسألة عضلات».
ويبقى خصمه الأول والأخير هم العرب. وكان مائير أميت قد غادر إدارة جهاز الموساد بكل هدوء. وفي اليوم الأخير استدعى المتعاونين معه في إدارة الجهاز وقال لهم مرّة أخيرة إذا كان العمل في الموساد يطرح عليهم إشكالية أخلاقية فما عليهم سوى أن يتركوه على الفور. كانت تلك هي آخر كلماته لهم قبل أن يصافحهم مغادراً المقر من دون عودة إليه.
كانت هناك، في الواقع، أزمة تلوح في أفق العلاقات بين الموساد وأجهزة الاستخبارات الأميركية وتهدد ذلك التحالف القائم بينهما آنذاك، وبدا أنه قد تكون لها نتائج وخيمة بالنسبة لإسرائيل.
كان في قلب تلك الأزمة أحد العملاء الذين عملوا تحت أمرة مائير أميت، وهو عميل، ليس كالآخرين، إذ نال شهرة بعد تخطيطه وتنفيذه لعملية اختطاف المسؤول النازي السابق أدولف إيخمان من الأرجنتين وإعادته إلى إسرائيل حيث حوكم وأعدم، الشخص المقصود هنا اسمه رافائيل إيتان، الشهير بـ «رافي».
أولوية إسرائيلية للتجسس العلمي والتقني على أميركا
* الحلقة الثالثة :
يجد القارئ نفسه هنا على موعد مع عمليتين من عمليات الموساد يفصلهما مدى زمني بعيد، وبالتالي فإنهما تتيحان إلقاء نظرة على تطور الأساليب التي يعمل بها والإمكانات الموضوعة تحت تصرفه، العملية الأولى هي اختطاف أدولف ايخمان في الأرجنتين والثانية هي تجنيد جوناثان بولارد والحصول من خلاله على ألوف الوثائق الأميركية ذات الأهمية البالغة التي تكشف أدق أسرار المنطقة وأكثرها حساسية.
تعلّم سكان ضاحية أفيكا في شمال تل أبيب رؤية رافائيل إيتان بنظارتيه السميكتين والأصم تماما بأذنه اليمنى وهو يحمل تحت ذراعيه أنابيب قديمة أو سلاسل دراجات صدئة أو أشياء معدنية أخرى عتيقة. وما إن يصل إلى بيته حتى يلبس بزة العمل الزرقاء ويضع على وجهه قناع السبّاكين قبل لحم المعادن أو فكّ لحامها.
كان جيرانه يتساءلون عمّا إذا لم يكن يريد بذلك الهروب من ماضيه، لاسيما وأنهم كانوا يعرفون أنه قد قام بالقتل عدة مرّات، ليس في أرض المعارك وإنما في عمليات سرّية. ولم يكن أحد من أولئك الجيران يعرف عدد الذين قتلهم أحيانا رفسا بحذائه. يقول هو نفسه: «في كل مرّة كان علي أن أقتل أحدهم، كنت أحسّ بحاجة الى النظر إليه وجها لوجه، في بياض عينيه، ثم أشعر بالارتياح والتركيز. ولا أعود أفكر إلا بما ينبغي علي عمله، وكنت أفعله، هذا كل شيء».
كان رافي إيتان خلال ربع قرن نائب مدير عمليات الموساد. لم يكن من النوع الذي يجلس وراء مكتبه كي يقرأ التقارير بينما يقوم الآخرون بالعمليات في أرض الميدان. لذلك لم يكن يترك أية مناسبة للمشاركة في أية عملية وذلك تحت شعار: «عندما لا يشارك المرء في الحل، فهذا يعني أنه يشارك في المشكلة». وكان من أهم العمليات التي قام بها وجلبت له شهرة كبيرة عملية اختطاف أدولف إيخمان، أحد كبار مسؤولي النظام النازي الألماني.
عملية إيخمان
في عام 1957 وصلت إلى الموساد معلومة تفيد أنه تم رصد أدولف إيخمان في الأرجنتين، وتمّ تكليف رافائيل إيتان بخطف النازي السابق وجلبه إلى إسرائيل. لقد زيّنوا له العملية وأفهموه أنها سوف تضع جهاز الموساد في طليعة الأجهزة السرية العالمية، إذ ربما ليس هناك أي جهاز آخر يمكن أن يفكر بمثل هذه العملية. كانت المخاطر هائلة، فإيتان سيقوم بالعملية على بعد آلاف الكيلومترات وبهوية مستعارة ومن دون أي دعم وبوسط معادي إلى حد ما فالأرجنتين كانت ملاذ النازيين، وبالتالي يمكن للفشل أن يؤدي إلى السجن، وربما إلى المقبرة.
انتظر إيتان مدة عامين كاملين قبل أن تتأكد المعلومة الأولية التي تثبت حقيقة أن الرجل الذي كان يعيش في إحدى الضواحي البورجوازية لمدينة بيونس أيريس تحت اسم ريكاردو كليمانت هو بالفعل أدولف إيخمان. تجمّد الدم في عروق رافائيل إيتان عندما أعطوه الضوء الأخضر للشروع بالعملية. فالعواقب المترتبة على العملية قد تكون شديدة الخطورة.
استأجرت شركة «العال» الإسرائيلية للطيران، طائرة إنجليزية من أجل القيام بالرحلة الطويلة إلى بيونس أيريس. يقول إيتان: «أرسلنا أحدهم إلى بريطانيا، لقد دفع المبلغ المطلوب وحصلنا على الطائرة. كانت الرحلة تنقل رسمياً وفداً إسرائيلياً للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئة والخمسين لاستقلال الأرجنتين. ولم يكن أي من أعضاء الوفد يعرف سبب وجودنا معهم، وكانوا يجهلون أيضا أننا كنا قد جهّزنا زنزانة في مؤخرة الطائرة من أجل وضع إيخمان فيها عند العودة».
وصل إيتان ورجاله إلى العاصمة الأرجنتينية في أول مايو 1960، ونزلوا في إحدى الشقق السبع التي جرى استئجارها من أجلهم، وبحيث يتم استخدام إحداها كسجن مؤقت لإيخمان قبل ترحيله. استؤجرت 12 سيارة من أجل العملية. راقب إيتان وفريقه إيخمان طيلة ثلاثة أيام وعرفوا أنه ينزل في محطة محددة من حافلة النقل العام عند زاوية شارع غاريبالدي.
وفي مساء العاشر من شهر مايو 1960 قرر إيتان الانتقال إلى التنفيذ يرافقه سائق ورجلان مكلفان بالسيطرة على إيخمان عندما يصبح داخل السيارة. كان أحد الرجلين قد تلقى تدريبا خاصا للسيطرة على الأشخاص في الشارع. وكان يُفترض أن يبقى إيتان داخل السيارة بجانب السائق و«تقديم المساعدة إذا دعت الحاجة».
تحدد موعد تنفيذ العملية في اليوم التالي. ويوم الحادي عشر من مايو وصلت سيارة الموساد إلى شارع غاريبالدي. لم يكن أحد ينبس ببنت شفة، إذ لم يكن هناك ما يقال. كانت حافلات للنقل تقف وتكمل سيرها وعند الساعة الثامنة وخمس دقائق رصدوا إيخمان في إحدى الحافلات. يقول إيتان: «بدا إيخمان متعباً (...). كان الشارع مقفراً.
وسمعت عميلنا الأخصائي بالخطف يفتح باب السيارة قليلا خلفي. وعندما وصلنا إلى محاذاة إيخمان كان يمشي بخطوات سريعة كأنه في عجلة للعودة إلى منزله وتناول طعام العشاء (...). كان مقررا أن تستمر العملية اثنتي عشرة ثانية، ينطلق أثناءها رجلنا من المقعد الخلفي ويمسك إيخمان من رقبته ثم يدفعه إلى داخل السيارة».
وقفت السيارة بمحاذاة إيخمان. استدار ونظر مندهشاً للعميل الذي انطلق من المقعد الخلفي للسيارة. لكن هذا العميل مشى فجأة على رباط حذائه المفكوك وكاد يقع على رأسه. وكاد إيخمان أن ينجو بسبب رباط حذاء مفكوك. أسرع إيخمان الخطى؛ فانطلق إيتان من السيارة. يقول: «لقد أمسكته من رقبته بقوة رأيت عينيه تجحظان بسببها. ولو أنني شددت قبضتي قليلا فلربما كنت قتلته. كان مساعدي قد وقف وفتح لي باب السيارة فدفعت إيخمان على المقعد الخلفي، وتبعه عميلنا. استمرت العملية كلها خمس ثوان».
أُدين إيخمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقبيل إعدامه في 31 مايو 1962 كان رافائيل إيتان في زنزانة تنفيذ الحكم بسجن الرملة. يقول: «نظر لي إيخمان وقال لي: سيأتي دورك أيها اليهودي!، فأجبته: ليس اليوم، ليس اليوم». وكان قد تمّ بناء فرن خاص من أجل حرق جثته؛ وألقي رماده في البحر. لقد حرص بن غوريون على أن لا يبقى أي أثر منه كي يحول دون قيام الذين يحنّون للنازية بتكريمه. نظر رافائيل إيتان يومها طويلاً إلى أمواج البحر وهو في غاية الارتياح.
مهام مختلفة
تابع رافي إيتان عمليات الاغتيال في أوروبا بواسطة القنابل التي يجري تفجيرها عن بعد، أو بواسطة مسدس «بيريتا»، السلاح المفضل بالنسبة لجهاز الموساد. وكان إيتان يقوم بعمليات القتل من دون أن يهتز له جفن. وكان في كل سفرة إلى الخارج ينتحل هوية مزورة مختلفة من بين المخزون الهائل لدى الموساد من جوازات سفر وهويات مزورة أو مسروقة. وأظهر إيتان براعة كبيرة في تجنيد المتطوعين «سيانيم» لمساعدة الموساد من بين اليهود في الخارج.
وكان يستجلبهم، كما شرح قائلا: «كنت أشرح لهم أن شعبنا قد أمضى ألفي عام وهو يحلم. وأننا صلينا نحن اليهود خلال تلك المدة كلها كي يأتي يوم الخلاص. واحتفظنا بذلك الحلم في أغانينا وكتاباتنا وقلوبنا، واليوم أصبح حقيقة. ثم كنت أضيف: كي تستمر هذه الحقيقة نحن بحاجة لأناس من أمثالكم». وفي المحصلة وجد إيتان نفسه على رأس أكثر من مائة شخص بينهم المحامي والطبيب والتاجر وربة المنزل وكلهم مستعدون لتنفيذ أوامره في مختلف أنحاء أوروبا.
حرص رافائيل إيتان على أن يبقى بعيدا عن الخصومات السياسية التي ظلّت متأججة بين الأجهزة السرية الإسرائيلية. وهكذا كان جهاز الاستخبارات الداخلية «شين بيت» وجهاز الاستخبارات العسكرية «أمان» يريدان التخلص من وصاية الموساد. لكن ما كان لموقع الموساد أن يهتز في ظل إدارة مائير أميت الذي استطاع إفشال جميع محاولات هز أسبقيته.
لكن عندما ترك أميت منصبه سعى العديد من الضباط إقناع إيتان بترشيح نفسه وأكّدوا له أنهم وراءه. لكن قبل أن يتحرك جرى تعيين زافي زامير مديراً جديداً للموساد. فاستقال إيتان وفتح مكتبا للاستشارات الأمنية.بعد عام فقط أعرب إيتان عن استعداده للعودة إلى صفوف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ذلك أنه في عام 1974 عيّن إسحق رابين المدعو إسحق هوفي على رأس الموساد وربط الجهاز الأمني بأرييل شارون مستشاره للشؤون الأمنية.
اختار شارون رافي إيتان كمساعد له. بعد ثلاث سنوات أصبح مناحيم بيغن رئيسا لوزراء إسرائيل فاختار إيتان كمستشار أمني شخصي عنده. المهمة الأولى التي حددها إيتان، في هذا الموقع الجديد، هي اغتيال أعضاء منظمة إيلول الأسود الفلسطينية. وبعد عمليات اغتيال في روما وباريس ونيقوسيا لمن اعتبرهم الموساد بين منفذي عملية ميونيخ عام 1972 التي قُتل فيها أحد عشر رياضيا إسرائيليا، حدد رافي إيتان هدفه الجديد: علي حسن سلامة الذي استطاع أن ينجو في الدقيقة الأخيرة من محاولات لاغتياله أثناء تنقله بين العديد من العواصم وقبل أن يستقر في العاصمة اللبنانية بيروت.
ذهب رافائيل إيتان إلى بيروت بصفة رجل أعمال يوناني حيث استطاع التعرف على عنوان إقامة علي حسن سلامة. عاد بعدها إلى تل أبيب وأرسل ثلاثة من عملائه إلى العاصمة اللبنانية استأجر أحدهم سيارة وقاموا بحشوها بالمتفجرات وأوقفوها في الطريق الذي يسلكه هدفهم كل يوم وهو في طريقه إلى مكتبه. وفي لحظة مروره جرى تفجيرها وقتله.
وتقديرا من مناحيم بيجن لمواهب رافائيل إيتان عيّنه مديرا لمكتب العلاقات العلمية «لاكام» الذي تأسس عام 1960 في إطار وزارة الدفاع مع مهمة محددة هي «جمع المعلومات بكل السبل الممكنة». أثار هذا المكتب عداء جهاز الموساد في البداية إذ رأى فيه منافسا وحاول مائير أميت وقبله إيسر هاريل حذفه أو «امتصاصه». لكن شيمون بيريز الذي كان نائبا لوزير الدفاع أصرّ على بقائه، بل وفتح «لاكام» مكاتب له في نيويورك وبوسطن وواشنطن ولوس أنجلوس؛ أي في الأماكن الرئيسية لتواجد التكنولوجيات المتقدمة.
وفي عام 1968 حُكم على أحد مهندسي طائرة الميراج-3 الفرنسية بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب تسليمه معطيات كافية لبناء مثل تلك الطائرة لمكتب «لاكام». وعلى أساس هذا «النجاح» في الحصول على أسرار الطائرة المقاتلة الفرنسية قبل «إيتان» تولي رئاسة المكتب المعني مع طموحه في أن يجعل منه جهازا متميّزا في عالم التجسس.
وفي الوقت نفسه أعاد الصلة من جديد مع جهازه السابق «الموساد» الذي كان قد تولّى إدارته ناحوم ادموني الذي كان، مثل إيتان، يحذر كثيرا من النوايا الأميركية حيال الشرق الأوسط، وكان يرى بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لا تقدم له سوى معلومات متواضعة.
وزاد قلق مدير الموساد الجديد بعد تلقيه تقارير من عملائه في واشنطن أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية قد التقوا بزعماء عرب قريبين من ياسر عرفات وأنه يجري البحث من أجل إرغام إسرائيل على قبول المطالب الفلسطينية. وشرح ادموني لإيتان أنه لم يعد يستطيع اعتبار الولايات المتحدة ك«حليف له مصداقيته طيلة الوقت».
بالإضافة إلى هذا وصل إلى مسامع عملاء للموساد في شهر أغسطس 1983 أن عملية يتم تحضيرها ضد القوات الأميركية العاملة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في بيروت. وكان أولئك العملاء قد رصدوا وجود شاحنة مرسيدس قد تكون مفخخة. كان ينبغي على الموساد حسب الاتفاقات المبرمة إحالة المعلومات فوراً إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
لكن أثناء اجتماع للقيادة الإسرائيلية تلقى جهاز الموساد الأمر التالي: افعلوا كل ما هو ضروري لمراقبة شاحنة المرسيدس. أمّا بالنسبة لليانكي - الجنود الأميركيين - فليس مهمتنا هي حمايتهم، ويستطيعون أن يتكفّلوا هم أنفسهم بذلك. ولا مجال لعمل أكثر من ذلك لهم».
وبتاريخ 23 أكتوبر 1983، وتحت أنظار عملاء الموساد، انطلقت الشاحنة المفخخة بسرعة وصدمت قيادة المارينز بالقرب من مطار بيروت لتقُتل 243 جندياً أميركياً في الانفجار. وينقل المؤلف عن فكتور اوستروفسكي، العميل الإسرائيلي السابق، قوله أن رد فعل الموساد كان: «لقد أرادوا دسّ أنفهم في الورطة اللبنانية، وهم يدفعون الثمن».
التجسس على أميركا
في هذا السياق، جعل رافائيل إيتان من التجسس العلمي والتكنولوجي في الولايات المتحدة هدفا له، وكانت العقبة الأولى أمامه هي إيجاد مخبر فني في موقع رفيع. بحث في قائمة «المتطوعين» لخدمة إسرائيل مجانا التي كان قد أعدّها عندما كان في الموساد، وأشاع حوله أنه مهتم بكل شخصية علمية مقيمة في الولايات المتحدة ومتعاطفة مع إسرائيل.
ولم يحصل على أية نتيجة خلال عدة أشهر. لكن في شهر أبريل عام 1984 أخبره العقيد سيللا الذي كان يدرس المعلوماتية في نيويورك، وقائد السرب الذي كان قد قصف المفاعل الذري العراقي قبل ثلاث سنوات، إنه تعرّف على المدعو جوناثان بولارد أثناء حفلة عشاء نظمها ثريّ يهودي.
كشف له بولارد يومها أنه متحمس للصهيونية من جهة، ويعمل لصالح الاستخبارات البحرية الأميركية. واستطاع سيللا أن يعرف بعد فترة وجيزة أن بولارد يعمل في المركز السرّي لمكافحة الإرهاب التابع للبحرية الأميركية والموجود في سويتلاند بولاية ماريلاند. وكان من بين مهماته تحليل الوثائق المصنفة «أسرار دفاعية» والخاصة بجميع المنظمات الإرهابية في العالم.
كان منصبا شديد الحساسية سمح لبولارد أن يطلع على أعلى مستويات السرية في إطار أجهزة الاستخبارات الأميركية. ولم يصدّق سيللا أذنيه وهو يسمع محدثه يقدم له تفاصيل دقيقة حول قضايا رفضت فيها المصالح الأميركية التعاون الوثيق مع الأجهزة الإسرائيلية. وقد أشار سيللا أنه اعتراه الشك آنذاك بأن الأمر قد يتعلق بفخ نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. لكن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي أعطاه الأوامر بتعميق الصلة مع بولارد.
تعددت لقاءات سيللا وبولارد بعد ذلك في ملاعب رياضية أو في أحد المقاهي. وفي كل مرة كان بولارد يجلب معه وثائق في غاية السرية من أجل إثبات إخلاصه، وكان سيللا يرسلها مباشرة إلى تل أبيب. كانت دهشته شديدة عندما عرف أن الموساد قد اتصل قبل عامين ببولارد ولكنه وجده «شخصية غير مستقرة».
وذات يوم قام سيللا بدعوة يوسف ياجور، الذي كان يعمل بصفة ملحق علمي في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك والتابع لمكتب «لاكام» الذي كان يديره رافائيل إيتان، لتناول طعام العشاء مع بولارد. في ذلك العشاء كرر بولارد أن الولايات المتحدة تبخل بمعلوماتها على إسرائيل لأنها تريد المحافظة على علاقات جيدة مع البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.
وفي نفس ذلك المساء اتصل يوسف ياجور، بواسطة خط هاتفي محمي من عمليات التنصت، بمعلمه رافائيل إيتان الذي طلب منه أن يعمق صلاته أكثر مع بولارد وزوجته المقبلة، آن هندرسون. هكذا تكررت دعواتهما لتناول وجبات الطعام في المطاعم الفاخرة ولحضور حفلات العروض السينمائية الخاصة للأفلام الجديدة. وبنفس الوقت كان الجاسوس الذي تمّ تجنيده يقدم لإسرائيل وثائق في غاية الأهمية والتي اولاها إيتان أهمية كبيرة ورأى أنه حان الوقت للتعرف على مصدر معلوماته الثمين الجديد.
في نوفمبر 1984 قام سيللا وياجور بتقديم هدية إلى بولارد وآن هندرسون تمثلت في رحلة إلى باريس مدفوعة التكاليف بشكل كامل. وشرح ياجور لبولارد أن هذه الرحلة كانت بمثابة «مكافأة متواضعة بالقياس إلى الخدمات الجليلة التي تقدمها لإسرائيل«. لقد سافرا إلى فرنسا بالدرجة الأولى وكان في استقبالهما بمطار باريس سائق قادهما إلى فندق البريستول الشهير حيث كان بانتظارهما رافائيل إيتان.
في نهاية اللقاء اتفق إيتان مع بولارد على أن لا تعود اللقاءات مع عملاء الموساد مجرد لقاءات صداقة وفي مناسبات وإنما أصبحت لقاءات «عمل». خرج سيللا من الصورة وأصبح ياجور هو العميل المسؤول رسميا عن جوناثان بولارد. وتمّ الاتفاق على نظام جديد لتسليم الوثائق بحيث أصبح بولارد يجلبها إلى شقّة المدعوة «ايريت ايرب»، السكرتيرة في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وحيث كانت قد وُضعت في مطبخها آلة تصوير ذات سرعة كبيرة لأخذ نسخ عن جميع تلك الوثائق وكانت زيارات بولارد لهذه السكرتيرة تتعاقب مع مروره إلى عدة مغاسل للسيارات، حيث كانت سيارته بصدد الغسيل آليا،
كان يعطي الوثائق التي بحوزته سرا ليوسف ياجور الذي تكون سيارته أيضا بصدد الغسيل في الآلة المجاورة. وكان ياجور قد زوّد سيارته بآلة تصوير مخفية تحت المقود. بكل الحالات كانت شقة ايريت ومغاسل السيارات قريبة من مطار واشنطن مما كان يسهّل انتقال ياجور بين العاصمة الفيدرالية ونيوروك. وما إن كان يصل إلى القنصلية حتى يبعث ما لديه من وثائق عبر «فاكس محمي» إلى تل أبيب.
تجاوزت المعلومات المحصلة توقعات رافائيل إيتان إذ وصلته ذات يوم معلومات مفصّلة عن آخر الأسلحة التي قامت روسيا بتزويد سوريا بها مع تحديد دقيق لمواقع صواريخ اس.اس-21 وسي.آ-5، وكذلك خرائط وصور للترسانات العسكرية السورية والعراقية والإيرانية، بما في ذلك صور مصانع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وفضلاً عن الحساسية الكبرى للمعلومات المحصّلة توضحت أيضا بالنسبة لإيتان طرق التجسس التي تتبعها الأجهزة السرية الأميركية في الشرق الأوسط ولكن أيضا في جنوب إفريقيا. وكان بولارد قد سلّم للإسرائيليين تقريراً أعدّته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن البنية الكاملة لشبكة جواسيسها في تلك البلاد ـ جنوب إفريقيا.
كذلك سلّمهم وثيقة أخرى تشرح بأدق التفاصيل كيف قامت جنوب إفريقيا بأول تفجير ذرّي يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر 1979 في جنوب المحيط الهندي. لكن حكومة بريتوريا نفت باستمرار امتلاكها للقدرة النووية. وتصرّف رافائيل إيتان بطريقة قام من خلالها عملاء الموساد بتسليم حكومة جنوب إفريقيا جميع الوثائق الأميركية التي تخصّها، مما أدّى إلى تفكيك كامل مباشر لشبكة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فيها. وتوجب أن يغادر 12 عميلا البلاد بأقصى سرعة ممكنة.
سقوط بولارد
قام جوناثان بولارد خلال الأحد عشر شهرا التالية بتسليم الإسرائيليين أخطر المعلومات التي جمعتها الأجهزة السرية الأميركية. وتمّ هكذا تحويل أكثر من ألف وثيقة «سرّية للغاية« إلى إسرائيل، حيث كان رافائيل إيتان يدقق فيها بإعجاب قبل أن يسلمها بدوره إلى إدارة جهاز الموساد. وبالاعتماد على المعلومات المجمّعة قام ناحوم ادموني مدير الموساد بتقديم توصيات إلى الحكومة الائتلافية التي كان يتولى رئاستها آنذاك شيمون بيريز حول أفضل طريقة للتصرف حيال السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
وينقل المؤلف عن محضر للاجتماعات الوزارية الإسرائيلية آنذاك ما يلي: «عندما يتم الاستماع إلى ناحوم ادموني، يسود تقريبا الشعور أن المرء يجلس مع الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. ولم نكن على اطلاع فوري بآخر الأفكار التي تنبثق في واشنطن حيال القضايا التي تهمنا من قريب أو بعيد فحسب، ولكن كان لدينا أيضا الوقت من أجل التأمل والتفكير قبل اتخاذ أي قرار.
أصبح جوناثان بولارد عنصراً حاسماً في السياسة الإسرائيلية وفي اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وقام إيتان بتزويده بجواز سفر إسرائيلي تحت اسم داني كوهين وقرر له مرتباً شهرياً كبيراً. بالمقابل طلب منه معلومات وتفاصيل إضافية عن نشاطات التجسس الإلكتروني لوكالة الأمن القومي في إسرائيل وعن طرق التنصّت المستخدمة حيال السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وعلى البعثات الدبلوماسية الأخرى للدولة العبرية في الولايات المتحدة الأميركية.
لم يتمكن بولارد من تزويده بالمعلومات المطلوبة إذ جرى اعتقاله بتاريخ 21 نوفمبر 1985 أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبعد عدة ساعات فقط كان يوسف ياجور والعقيد سيللا والسكرتيرة ايريت ايرب في الطائرة بالطريق إلى إسرائيل قبل أن يسائلهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. أما بولارد فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد وصدر على زوجته حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
أطلق مؤتمر المنظمات اليهودية بالاشتراك مع أكثر من خمسين مجموعة أخرى في عام 1999 حملة مكثفة لإطلاق سراح بولارد. وروّج اللوبي اليهودي لفكرة تقول أنه لم يقترف جريمة الخيانة العظمى حيال الولايات المتحدة «ذلك أن إسرائيل كانت آنذاك ولا تزال اليوم حليفا قريبا». ودعمت المنظمات اليهودية الدينية تلك الحملة. وصرّح أستاذ القانون في جامعة هارفارد الان م. ديرشفيتز محامي بولارد أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الجاسوس قد مس «قدرة أجهزة استخبارات الأمة» أو «نشر معطيات حولها على الصعيد العالمي.
في مواجهة تلك الحملة المسيّرة من إسرائيل عرفت أجهزة الاستخبارات الأميركية مبادرة غير مسبوقة إذ خرج عدد من أعضائها إلى النور وحاولوا إثبات خيانة بولارد. وأدّى هذا إلى تعبئة أكبر من اللوبي اليهودي القوي. وخشيت الأجهزة السرية الأميركية أن يقوم بيل كلنتون في إحدى أزماته الدونكيخوتية، حسب تعبير أحد ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بإطلاق سراح بولارد قبل نهاية ولايته الرئاسية.
وقال جورج تينيت، رئيس الوكالة آنذاك، لكلينتون: «إن إطلاق سراح بولارد سيثبط من عزيمة الأجهزة السرية». وهذا ما أجاب عليه كلنتون بالقول «سنرى، سنرى».كان رافائيل إيتان يراقب كل ما يجري حول قضية بولارد بانتباه كبير لكنه كان مشغولا أيضا بقضية أخرى أكثر أهمية وتخص الملف النووي الإسرائيلي.
الإسرائيليون يخدعون المفتشين الأميركيين في صحراء النقب
*الحلقة الرابعة :
ينتقل المؤلف هنا إلى موضوعين على جانب كبير من الأهمية، أولهما مساهمة الموساد في تحويل مفاعل ديمونة من مشروع يحظى بحماس ديفيد بن غوريون إلى أمر واقع، والثاني توظيف عملاء الموساد للاغتيال كأداة للحركة السياسية، بما في ذلك اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير والمناضل فتحي الشقاقي والعالم الكندي جيرالد بول ومحاولة أغتيال خالد مشعل، ثم يفتح المؤلف الباب أمام حشد من علامات الاستفهام حول اغتيال اسحق رابين، تثير الشكوك في الرواية الرسمية لمقتل رابين.
شاعت لسنوات طويلة مقولة أن إسرائيل لديها ما وصف بأنه «أفضل جيش نظامي» في منطقة الشرق الأوسط. ولكن لم يكن ديفيد بن غوريون مكتفيا بذلك، وإنما أصدر الأوامر ببناء مفاعل ذري في صحراء النقب بالقرب من ديمونة.عمل في ذلك المفاعل 2500 عالم وتقني. وصمم المهندسون منشأة على عمق 25 متراً تحت الأرض لوضع المفاعل في قلب مختبر هائل «ماخون-2». ويقوم عمل هذا المختبر على نظام فصل وإعادة معالجة المواد المشعّة، وكان قد جرى استيراده من فرنسا تحت تسمية رسمية هي «آلات لصناعة النسيج».
لم يكن مفاعل ديمونة وحده كافياً لتزويد إسرائيل بالقنبلة النووية، بل كان لابد من توفير المادة الانشطارية، أي اليورانيوم المخصّب أو البلوتونيوم. لكن القوى النووية القليلة آنذاك وقّعت معاهدة التزمت من خلالها بعدم تزويد أي بلد بغرام واحد من المواد القابلة للانشطار التي كان مفاعل ديمونة بدونها منشأة غير عملية.بعد ثلاثة أشهر من نصب المفاعل ف1تحت مؤسسة صغيرة لإعادة معالجة المواد المشعّة أبوابها في معمل قديم للحديد في ابوللو ببنسلفانيا.
حملت هذه المؤسسة اسم شركة نوميك للمواد النووية وتجهيزاتها. كان مديرها العام هو سلمان شابيرو الذي كان اسمه على القوائم التي أعدّها رافائيل إيتان لليهود الأميركيين الأكثر نفوذا في المجال العلمي، كما كان اسمه موجودا على قائمة دافعي الأموال «الأكثر كرماً» لإسرائيل. كان ذلك إذن هو المدخل إلى الصناعة النووية الأميركية عن طريق شابيرو هذا، ابن الحاخام، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة جون هوبكنز.
لم يبد أن الإدارة الأميركية كانت متحمسة آنذاك لحصول إسرائيل على السلاح النووي. وينقل المؤلف أن رسالة وجهها الرئيس الأميركي جون كنيدي في فبراير 1961 إلى دافيد بن غوريون يطلب فيها وضع مفاعل ديمونة في خطط التفتيش المنتظمة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما اعتبره بن غوريون بمثابة «ضغط أميركي» بل وقال: «إن وجود كاثوليكي في البيت الأبيض ليس أمرا جيدا بالنسبة لإسرائيل». وطلب بن غوريون بعدها مساعدة رجل يثق به في واشنطن هو أبراهام فينبيرغ، الصهيوني المتزمت والمؤيد للتطلعات النووية لإسرائيل.
كان فينبيرغ من أغنى اليهود في الحزب الديمقراطي. ولم يكن يخفى القول أنه إذا كان قد تبرع بمليون دولار لحزب كنيدي، فإنما كان ذلك من أجل الدفاع عن قضايا إسرائيل في الكونغرس. وكانت طريقته المفضلة في العمل هي ممارسة الضغط السياسي المباشر، وقد قال صراحة لكنيدي عندما كان مرشحا: «نحن مستعدون لدفع قيمة فواتيرك إذا تركتنا نشرف على سياستك في منطقة الشرق الأوسط»، يومها اكتفى كنيدي بوعد «منح إسرائيل جميع التنازلات الممكنة».
فدفع فينبيرغ 000 500 دولار ك«بداية». كان العرض واضحا وهو أنه إذا كان الرئيس الأميركي يصر على متابعة المطالبة بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمفاعل «ديمونة» فإنه «عليه أن لا يعتمد على الدعم المالي لليهود خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة». ووجد فينبيرغ دعما مهما لدى وزير الخارجية الأميركي آنذاك روبت مكنمارا الذي قال للرئيس أنه يتفهم «رغبة إسرائيل في امتلاك القنبلة الذرية».
أصرّ كنيدي على موقفه وتوجب على بن غوريون قبول مبدأ القيام بجولة تفتيشية. لكن كنيدي قدّم في الدقيقة الأخيرة تنازلين مهمين. فمقابل السماح بالدخول إلى مفاعل ديمونة تقوم الولايات المتحدة ببيع الدولة العبرية صواريخ أرض ـ جو من طراز هاواك. أي سلاح الدفاع الأميركي الأكثر كفاءة في عصره. ثم إن عملية التفتيش لن تجري من قبل تقنيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنما من قبل فريق أميركي حصرا وبعد برمجة الزيارة بعدة أسابيع مقدّما.
لقد خدع الإسرائيليون المفتشين الأميركيين وبنوا فوق مفاعل ديمونة الحقيقي مركزا للمراقبة كي يدفعوا أولئك المفتشين للاعتقاد أن الأمر يتعلق فعلا بمفاعل يرمي إلى تحويل صحراء النقب إلى فردوس أخضر. أمّا القسم الذي كان يتم تزويده ب«الماء الثقيل» الآتي من فرنسا والنرويج فلم يسمحوا بتفتيشه ل«أسباب أمنية». وكان يكفي للتقنيين أن يلقوا نظرة على محتوى الأوعية كي يفهموا ما فيها. وعندما وصل الأميركيون اكتشف الإسرائيليون أنه ليس فيهم من يتحدث اللغة العبرية، مما كان يقلل من حظوظ إمكانية اكتشافهم للأهداف الحقيقية لمفاعل «ديمونة».
في تلك الأثناء وافقت السلطات الأميركية على طلب تقدّمت به السفارة الإسرائيلية في واشنطن للجنة الطاقة الذرية من أجل السماح ل«مجموعة من العلماء بزيارة شركة نوميك من أجل أن يفهموا بشكل أفضل أسباب قلق المفتشين الأميركيين في ميدان معالجة النفايات النووية». ومع الموافقة على ذلك الطلب أخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ما ينبغي للمراقبة ولمعرفة إذا كان سلمان شابيرو، رئيس الشركة، يتعاون أولا مع الأجهزة السرية الإسرائيلية.
قرر رافائيل إيتان أن يقوم هو شخصيا بزيارة شركة نوميك برفقة فريق يضم عالمين كانا يعملان في مفاعل ديمونة كاختصاصيين في معالجة النفايات المشعة. كانت مهمة هذين العالمين هي إيجاد السبل لسرقة المادة القابلة للانشطار من شركة نوميك. كان رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يراقبون عن قرب الزيارة. وبدا أن تقارير المكتب تحمل الكثير من الشكوك فيما يتعلق بما كان يعرفه شابيرو عن الأسباب الحقيقية لزيارة رافائيل إيتان وأصحابه.
وأشار أحد تلك التقارير بعد شهر من تلك الزيارة إلى أن شركة نوميك قد وقعت عقد شراكة مع الحكومة الإسرائيلية من أجل تطوير «عمليات تعقيم الأطعمة والعينات الطبية بواسطة الإشعاع». بل وأشار تقرير آخر إلى «التحذير الملصق على الحاويات المعدنيّة والذي يدل على وجود مواد مشعّة خطيرة». ثم أضاف: «بسبب هذا التحذير لم يرد أحد فتح تلك الحاويات لتفحص ما بداخلها، ومنعونا نحن من عمل ذلك».
كانت السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد أفهمت وزارة الخارجية الأميركية أن أية محاولة لفتح حاوية من الحاويات سيترتب عليه وضعها في مصاف الحقيبة الدبلوماسية التي لا يحق للسلطات في بلدان التمثيل الدبلوماسي فتحها. هكذا وباسم الحصانة رأى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الحاويات التي يجري تحميلها في طائرة شحن تابعة لشركة العال الإسرائيلية أمام أعينهم دون أن يستطيعوا فعل أي شيء.
أحصى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تسع إرساليات تمّت بتلك الطريقة خلال الأشهر الستة التي تلت زيارة رافائيل إيتان لشركة سلمان شابيرو. ورأى المسؤولون عن المكتب أن كمية كافية من المواد الانشطارية لصناعة قنبلة ذرية قد وصلت إلى مفاعل ديمونة . نفى شابيرو أن يكون قد زوّد إسرائيل بأية مواد منها، لكن مكتب التحقيقات وجد «عجز» في كمية المواد الانشطارية التي تعاد معاملتها في شركته. قال شابيرو ان ضياع اليورانيوم يعود إلى «تسربه داخل الأرض« أو «تبخره في الهواء». مثّلت الكمية المفقودة 50 كيلوغراماً ولم يتم توجيه أية تهمة لشابيرو. لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن إسرائيل كانت بطريقها إلى تصنيع السلاح النووي.
الهدف أبو جهاد
ينقل مؤلف هذا الكتاب عن عميل أمضى ربع قرن من حياته في خدمة الموساد قوله: «كان لي الحق في أن أكذب لأن الحقيقة لم تكن تشكل جزءا من علاقتي مع الناس. كان هناك شيء واحد يهمني هو أن أستخدمهم لصالح إسرائيل». على هذا الأساس تربّى عملاء الموساد الذين كانوا يستهلون نشاطاتهم التجسسية في مهمات بالخارج. أما عدد عملاء الموساد فهو غير معروف، لكن عميل سابق للموساد هو فكتور اوستروفسكي كتب عام 1991 أن عددهم هو «حوالي 000 35 شخص في مختلف أنحاء العالم بينهم 000 20 يقومون بعمليات و000 15 نائمون، لا يقومون بأي نشاط» بينما يقوم العاملون بكل أنواع العمليات وفي مقدمتها التجسس والاغتيال.
وفي عام 1988 تولى إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، شخصيا عملية تخطيط وتنفيذ اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير، أبو جهاد. لقد قام عملاء الموساد طيلة شهرين بالرقابة المستمرة للفيلا التي كان يسكنها في ضاحية سيدي بوسعيد بالقرب من مدينة تونس. لقد راقبوا وعاينوا كل شيء من المداخل وعلو السور المحيط بها والمواد المتكون منها والنوافذ والأبواب والأقفال ووسائل الدفاع ومكان وجود الحرّاس الشخصيين ومسار حركتهم.
لقد راقبوا كل شيء وبأدق التفاصيل. وتلصصوا كذلك على زوجة أبوجهاد عندما كانت تلعب مع الأطفال وتبعوها عندما كانت تذهب للتسوق أو إلى صالون الحلاقة. والتقطوا الاتصالات الهاتفية التي كان يقوم بها زوجها. وحسبوا المسافة بين الغرف ودرسوا ساعات ذهاب وإياب الجيران وسجّلوا أرقام السيارات التي كانت تتردد إلى المنزل وأنواعها وألوانها. لقد طبّق القتلة القاعدة التي كان قد أرساها مائير أميت «عندما كان رئيسا لجهاز الموساد والقائلة إنه أثناء عمليات الاغتيال «ينبغي التفكير مثلما يفكر الهدف وعدم التوقف عند التشابه معه إلى اللحظة التي يتم فيها الضغط على الزناد».
كان عملاء الموساد قد خططوا لمهمتهم السوداء خلال شهر كامل في موقع للموساد في حيفا، وبتاريخ 16 أبريل 1988 أُعطي الضوء الأخضر للانطلاق بالعملية. وفي تلك الليلة أقلعت عدة طائرات إسرائيلية من طراز بوينغ 707 من قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب. وكان في الأولى إسحاق رابين وعدد من كبار الضباط الإسرائيليين.
كانوا على اتصال دائم مع فريق القتلة الذين أخذوا مواقعهم بالقرب من الفيللا التي كان يسكنها أبوجهاد وأسرته. قاد العملية عميل اسمه المستعار هو «سورد». وكانت الطائرة الثانية محشوة بآلات الالتقاط والتنصت والتشويش. أما الطائرتان الأخريتان فقد كانتا للدعم اللوجستي والتزويد بالوقود.
كانت الطائرات كلها تدور على ارتفاع عالي جدا فوق «فيللا» أبوجهاد في ضاحية سيدي بو سعيد قرب تونس وكانت على اتصال مع فريق سورد على الأرض بواسطة تردد لا سلكي خاص. وبعد منتصف ليلة 17 أبريل بقليل علم إسحق رابين ومن معه أن أبوجهاد قد عاد إلى منزله. بل أكد «سورد» أنه يسمع وقع خطوات القائد الفلسطيني وهو يصعد الدرج إلى الطابق الثاني حيث توجد زوجته ثم توجه إلى الغرفة المجاورة كي يقبل ابنه النائم ثم عاد إلى الطابق الأول حيث يوجد مكتبه.
وبعد 17 دقيقة من منتصف ليلة 17 أبريل 1988 أعطى إسحاق رابين الضوء الأخضر للشروع بعملية الاغتيال. كان سائق أبوجهاد ينام داخل سيارة المرسيدس خارج المنزل حيث كان الهدف الأول لأحد العملاء الذي أطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كاتم للصوت. ثم قام سورد وقاتل آخر بوضع عبوة ناسفة تحت البوابة الحديدية للفيللا.
اقتلعت هذه العبوة المتفجرة الجديدة المسماة «صامتة» البوابة دون أن تحدث أية ضجة تذكر. بعد ولوج المنزل قاما بقتل الحارسين الشخصيين، ثم دخل سورد إلى مكتب أبوجهاد الذي كان بصدد مشاهدة شريط فيديو يخص منظمة التحرير الفلسطينية. همّ أبوجهاد بالوقوف فأطلق عليه سورد رصاصتين استهدفتا صدره.
ثم اتجه القاتل نحو الباب للخروج فوجد بمواجهته أم جهاد فصرخ بوجهها باللغة العربية: ادخلي إلى غرفتك. كان ابنها بين ذراعيها. ثم «تبخر» سورد وفريق القتلة الذي رافقه وسط الظلام. استغرقت العملية ثلاث عشرة ثانية. لاقى اغتيال أبوجهاد صدى عالميا كبيرا بل ينقل المؤلف عن عزرا وايزمان، الوزير الإسرائيلي قوله: «ليس باغتيال الناس يمكن لمسيرة السلام أن تتقدم».
المسلسل يتسارع
لكن مسلسل الاغتيالات لم يتوقف، بل تسارع إيقاعه إلى هذا الحد أو ذاك. ذات مساء من أكتوبر 1995 جرى اجتماع على مستوى القيادة الإسرائيلية، وتحدد فيه الهدف الفلسطيني المقبل المطلوب اغتياله، لقد كان فتحي الشقاقي، المرجعية الدينية لتنظيم الجهاد الإسلامي. كان يومها في دمشق، وعلى أهبة التوجه إلى ليبيا. وكان يُفترض أن يمضي في طريق عودته يوما في جزيرة مالطة.
وكان «شابتاي شافيت» قد أرسل في آخر عملية له كرئيس للموساد، عميلا أسود» - كما يطلق على المخبرين من العرب في أوساط الموساد ـ إلى دمشق. وكانت مهمته هي تنشيط الرقابة الإلكترونية على منزل زعيم الجهاد الإسلامي وذلك بمساعدة أجهزة أميركية جديدة من الأكثر تقدما وذلك للتمكن من التنصت على منظومة الاتصالات التي كان يستخدمها وهي من صنع روسي. وبواسطة عمليات التنصت جرت معرفة تفاصيل رحلة فتحي الشقاقي إلى ليبيا عبر مالطة. وبالتالي لم يكن من الصعب التحضير لعملية اغتياله وتنفيذها.
فبتاريخ 24 أكتوبر 1995 سافر عميلان من جهاز الموساد إلى روما. وعند وصولهما إلى المطارين سلمهما عملاء محللون جواز سفر بريطانياً جديداً لكل منهما. ثم توجها إلى مالطة ونزلا عند وصولهما في غرفتين بفندق ديبلومات على مرفأ فاليتا. استأجر أحدهما دراجة نارية للاطلاع على معالم الجزيرة، كما قال. ولم ير أي عامل من عمال الفندق العميلين الإسرائيليين وهما يتبادلان الحديث. وعندما أشار أحد خدم الفندق لأحدهما أن حقيبته ثقيلة الوزن أجابه بغمزة عين أنها تحتوي على سبائك ذهبية.
في المساء نفسه أخطرت سفينة شحن إسرائيلية السلطات المالطية أنها تتجه إلى إيطاليا ولكنها أصيبت بعطل فني سيرغمها على البقاء في عرض البحر بمواجهة الجزيرة بانتظار القيام بإصلاح الخطأ الطارئ. كان على متن تلك السفينة شابتاي شافيت، مدير جهاز الموساد مع فريق من التقنيين المختصين بمجال الاتصالات. هكذا تم تبادل المعلومات بين الموجودين على السفينة وبين العميلين اللذين كان ثقل حقيبة أحدهما يعود إلى وجود جهاز إرسال بداخلها.
وفي الفندق نفسه قام فتحي الشقاقي بحجز غرفة له. وفي صباح اليوم التالي أطلق عليه عميلا الموساد عدة رصاصات، بعد أن كانا قد أوقفا الدراجة المستأجرة بمحاذاته وهو في طريقه للمطار عائدا إلى دمشق. بعد ساعة واحدة فقط من عملية الاغتيال انطلق من مرفأ فاليتا قارب صغير وعندما وصل إلى محاذاة سفينة الشحن الإسرائيلية «المعطلة» أخبر قبطانها السلطات المالطية أنه قد جرى إصلاح الخلل الميكانيكي «مؤقتا» ولذلك ينبغي عدم إكمال الطريق إلى إيطاليا والعودة إلى حيفا لإجراء عملية صيانة كاملة.
بعد عدة أيام فقط من اغتيال فتحي الشقاقي اغتيل إسحاق رابين، ذلك «الصقر» الذي تحول إلى «حمامة». لقد قتله يهودي متشدد اسمه إيغال أمير، وفي موقع ليس بعيدا عن مقر الموساد.لم يقتصر عملاء الموساد على استهداف القيادات الفلسطينية وإنما استهدفوا أولا الذين اعتبروهم في صفوف أعدائهم. كانت تلك هي حالة الدكتور «جيرالد بول»، العالم الكندي والخبير المعروف عالميا في ميدان صناعة المدافع.
كانت إسرائيل قد حاولت مرّات عديدة استمالته للتعاون معها لكنه رفض ذلك باستمرار، بل وقبل التعاون مع نظام صدام حسين من أجل تزويده بمدفع هائل يبلغ طوله 148 مترا ويزن 32 طنا من الأنابيب الفولاذية القادمة من شركات بريطانية. وأسس بول لهذا الغرض شركة في بروكسل ببلجيكا. جعل عملاء الموساد في هذه البلاد من التجسس على نشاطات الشركة إحدى مهامهم الرئيسية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك هو إسحاق شامير ذو الكفاءات العالية في عمليات الاغتيال المخططة منذ أن كان عضوا فاعلا في جماعة «الهاجاناه» التي مارست الكثير من العمليات الإرهابية في فلسطين قبل قيام الدولة العبرية. وأصدر شامير تعليمات لناحوم ادموني، مدير الموساد، باغتيال العالم الكندي .
بعد يومين من ذلك القرار وصل عميلان للموساد إلى بروكسل قادمين من تل أبيب، واستقبلهما عميل مقيم. كان يراقب تحركات «بول» منذ أسابيع. وفي 22 مارس 1990 توجّه العملاء الثلاثة إلى حيث كان يقطن هدفهم والذي أصبح ضحيتهم في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه. كان عمره آنذاك 61 سنة.
أكّد «مايكل» ابن العالم الكندي مرارا بعد ذلك أن والده كان على اقتناع تام أن عملاء الموساد يلاحقونه، لكن ما إن عاد القتلة الثلاثة إلى تل أبيب حتى بدأت إدارة الحرب النفسية في جهاز الموساد بنشر إشاعات، استخدمت فيها وسائل الإعلام، مفادها أن جيرالد بول قد اغتيل لأنه أراد أن يضع حدا لتعاونه مع نظام صدام حسين.
استهداف مشعل
لكن إذا كان شامير قد وسّع من دائرة الاغتيالات فإن بنيامين نتانياهو حدد أعداءه الرئيسيين الذين ينبغي قتلهم في قادة حركة حماس وينقل عنه المؤلف، كما قال عضو مهم في الأجهزة السرية الإسرائيلية، تصريحه: «أريد رأس هؤلاء الحاقدين في حماس، ولو كلّفني ذلك منصبي». ويضيف المسؤول في جهاز الموساد: «كان نتانياهو يريد نتائج فورية مثلما هو الأمر في ألعاب الفيديو أو في أفلام المغامرات القديمة التي يعشقها».
وكان الهدف الأول الذي حدده الموساد هو خالد مشعل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس والذي كان عملاء الموساد في العاصمة الأردنية عمّان قد حددوا وجوده منذ فترة. قال نتانياهو على الفور: هيا ابعثوا إلى عمّان «من يصفّي حسابه«. ذلك دون أن يأبه أبدا لما يمكن لمثل تلك العملية أن تجلبه من تدهور في العلاقات مع الأردن بعد أن كان سابقه «رابين» قد نجح في إقامتها مع الملك حسين. هذا بالإضافة إلى ما قد يحرم إسرائيل من معلومات مهمة حول سوريا والعراق.
جرى سرّا تحضير فريق كوماندوز من ثمانية عملاء للموساد. كانت المهمة محددة لكل منهم بحيث يعود الجميع بعد تنفيذ الاغتيال عبر جسر «اللنبي» بالقرب من القدس. وكان السلاح المستخدم غير اعتيادي، أي ليس مسدسا كاتما للصوت، وإنما كان غازا ساما. كانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل ذلك السلاح من قبل الموساد، حيث كان علماء روس هاجروا إلى إسرائيل وراء تصنيعه.
وفي 24 سبتمبر 1997 وصل أعضاء فريق الدعم إلى عمان من أثينا وروما وباريس حيث كانوا قد أمضوا عدة أيام واستلموا جوازات سفر كمواطنين في تلك البلدان، بينما كان القاتلان المكلّفان بتنفيذ خطة الاغتيال يحملان جوازات سفر كندية ، وكانا قد شرحا للعاملين في فندق «انتركونتيننتال» أنهما قد جاءا بقصد السياحة، أما أعضاء فريق الدعم فقد نزلوا في السفارة الإسرائيلية غير البعيدة.
في اليوم التالي قام القاتلان باستئجار سيارتين بواسطة موظفي الاستقبال في الفندق بزعم أنما سيقومان برحلة إلى جنوب البلاد. كان ذلك عند الساعة التاسعة، وعند الساعة العاشرة كان خالد مشعل في طريقه إلى مكتبه. كان يركب قرب سائقه بينما كان ثلاثة من أطفاله يجلسون في المقعد الخلفي. وعندما وصلت السيارة إلى منطقة الحدائق أنذر السائق خالد مشعل بأنهم ملاحقون. قام مشعل فورا بالاتصال مع الشرطة وأعطاهم رقم سيارة عميلي الموساد. لكن رجال الشرطة أخبروه بعد دقائق أن السيارة المعنية مستأجرة من قبل «سائح كندي».
قام خالد مشعل بتقبيل أطفاله الثلاثة قبل النزول من السيارة أمام مكتبه كي يتابعوا هم طريقهم إلى المدرسة برفقة السائق. كان القاتلان ينتظران مع حشد أمام مكتب حماس في شارع وصفي التل. تقدم أحدهما نحو مشعل ورشّ الغاز القاتل في وجهه. ثم هرب مباشرة باتجاه السيارة التي كانت تنتظر. لكنهما لم يستطيعا الفرار إذ انطلقت عدة سيارات وراء سيارة القاتلين، وأخبر أحدهم الشرطة كي تغلق طرق الحي.
حاولت سيارة ثانية تابعة لفريق الدعم الإسرائيلي التدخل وتهريب القاتلين، لكن إحدى السيارات اعترضت طريقها وأحاط رجال مسلحون فجأة بعملاء الموساد وأرغموا القاتلين على الانبطاح أرضا. وصلت الشرطة في الحال أيضا بينما نقلت سيارة إسعاف خالد مشعل إلى أحد المستشفيات. اقتيد القاتلان إلى مركز الشرطة حيث أبرزا جوازي سفريهما الكنديين وأكّدا أنهما ضحية «مؤامرة كبيرة». لكن رئيس جهاز مكافحة الجاسوسية الأردني وضع حدا ل«مهزلتهما» وأخبرهما أنه يعرف من هما.
وقد صرّح فيما بعد قائلا إن المسؤول المحلّي للموساد «أفرغ ما في جعبته واعترف أن الرجلين تابعين له وأن إسرائيل سوف تفاوض مباشرة مع الملك حسين». وينقل المؤلف عن أحد عملاء الموساد قوله عن اتصال هاتفي جرى بين الملك الأردني ونتانياهو: «لم يطرح الملك حسين على نتانياهو سوى سؤالين. بماذا يلعب؟ وهل يمتلك دواء ناجعا ضد الغاز السام المستخدم»؟. أراد نتانياهو أن ينكر في البداية كل شيء، لكنه لم يكن يعرف أن عميليه قد اعترفا بكل شيء أمام عدسة الكاميرا وأن شريطا مسجلا كان بطريقه إلى واشنطن».
سقوط الرواية الرسمية
إثر الفشل الذريع الذي عرفته تلك العملية استقال «داني ياتوم» مدير جهاز الموساد من منصبه في شهر فبراير من عام 1998، ولم يبعث له بنيامين نتانياهو الرسالة التقليدية التي تعوّد رؤساء الوزراء الإسرائيليون إرسالها إلى مدريري الموساد عند مغادرتهم الوظيفة من أجل «شكرهم على الخدمات التي قدّموها».
وكانت مواقع «ياتوم» قد اهتزت منذ اغتيال إسحق رابين، خاصة بعد أن قام الصحافي «باري شاميش» بتحقيق شخصي اعتمد فيه على تقارير طبية وعلى شهادات العديد من الحرّاس الشخصيين لرابين؛ ثم نشر في عام 1999 نتائج تحقيقه على شبكة الانترنت. وكانت تلك النتائج تشابه إلى حد كبير ما كان قد تمّ التوصل إليه من نتائج بعد مقتل الرئيس الأميركي جون كنيدي عام 1963.
وجاء في نتائج تحقيق شاميش قوله: «إن نظرية القاتل المعزول التي قبلت بها اللجنة الحكومية حول اغتيال رابين تخفي ما ربما كان محاولة اغتيال فاشلة ترمي إلى إنعاش الشعبية المترنحة لإسحاق رابين لدى الناخبين. لقد قبل إيغال أمير أن يلعب دور القاتل تنفيذا لتعليمات مسؤوله في الأجهزة السرية الإسرائيلية».
وأضاف: «لقد أطلق أمير رصاصة خلّبية لا تقتل. وقد أطلق رصاصة واحدة وليس ثلاث رصاصات كما أُعلن. وأظهر فحص مختبرات الشرطة على غلاف الرصاصة الذي وجدوه في مكان وقوع الجريمة أنه لا يتناسب مع صفات السلاح الذي استخدمه أمير. ولم يكن هناك من شاهد رابين وهو ينزف دما .
وسرّ آخر هو: كيف أضاعت السيارة التي أقلّت رابين إلى المستشفى ما بين ثمانية إلى اثنتي عشر دقيقة بينما كان يُفترض ألا يستغرق نقله سوى 45 ثانية عبر الشوارع المقفرة حيث كانت الشرطة قد منعت السير من أجل الاجتماع الشعبي لنصرة السلام الذي كان رابين يشارك به؟».
لكن يبقى السر الأكثر خطورة فيما قال به شاميش هو التالي: «خلال ذلك المسار الغريب الذي سلكه سائق مدرّب إلى المستشفى أُصيب رابين برصاصتين حقيقيتين انطلقتا من مسدس حارسه الشخصي يورام روبين. هذا السلاح اختفى في المستشفى ولم يعثر له على أثر بعد ذلك. وظلّت الرصاصتان اللتان تمّ استخراجهما من جسد إسحاق رابين مفقودتين مدة إحدى عشرة ساعة. ثم انتحر حارسه روبين بعد ذلك«.
لم تكن النتائج التي توصل لها شاميش هي وحدها التي ألقت الشكوك حول الرواية الرسمية لمقتل رابين؛ بل إن شهادات «تحت القسم» أكّدت «أن شيئا ما خطيرا قد حدث وله مواصفات المؤامرة». أما أمير نفسه فقد قال للمحكمة أثناء قراءة قرار الاتهام: «إذا قلت الحقيقة، فإن النظام كله سينهار، ولدي ما يكفي كي أبيد هذه البلاد».
ما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو أن شاميش ليس «مأخوذا بفكرة المؤامرات« بل إنه متعقل عامة فيما يكتب.
هكذا ألقى الموساد شباكه على فانونو في روما
* الحلقة الخامسة :
لا تزال العديد من علامات الاستفهام تدور حول قصة التقني النووي الإسرائيلي مردخاي فانونو وكشفه إنتاج إسرائيل للقنابل النووية، قبل اختطافه من أوروبا وإيداعه السجون الإسرائيلية، والغموض نفسه سيلف مصير روبرت ماكسويل الذي لقي مصرعه في عرض البحر، لكن غموضاً أشد سيفرض نفسه عندما يتعلق الأمر بمحاولة الموساد مد الجسور إلى مدينة الفاتيكان.
ردخاي فانونو هو يهودي مغربي من مواليد 13 أكتوبر 1954 في مراكش، حيث كان أهله يملكون متجراً صغيراً. هاجرت أسرته إلى إسرائيل عام 1963 وأقامت في بئر السبع بالنقب، أمضى خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ووصل إلى رتبة رقيب في صفوف وحدة لنزع الألغام كانت منتشرة في هضبة الجولان.
في صيف عام 1986، بعد تسريحه من الجيش وفشله في دراسة الفيزياء بالجامعة، تم قبوله كموظف في مفاعل ديمونة. ثم جرى تسريحه من هذا العمل، حيث حمل ملفه الأمني العبارة التالية:
«له أفكار موالية للعرب وفوضوية». غادر إسرائيل إلى أستراليا عام 1986 وهو يحمل حقيبة سفر على ظهره، ووصل إلى سيدني في صيف العام التالي. وأجمعت التقارير التي وصلت عنه لمدير الموساد، ادموني، أنه لم يقم أية صداقات أثناء وجوده في ديمونة وكان يمضي وقته منعزلا في منزله وهو يقرأ كتب السياسة والفلسفة. أشار علماء النفس في جهاز الموساد إلى أن مثل هذه الشخص يمكن أن يكون خطيراً أو متهوراً.
تعرّف فانونو في سيدني على الصحافي الكولومبي أوسكار جيريريو الذي أكد لأصحابه أنه يعرف عالماً نووياً إسرائيلياً هو بصدد أن يكشف للعالم بالتفاصيل الخطط النووية الإسرائيلية الإستراتيجية، وأنه بالتالي يحضر «سبق القرن الصحافي». لم تعجب تلك التصريحات الملتهبة فانونو الذي كان مؤيدا حقيقيا للسلام ويتمنى نشر قصته في صحيفة جدّية من أجل إنذار العالم حيال التهديد الذي تمثله إسرائيل.
لكن كان جيريرو قد سبق واتصل بمجلة «صانداي تايمز» اللندنية الأسبوعية التي أوفدت أحد صحافييها إلى سيدني من أجل إجراء مقابلة مع فانونو. وقد أصرّ هذا الصحافي على اصطحاب الإسرائيلي إلى لندن من أجل مواجهة أقواله مع آراء أحد كبار الاختصاصيين النوويين في بريطانيا.
كان فانونو يمتلك في الواقع ستين صورة مأخوذة داخل مختبر ماخون-2 في مفاعل الديمونة بالإضافة إلى مخططات ورسوم ومذكرات، أي ما يكشف على أن إسرائيل قد أصبحت قوة نووية حقيقية.
حاول جيرورو بعد أيام من سفر فانونو إلى لندن نشر صور بعض الوثائق التي كان قد حصل عليها وصورها، لكن الصحف الأسترالية رفضت بحجة أنها وثائق مزوّرة. فسافر الصحافي الكولومبي مقتفيا آثار فانونو في لندن، وقدّم ما لديه من صور لصحيفة «صاندي ميرور» مرفقة بصورة لفانونو كان قد التقطها له في أستراليا.
بعد ساعات فقط استطاع نيكولا ديفيس، رئيس التحرير، العثور على فانونو والصحافي في مجلة «صانداي تايمز» برفقته. قام بإخطار ماكسويل، صاحب إمبراطورية الصحافة البريطانية، الذي اتصل بدوره هاتفيا في الحال برئيس الموساد «ادموني».
ألغام نووية للجولان
أخدت صحيفة «الصنداي تايمز» قصة فانونو على محمل الجد، وبدأ الإسرائيليون يفكرون بالرد، وأوفد الموساد إلى لندن أحد الذين تعوّد الاعتماد عليهم في الأزمات الصعبة المدعو آري بن ميناش، الذي روى فيما بعد للصحافي الأميركي سيمور هيرش ما يلي:
«نجح نيكولا ديفيس بإقناع جيريرو بلقاء صحافي أميركي - بن ميناش - وعرض الصحافي الكولومبي أثناء اللقاء عدة صور كان فانونو قد التقطها. كان لا بد من أن يقوم الخبراء الإسرائيليون بتفحصها. فشرحت له أنني بحاجة لنسخة عنها لمعرفة قيمتها قبل الدفع».
أرسلت النسخ المسلّمة فورا إلى إسرائيل حيث أكد عدد من الرسميين العاملين في مفاعل الديمونة أنها تخص فعلا مختبر ماخون-2. وكانت إحدى الصور تبيّن القاعة التي جرى فيها تصنيع الألغام النووية التي كان يفترض وضعها في الجولان على الحدود السورية. وبالتالي لم يكن هناك أي مجال للتشكيك بمصداقية فانونو، ويكفي لأي فيزيائي نووي أن يحدد بلحظة عين عمل منشأة من هذا الطراز.
استدعى شيمون بيريز، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، كبار المسؤولين في الحكومة والموساد لمعالجة الأزمة. كان المطلوب أولا معرفة كيف حصل فانونو على الصور وهل كان وحده أم مع آخرين. وفي لندن فهمت «الصنداي تايمز» أن إسرائيل مستعدة لفعل أي شيء من أجل نزع مصداقية فانونو، ولذلك واجهته مع الدكتور فرانك بارنابي، الخبير النووي فوق الشبهات، الذي أكّد صحة صور ووثائق التقني الإسرائيلي.
التقى بن ميناش من جديد مع ماكسويل الذي قال له بوضوح إنه يعرف ما ينبغي عمله وأنه قد تحدث مع مدير الموساد. وفي اليوم التالي نشرت في «الصنداي ميرور» صورة كبيرة لمردخاي فانونو مرفقة بمقال أثار جنون فانونو والصحافي الكولومبي - الذي وصفه المقال أنه كذّاب ومحتال- ووصف اتهاماتهما أنها مجرد هراء مبتذل، كان ماكسويل هو الذي أملى المقال وأشرف على مكان نشر صورة فانونو. كانت حملة التضليل الإعلامي قد انطلقت.
بعد نشر المقال تمت تعبئة جميع المتعاونين مع الموساد في لندن للبحث عن مكان فانونو. وتلقى العشرات من المتطوعين اليهود قوائم الفنادق المطلوب الاتصال بها.
وفي كل مرة كان المتحدّث يطلب من العاملين في الفندق إذا كان بين النزلاء أحد بمواصفات فانونو - كما نشرتها المجلة البريطانية- لأنه من أقاربه ويرغب اللقاء به. وبتاريخ 25 سبتمبر وصل إلى علم ادموني أنه قد جرى تحديد مكان تواجده. وبالتالي ينبغي الانتقال إلى المرحلة التالية.
أقدم مهنتين
من المعروف أن العلاقة بين التجسس والجنس قديمة قدم الجاسوسية نفسها، إنهما أقدم مهنتين في التاريخ. وجهاز الموساد يعرف جيدا استخدام الجنس كطعم، وهذا ما عبّر عنه مائير أميت بالقول: «إنه سلاح فعّال. فالمرأة تملك مواصفات لا يمتلكها الرجل. إنها تعرف كيف تستمع. والأسرار تصل إلى أذنيها بشكل طبيعي.
ثم إن تاريخ الاستخبارات الحديثة زاخر بقصص النساء اللواتي استخدمن سحرهن من أجل خدمة بلادهن.. لكن نساءنا شجاعات ويعرفن مخاطر ذلك. وهذا العمل يتطلب شجاعة خاصة، إذ ليس المقصود هو مضاجعة رجل وإنما أن يُدخل في روعه استعداد المرأة لفعل ذلك إذا قدّم لها بعض الأسرار».
اختار ناحوم ادموني كطعم يجذب فانونو شيريل بن توف ابنة أسرة يهودية غنية في أورلاندو بفلوريدا. كان أبواها قد طلّقا فمالت هي إلى التدين وقدمت إلى إسرائيل حيث تزوجت من أوفر بن توف الذي يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ويوم العرس تحدث معها أحد ضباط الموساد عن المستقبل وانتهت عميلة له.
كان قد تمّ تحديد مكان وجود فانونو وكان عليها أن تجذبه إلى خارج بريطانيا. لقد قدّمت نفسها له كسائحة أميركية تقوم برحلة في أوروبا بعد قصة طلاق مؤلمة. ووصفت قصة طلاق والدتها ووالدها على أنها قصتها الشخصية ثم أضافت أن لها أختا في روما، كما زعمت. كان الهدف النهائي لمهمتها هو أن تجذب فانونو إلى العاصمة الإيطالية.
وفي 23 سبتمبر 1986 انضمت إلى فريق من تسعة عملاء كانوا يعملون في لندن تحت أمرة مدير عمليات الموساد بيني زيفي. حذّر صحافيو «الصنداي تايمز» فانونو من أن اللقاء مع الأميركية الجميلة يبدو صدفة مدروسة وليس عفوية.
كان قلبه قد مال لها ولم يعد يسمع صوت العقل، إذ أصرّ على الاتفاق معها على لقاء بعيد عن الأنظار في روما وفي منزل «أختها».
وصل «بيني زيفي» وأربعة آخرون من عملاء الموساد على نفس الرحلة من لندن إلى روما برفقة شيريل وفانونو. استقل الاثنان سيارة أجرة للذهاب إلى شقة في روما حيث كان ينتظرهم ثلاثة من عملاء الموساد. لقد قيدوا فانونو وزرقوه بمادة مشلّة. وصلت في الليل سيارة إسعاف لنقل «المريض» واخترقت روما باتجاه الجنوب حيث كان طراد ينتظر فانونو كي ينقله إلى حيفا.
بقي فانونو إحدى عشرة سنة في زنزانة منفردة حتى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. كانت ظروف اعتقاله شديدة الصعوبة، لكن إسرائيل خففت منها عام 1998 أمام ضغط دولي قوي ودافعت عنه منظمة العفو الدولية واسهبت الصاندي تايمز بالحديث عن وضعه المؤلم خاصة أنه لم يتقاض منها أي مبلغ مقابل السبق الصحافي الذي سلمه لها.
الخلاص من ماكسويل
في لندن هدد روبرت ماكسويل، كما فعل غالبا في الماضي، بأنه سيقدم شكوى قضائية ضد كل من يتجرأ ويعيد ما كتبه الصحافي بن ميناش من أقوال ضده. ولم يتجرأ أي ناشر بريطاني أن يتحدى صاحب إمبراطورية الصحافة ولم تمتلك أية صحيفة شجاعة أن تطلب من صحافييها استقراء الاتهامات الموجودة في الكتاب.
كان ماكسويل، مثل بن ميناش سابقا، على اقتناع بأنه محمي لسبب بسيط أنه كان «يطير» لحساب الموساد. ولم يكن يتردد في تكرار القول أنه كان هو أيضا يعرف «مكان وجود الجثث»، وكان جهاز الموساد يدرك تماما ماذا يريد قوله.
ما يؤكده المؤلف هو أن روبرت ماكسويل، الذي كان قد صرف من الخدمة أحد الصحافيين العاملين معه لأنه بالغ قليلا في فاتورة مصاريفه، كان هو نفسه يختلس سراً أموال هؤلاء العاملين كي يساعد أصدقاءه في الموساد.
وكان هو شخصيا الذي ينظم عملية السرقة تلك عبر مجموعة من عمليات التزوير المالية وعبر المرور بعدة بنوك وصولا إلى حساب خاص للموساد في بنك إسرائيل بتل أبيب. لذلك كان يتم الاحتفاء بماكسويل في إسرائيل وكأنه رئيس دولة.
لكن الموساد، وعلى قاعدة معرفته بالشهية الجنسية لدى «إمبراطور» الصحافة البريطانية، كان يقدم له في كل مرة عاهرة مدفوعة الأجر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مع الاحتفاظ بأشرطة فيديو ل«الابتزاز» إذا دعت الضرورة.
وكان عميل الموساد السابق ما بين 1984 و1986 فكتور أوستروفسكي، اليهودي المولود في كندا، قد كشف حقيقة أن «الموساد قد موّل العديد من العمليات في أوروبا من الأموال التي اختلسها ماكسويل من مرتبات موظفيه».
وما أكّده اوستروفسكي، وآخرون، هو أن الموساد رأى بعد سنوات من الخدمات والأموال التي قدمها روبير ماكسويل له ولإسرائيل انه قد أصبح خارج إطار السيطرة بل و«خطير».
وذلك في الوقت الذي كانت مصلحة الضرائب قد بدأت بتحقيقات حول سلوكه المالي مع موظفيه، كما كان البرلمان ووسائل الإعلام قد اعتبروا أن هناك علامات استفهام حول ثروته.
وأدّى هذا كله إلى تعرضه لأزمة مالية حقيقية فطالب الموساد بأن يعيد له مبالغ كان قد «أقرضها» له وإلا فقد يكشف عن اللقاء الذي جرى في يخته ببحر الأدرياتيكي بين رئيس الموساد «ادموني» وفلاديمير كريشكوف، الرئيس السابق لجهاز كي.جي.بي السوفييتي لحبك مؤامرة ضد غورباتشوف.
وكان الموساد قد وعده باستخدام نفوذه لدى الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية للاعتراف ب«النظام الجديد» في روسيا في حالة نجاح الانقلاب - الذي فشل- وبالمقابل وعد كريشكوف بتسهيل هجرة جميع اليهود في الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل.
في تلك اللحظة، وكما يؤكد أوستروفسكي «اجتمع الجناح اليميني في الموساد في إطار لجنة مصغّرة وقرر الخلاص من ماكسويل». وإذا كان هذا التأكيد دقيقا - لم تكذبه إسرائيل أبدا بشكل قاطع- فإنه لا يبدو من المعقول أن تتصرف تلك «اللجنة المصغّرة» من دون موافقة أعلى المستويات، بل ربما الموافقة الشخصية لرئيس الوزراء آنذاك إسحق شامير.
وزاد من تعقيد الأمر نشر كتاب في ذلك السياق للصحافي الأميركي سيمور هيرش عن «إسرائيل وأميركا القنبلة»، والذي تعرض لموضوع دخول إسرائيل إلى نادي القوى النووية. وقد قدّم هيرش العديد من البراهين على وجود روابط جديدة بين ماكسويل والموساد وخاصة الطريقة التي غطت فيها مجموعة «الميرور» قضية فانونو.
ويؤكد اوستروفسكي أن خطة الموساد للخلاص من ماكسويل كانت تتعلق بقدرته على جذبه بعيدا عن بريطانيا حيث يمكن لعملاء الموساد أن يضربوا ضربتهم.
وبتاريخ 29 أكتوبر 1991 تلقى ماكسويل اتصالا هاتفيا من عميل للموساد في السفارة الإسرائيلية بمدريد يدعوه فيها للقدوم إلى إسبانيا في اليوم التالي ووعده بإيجاد تسوية. وطلب منه التوجه إلى جبل طارق ثم يأخذ يخته ويأمر قبطانه بالتوجه نحو جزر الكاناري و«ينتظر رسالة».
وقد اقترف ماكسويل خطأ قبول الدعوة.
وفي 30 أكتوبر وصل أربعة إسرائيليين إلى مرفأ الرباط في المغرب وقدّموا أنفسهم كسائحين من هواة الصيد البحري. هكذا استأجروا مركبا لمواجهة أمواج الأطلسي واتجهوا صوب جزر الكاناري.
وفي 31 أكتوبر، بعد رسو اليخت في مرفأ سانتا كروز، تناول «إمبراطور» الصحافة البريطانية طعام العشاء وحيدا في فندق «مينسي». وعندما انتهى اقترب منه رجل لفترة قصيرة، لم تُعرف هويته ولا ما قال له. لكن ماكسويل عاد مباشرة إلى اليخت وطلب من قبطانه أن يرفع المرساة. وبقي المركب في البحر طيلة ستة وثلاثين ساعة بعيدا عن الشاطئ.
كتبت مجلة «بزنس ايج» البريطانية تحت عنوان «كيف ولماذا اغتيل روبير ماكسويل» إن قاتلين قد صعدا إلى اليخت بعد أن وصلا إليه بواسطة قارب مطاطي بمحرك. ووجدا ماكسويل على ظهر اليخت فقيّداه و«وحقنه أحدهما بفقاعة هواء مات بعدها خلال عدة ثوان فقط». وحددت المجلة القول إن جثته قد ألقيت بعد ذلك في البحر ولم يتم اكتشافها إلا بعد إحدى عشرة ساعة مما أخفى آثار الحقن.
جسور إلى الفاتيكان
إن مؤلف هذا الكتاب يتوقف طويلا عند علاقة الموساد بالفاتيكان، ويؤكد بداية أن جميع رؤساء وزراء إسرائيل أبدوا إعجابهم الكبير بمفهوم البابوية، وذلك على اعتبار أن البابا يمثل سلطة روحانية وسياسية لا تقدم حسابا لأحد وليست خاضعة لمساءلة أية سلطة قضائية أو تشريعية. ثم إن الفاتيكان هو عالم محاط بالسرية التي تحكم آليات عملها من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا.
وكان رؤساء الموساد جميعهم قد تساءلوا عن كيفية التمكن من رفع الغطاء عن هذا العالم «المجهول»، لكن جميع المحاولات التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية والأجهزة السرية لإقامة علاقات جيدة مع الفاتيكان باءت بالفشل.
وبقيت السياسة الخارجية للحبر الأعظم تتحدث عن «الأراضي المحتلة» في الضفة الغربية وقطاع غزّة وعن هضبة الجولان باعتبارها أرضاً سورية ضمّتها إسرائيل. وكان الكرادلة والقساوسة يتحفظون في تصريحاتهم حول هذا الموضوع على خلفية اعتقادهم أن إسرائيل قد نشرت جواسيسها في كل مكان من أجل رصد حركاتهم وسكناتهم.
لكن الأمر تغيّر بعد وصول يوحنا بولس الثاني إلى منصب البابوية عام 1978 وأصبحت لإسرائيل مكانة دبلوماسية حقيقية في الفاتيكان. وكان سابقه بولس السادس قد استقبل غولدا مائير عام 1973 دون أن يؤدي ذلك إلى تغير جوهري في سياسة الفاتيكان التي استمرت بالمطالبة في قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفي ظل رئاسة رونالد ريغان للولايات المتحدة الأميركية تعززت كثيرا العلاقات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والبابا يوحنا بولس الثاني وتكررت زيارات «وليم كيسي» رئيس الوكالة آنذاك، إلى الفاتيكان. وقد عبّر ريتشارد آلن الكاثوليكي والمستشار الأول للأمن القومي لدى رونالد ريغان عن قوة تلك العلاقة بالقول:
«ترمز العلاقات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والبابا إلى أحد أروع التحالفات في جميع الأزمنة. وكان ريغان على اقتناع كبير بأنهما، هو والبابا، سيغيران وجه العالم». وفي الوقت نفسه لم تنس وكالة الاستخبارات المركزية أن تضع أجهزة للالتقاط والتنصت في مكاتب كرادلة وقساوسة أميركا الوسطى المؤيدين لما سمي ب«لاهوت التحرير».
طلب ناحوم ادموني، مدير الموساد، من صديقه الكسندر هيغ، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، تزويده بنسخة عن الدراسة النفسية التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للبابا يوحنا بولس الثاني.
لقد ركزت الصورة (النفسية) المرسومة له على أنه ورع جدا دينيا لكنه شديد الغضب أحيانا ويمكن أن يفقد برودة أعصابه، ويتحلّى بحس جيوسياسي كبير وقد يحصل ويكون متشددا مثل أي دكتاتور. وينتهي التقرير الأميركي إلى القول أن يوحنا بولس الثاني «ضليع جدا في ميدان السياسة ويرغب في لعب دور على الصعيد العالمي».
توصل ادموني وقيادة الموساد إلى الاقتناع بأن الاستخبارات الأميركية قد أقنعت البابا بأن محاولة اغتياله من قبل التركي محمد علي أقجا بتاريخ 13 مايو 1981 كان من تدبير السوفييت. فقرر الإسرائيليون لعب ورقة «فرّق تسد» وذلك عبر تقديم رواية أخرى لمحاولة اغتيال البابا وأن إيران كانت وراءها».
جوازات السفر المفقودة
لكن تبقى أوروبا إحدى ساحات النشاط الرئيسي لعملاء الموساد إلى جانب الولايات المتحدة. وذات يوم من أيام يوليو 1986 عثروا على كيس بلاستيكي في إحدى مقصورات الهاتف بشارع في مدينة بون الألمانية.
لحظته دورية للشرطة فوقفت لمعرفة ما فيه. لقد وجدت ثمانية جوازات سفر بريطانية غير مستخدمة جرى تسليمها للسفارة البريطانية. حامت الشكوك حول الفلسطينيين والجيش الجمهوري الإيرلندي لكن جهاز مكافحة الجاسوسية البريطاني ركّز شكوكه على جهاز واحد يمكنه أن يصنع بمثل تلك الدقة جوازات السفر التي تبيّن أنها مزورة، وهو جهاز الموساد.
نفى ناحوم ادموني ذلك وأشار إلى إمكانية أن تكون الأجهزة السرية الألمانية الشرقية - ستازي- قد شرعت ببيع جوازات سفر مزوّرة لليهود الراغبين في السفر إلى إسرائيل، مع ذلك «كان ادموني يعرف جيدا أن تلك الجوازات كانت من صنع مزوري الموساد وأنه كان مفترض منحها لعملائه من أجل تسهيل دخولهم وخروجهم من بريطانيا».
وذلك رغم «التفاهم» الذي كان قد تمّ الوصول إليه بين الموساد والاستخبارات الخارجية البريطانية ونصّ على إطلاع البريطانيين على كل العمليات الإسرائيلية في بريطانيا.
ولم يتردد الموساد في إدخال بعض عملائه سرا إلى لندن في أفق القيام بعمليات اغتيال للفلسطينيين وكبح الجهود التي كان ياسر عرفات يقوم بها من أجل ربط صلات مع حكومة مرجريت تاتشر التي كانت «بدأت بالاقتناع شيئا فشيئا أن الرجل كان قادرا على المساهمة في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يعترف بنفس الوقت بالحق المشروع للشعب الفلسطيني بأرضه وبحق الأمن بالنسبة لإسرائيل».
رأى شيمون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أن قضية جوازات السفر المزورة تلك قد تخرّب العلاقات مع حكومة تاتشر وقال إنه من الأفضل لعب ورقة الصراحة إذ «بمقدار ما يتم الاعتراف مبكرا بالخطأ يمكن تسوية الأمور بسرعة».
رفض ادموني الفكرة، ذلك أنها ستقود جهاز مكافحة الجاسوسية وسكوتلانديارد إلى التحقيق حول نشاطات الموساد في بريطانيا. وقد يؤدي ذلك إلى الكشف عن عميل سري كان يرى به الموساد «منجما للمعلومات». هذا فضلا عن الاعتراف أن الموساد مؤهل للقيام بمثل تلك الأعمال المشبوهة.
كانت تلك الجوازات مرسلة للسفارة الإسرائيلية في بون وكان يحملها عميل مبتدئ ولا يعرف العاصمة الألمانية جيدا. بعد الدوران كثيرا في الشارع دخل إلى المقصورة الهاتفية لإخطار السفارة الإسرائيلية أنه قد ضلّ العنوان تماما، ونسي هناك الجوازات. كلّفت تلك القضية ناحوم ادموني منصبه إلى جانب قضية الجاسوس اليهودي الأميركي جوناثان بولارد خلفه في إدارة الموساد «شابتاي شافيت» وورث عنه عواقب الفشل.
لم تشهد فترة «شافيت» على رأس الموساد الكثير من «الإنجازات» وذات يوم من ربيع عام 1996 استدعاه بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء آنذاك، إلى مكتبه وقال له باختصار إنه «معزول»، وعندما سأله من سيخلفه؟ أجاب: داني ياتوم.
كان ياتوم هذا صديقا حميما لبنيامين نتانياهو منذ فترة طويلة لكن علاقتهما تدهورت عندما فشلت محاولة اغتيال أحد قادة حماس الرئيسيين، أي خالد مشعل.
وزادت العلاقة سوءاً بعدما تكشّف في عام 1997 أن أحد ضباط الموساد الكبار «يهودا جيل» الذي كان يعمل في الجهاز منذ 20 سنة قد «اخترع» تقريرا مختلقا من ألفه إلى يائه بالاعتماد على جاسوس «وهمي» موجود في دمشق حول استعداد سورية للهجوم على إسرائيل، وحيث تقاضى ذلك الضابط أموالا طائلة من «الصندوق الأسود» للموساد بناء على وظيفة وتقرير مزورين.
لكن بالمقابل وجّه الموساد نشاطاته صوب إفريقيا، حيث قدّم معلومات للمتمردين في زائير بقيادة لوران ديزيري كابيلا لقلب نظام موبوتو، وعزز علاقاته مع الأجهزة السرية في جنوب إفريقيا، وفي أميركا نجح بإيصال أحد عملائه إلى أعلى دوائر إدارة كلنتون.
كما كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. لكن هذا كله لم يمنع من عزل داني ياتوم من إدارة الموساد ليخلفه «افراييم هاليفي» يوم 5 مارس 1998. وتحول ياتوم مباشرة للعمل في ميدان صناعة السلاح الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه الذي عيّن فيه نتانياهو افراييم هاليفي مديرا للموساد أصدر قرارا آخر هو ان نائبه اميرام لوفين سيخلفه في 3 مارس 2000. كانت تلك هي المرّة الأولى في تاريخ الموساد التي يتم فيها تعيين مدير لمدة محددة كي يخلفه بعد ذلك نائبه.
داجان لمساعديه: اقتلوا بكل الوسائل وفي جميع الاتجاهات
• الحلقة السادسة و«الأخيرة» :
مع ختام هذا الكتاب يضع مؤلفه يدنا على ثلاثة موضوعات رئيسية أولها استمرار جهود التجسس الإسرائيلية على أميركا بعد سقوط الجاسوس جوناثان بولارد، وثانيها مؤشرات تورط الموساد في مصرع الأميرة ديانا.
وثالثها وأكثرها أهمية دور الموساد في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده ليصل في الختام إلى طرح مجموعة بالغة الاهمية من علامات الاستفهام التي لا تزال تنتظر الإجابة عنها واجه العالم وجميع الأجهزة السرية واقعا جديدا بعد أكبر عملية تفجيرات يوم 11 سبتمبر 2001.
يقول مؤلف هذا الكتاب إنه على الرغم من الأطنان من المقالات والكم الكبير من الكتب المكرّسة لهذا الحدث في جميع أنحاء المعمورة يبقى هناك سؤال لا يزال من دون إجابة وهو: «ماذا كان يعرف الموساد قبل الأحداث التي أدت إلى تدمير برجي التجارة الدولية في واشنطن وانهيار البنتاغون جزئيا؟».
ويضيف: «إن بعض الضباط الكبار الذين كانوا يعملون في قسم العمليات بقيادة الموساد كانوا قادرين على الإجابة بعد مرور عام». ويشير المؤلف أنه قبل ثلاث سنوات من تفجيرات 11 سبتمبر 2001 أعدّت لجنة بقيادة نائب الرئيس الأميركي آنذاك آل غور تقريرا طالبت فيه بزيادة سريعة في الميزانية المكرّسة لأمن المطارات.
ويؤكد في هذا السياق أن جهاز الموساد قدّم العديد من المعلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والجهات الحكومية الأميركية لكن جرى إهمالها من قبل إدارة بيل كلنتون وخلفه جورج دبليو بوش.
أُثيرت أسئلة كثيرة بعد 11 سبتمبر حول أسباب قلّة عدد جواسيس الاستخبارات الأميركية في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط؟ ولماذا التركيز فقط على الرقابة الإلكترونية؟
ومن المعروف أن وكالة الأمن القومي الأميركي هي أقوى جهاز للتجسس في العالم، إذ أنها تستطيع انطلاقا من مقرها الرئيسي في ولاية ماريلاند التجسس على جميع المكالمات الهاتفية في العالم بواسطة أجهزة الكترونية متقدمة جدا.
وحواسيبها الضخمة تسجل أسماء المشبوهين والكلمات الحساسة وأرقام الهواتف والعناوين الإلكترونية في العالم. ويتم بعد ذلك تحضير «قوائم مراقبة» مشفّرة يتم إرسالها عبر خطوط هاتفية محميّة إلى جميع هيئات الاستخبارات الأميركية.
لا أحد يعرف بالدقة كلفة عملية المراقبة هذه، لكن الكل يجمع على أنها تتجاوز عدة مليارات من الدولارات كل سنة. وتتمثل نقطة الضعف الكبيرة لهذا النظام في عدم الإلمام الكامل بمختلف اللغات في العالم.
ولا يكفي في نهاية المطاف إعداد قوائم وإنما ينبغي أيضا معرفة حل ألغازها. والإنسان وحده قد يكون قادرا على فهم أي حديث داخل سياقه ويعرف أدق التفاصيل التي قد تخفي حتى على أكثر أنظمة الرقابة الإلكترونية تقدما.
مغامرات طلبة الفن
في 9 مايو 2001 اقترب شابان بسيارتهما من موقع حراسة زتولك فيلدس، إحدى القواعد الجوية التابعة للحرس الجوي الوطني الأميركي، والتي كانت تضم داخلها متحفا صغيرا للطيران. كان حشد كبير من الزائرين بأتي كل عام لزيارة هذا المتحف.
وعندما طلب الحرس من الشابين إبراز هويتهما الشخصية أخرجا جوازي سفر إسرائيليين. وقدّما نفسيهما على أنهما طالبان في دراسة الفنون بجامعة القدس. سُمح لهما بالدخول لكن ضُبطا وهما يصوران الطائرات وقالا عندما جرى توقيفهما أنهما كانا يجهلان أن التصوير كان ممنوعا.
أرسلت القيادة العسكرية للمنطقة تقريرا لوزارة الدفاع الأميركية التي أرسلته بدورها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كانت المفاجأة كبيرة عندما عُلم أن «طلابا» إسرائيليين يدرسون «الفن» قد قاموا بأعمال شبيهة في العديد من الولايات الأميركية الأخرى.
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من السفارة الأميركية في إسرائيل التحقق من حكاية «طلبة الفن» هؤلاء، وكانت الإجابة هي أن «جامعة القدس» غير موجودة أصلا، وأقرب هيئة علمية منها قد تكون الجامعة العبرية، ولكن أسماء «الطلبة» المعنيين ليست موجودة في قوائمها. واكتشف الأميركيون، بعد التحقيق، أن الهواتف النقالة التي كانت مع «الطلبة» اشتراها دبلوماسي إسرائيلي في واشنطن قبل أن يعود إلى تل أبيب.
اتصل جورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بأفراييم هاليفي، مدير الموساد مستوضحا، فأكد له الإسرائيلي أنه ليس هناك أية عمليات جارية آنذاك. «لقد كان يكذب».
كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب، إذ كانت تلك العملية من بنات أفكاره. وأن «طلبة الفنون» لم يكونوا سوى طلبة في السنة الأخيرة من مركز تدريب الموساد كان قد جرى اختيارهم للقيام بمهمات في الولايات المتحدة الأميركية. ولم تكن تلك هي المرّة الأولى التي يتم فيها إرسال طلبة للتدرب على مثل تلك المهمات.
جرت تسريبات للصحافة، وكانت المقالات الأولى بعيدة تماما عن الواقع إذ أجرى الحديث عن «طلبة في الفن قدموا من الشرق الأوسط» وأنهم «يتحدثون اللغة العربية»، بل وجرى التأكيد أنهم ينتمون إلى «منظمة إرهابية مجهولة». وكان صحافي التحقيقات المعروف كارل كاميرون هو أول من أشار إلى أن جهاز الموساد قد يكون وراء تلك العملية.
لقد تحدث هذا الصحافي عن ذلك عبر قناة فوكس نيوز الأميركية وجوبه مباشرة بحملة عنيفة من اللوبي اليهودي في واشنطن وعلى رأسه لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية ذات الباع الطويل لدى الكونجرس وفي أوساط الاستخبارات وحتى لدى البيت الأبيض.
وعندما أطلقوا الرشقة الأولى على كاميرون أكّد في مقال آخر أن العديد من الإسرائيليين قد أخفقوا عندما تعرضوا لجهاز الكشف عن الكذب عندما سئلوا عن احتمال مراقبة النشاطات الأميركية.
وكتبت صحيفة «لوموند» في باريس أن شبكة واسعة للتجسس الإسرائيلي جرى الكشف عنها في الولايات المتحدة، وهي أكبر عملية من هذا النوع منذ عام 1985 عندما ضُبط جوناثان بولارد وهو يبيع معلومات سرية للغاية إلى جهاز الموساد.
ضاعف اللوبي اليهودي في أميركا من شراسته. ووجه اليكس سافيان، أحد مدراء لجنة دقة المقالات حول الشرق الأوسط في أميركا، الموالية لإسرائيل، للصحافي كاميرون تهمة أن له مشكلة شخصية حيال إسرائيل. فهو ترعرع في الشرق الأوسط (...). ومن الممكن أن يكون متعاطفا مع العرب.
فأجاب كاميرون: لقد عشت وترعرعت في إيران خلال عدة سنوات ذلك أن أبي كان يعمل في حقل الآثار. فهل هذا يجعل مني مناهضا لإسرائيل؟. كانت في الواقع تلك هي المرّة الأولى التي يجد كاميرون نفسه متهما بالتحيّز في أحد تحقيقاته.
وجاء على لسان مايكل ليند، أحد أهم أعضاء المؤسسة الأميركية الجديدة - هي مختبر للأفكار- ورئيس التحرير السابق لصحيفة ناشيونال انتيرست قوله: عندما يتعلق الأمر بضباط متخصصين في الشؤون الخارجية أو بتطبيق القانون أو بمسائل عسكرية، يبدو أنه من المستحيل المساس بإسرائيل من دون التعرض للتشهير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل القول بالموالاة للعرب.
وأخيرا، عندما كان طلبة الفن في طائرة تابعة لشركة العال تقلهم في طريق العودة إلى تل أبيب، اختفى كل أثر للتحقيق الذي قام به كارل كاميرون من موقع الانترنت التابع لقناة فوكس نيوز الأميركية.
ووضع مكانه تنبيها يقول إن هذه القضية قد حظر الإطلاع عليها، وصرح ناطق رسمي باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لقد طوينا الصفحة حول هذا التحقيق. وبعد فترة قصيرة أقصى أفراييم هاليفي عن إدارة الموساد.
تحذير لأميرة القلوب
كان هاليفي قد ترك ذكرى أخرى مثيرة من فترة إدارته للموساد، إذ كان قد قرر إعادة دراسة ملف وفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد في باريس. وبعد قراءته للملف الأول للموساد حول الحادث طلب من موريس العميل الإسرائيلي الذي شارك في تجنيد هنري بول، سائق السيارة التي تعرّضت للحادث القاتل، تقديم محضر عن اليوم الأخير لديانا ودودي.
ويؤكد الذين قرأوا هذا المحضر الجديد أنه يحتوي على العديد من الأقوال الدقيقة الجديدة بالقياس إلى الملف الأصلي للموساد؛ مثل القول أن محمد الفايد، والد عماد - دودي- كان مسكونا باستمرار بفكرة أن ديانا كانت حاملاً وأن المخابرات الأميركية والبريطانية والفرنسية كانت تراقب الثنائي العاشق منذ وصولهما إلى باريس.
ويشير المحضر أيضا إلى عدة محادثات هاتفية تضمنت احداها إنذارا من الحارس الشخصي لديانا، العامل سابقا في سكوتلانديارد، يقول لها انتبهي. ويركز تقرير موريس الجديد كثيرا على سيارة الفيات اونو البيضاء التي كانت تقف بالقرب من فندق ريتز.
وقد أكّد عدد من المصوّرين الصحافيين بعد ذلك أنها كانت تعود لجيمس اندرسون الذي تخصص بالتقاط صور لديانا وكسب من ذلك ثروة كبيرة. لكن موريس يؤكد أن اندرسون لم يكن موجودا تلك الليلة.
ويتحدث موريس عن سيارة فيات اونو بيضاء لاحقت بجنون السيارة المرسيدس التي كان يستقلها دودي وديانا ويقودها بول هنري. وبعد فترة من الحادث عُثر على سيارة من الطراز نفسه في مرآب لتصليح السيارات في باريس وقد أُعيد دهنها منذ فترة وجيزة باللون الأزرق.
وعندما كشطوا الدهان اكتشفوا أن لونها في الأصل هو الأبيض. لكن لم يذهب رجال الشرطة بعيدا في التقصّي بهذا الاتجاه. فهل كانوا يظنّون أن الأمر لا يتعلق بالسيارة التي يبحثون عنها؟
في هذه الحالة، لماذا لم يذهبوا إلى مقبرة للسيارات المحطّمة كانت موجودة في إحدى ضواحي باريس حيث كانت توجد سيارة فيات اونو بيضاء اللون محطمة إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، كانت قد تعرّضت لحادث بعد عدة ساعات من الحادث القاتل لديانا ودودي تحت نفق ساحة آلما بباريس؟
وجاء في محضر موريس قوله حرفيا: بعد أقل من أربع ساعات من وقوع الحادث طار جيمس اندرسون فجأة إلى كورسيكا. لم يكن هناك أي سبب مهني يدفعه للقيام بذلك.
ولم تكن هناك أية شخصية شهيرة في الجزيرة آنذاك. وفي مايو عام 2000 وُجدت سيارة محروقة في غابة بالقرب من مدينة نانت، وكان السائق محروقا بداخلها. وأظهرت فحوص الحمض النووي أن الجثة هي جثة جيمس اندرسون.
فلماذا ذهب اندرسون إذن إلى كورسيكا؟ هل من أجل تلقي مبلغ مالي كبير مقابل إعارته سيارته الفيات اونو البيضاء لأحدهم؟ لكن لمن؟ ما يقوله محمد الفايد هو أن سيارة اندرسون قد أُعيرت واستخدمت من أجل إرغام هنري بول على فقدان سيطرته على السيارة المرسيدس.
لكن هناك الكثير من الأسئلة الأخرى، مثل لماذا الإهمال الكبير في تحقيق الشرطة حول موت اندرسون؟ ولماذا لم تحاول معرفة أسباب سفره إلى كورسيكا والتفتيش بدقة في حساباته المصرفية؟ بكل الحالات لم يتم التحقيق عمّا إذا كان قد وضع مبلغا كبيرا من المال في أحد حساباته بعد الحادث.
ربما أن هاليفي لن يقول أبدا ما لديه حول هذه القضية. كان قد وصل من دون ضجيج إلى رئاسة الموساد وغادره بالطريقة نفسها، ليحل محله مائير داجان الذي كان قد شارك في قمع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1991.
لقد اختاره أرييل شارون الذي ربطته به صداقة حميمة بعد مشاركتهما معا في عمليات القمع ضد الفلسطينيين في لبنان، ومنذ اللحظات الأولى لاستلامه منصبه الجديد كانت تعليماته لعملائه واضحة وهي: اقتلوا بكل الوسائل... وبكل الاتجاهات.
ما بعد صدام .
في يناير 2003 كانت إدارة جورج دبليوبوش على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم على العراق، وفي ذلك الوقت الذي كانت تدق طبول الحرب قال الرئيس الأميركي لبعض المقرّبين منه أنه يتهيأ لرفع المنع المفروض على وكالة الاستخبارات المركزية من اغتيال صدام حسين.
وكانت قرارات المنع تلك التي أصبح ممنوعاً بموجبها على الوكالة قتل أي رئيس دولة تعود إلى الفشل الذريع الذي كانت قد عرفته محاولة اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو خلال سنوات السبعينات.
لم يتم إلغاء تلك القرارات رسميا أبدا بشكل رسمي، لكن في تلك الأيام الأولى من عام 2003 كان المحافظون الجدد الذين يحيطون بالرئيس بوش - وكان أغلبهم قد عمل مع بوش الأب - يرفعون الأنخاب للاحتفال بالموت القريب لصدام حسين.
وكان دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي، قد صرّح بأنه يحق شرعيا للولايات المتحدة اغتيال أي إنسان كان قد ساهم من قريب أو بعيد بالتحضير لتفجيرات 11 سبتمبر؛ ثم أضاف رامسفيلد قوله أن جرما آخر يقع على كاهل صدام وهو تخزينه لأسلحة الدمار الشامل.
ويشير مؤلف الكتاب هنا إلى أن كولن باول، وزير الخارجية، وجورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والمحللين قد ذكّروا بإلحاح أنه ليس هناك ما يثبت بطريقة قاطعة أن لصدام روابط مع تفجيرات سبتمبر أو أنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وكان رامسفيلد يجيبهم باستمرار بأن مصادر معلوماته تفيد غير ذلك.
اكتشف عميل الموساد المقيم في السفارة الإسرائيلية بواشنطن أن المصدر الرئيسي الذي يزود رامسفيلد بالمعلومات هو أحمد الجلبي الذي كان قد ساهم في إنشاء المؤتمر الوطني العراقي. ويؤكد مؤلف هذا الكتاب أن أحمد الجلبي كان أحد مخبري الموساد في العراق بعد وصول صدام حسين إلى السلطة عام 1979.
وكان مدينا بمئات الملايين من الدولارات للذين أودعوا أموالهم في البنك الذي عمل بإدارته. وكان الموساد قد نجح في سحب ودائعه منه قبل إفلاسه. وبعد فترة وجيزة وجّه محمد سعيد النابلسي، مدير البنك المركزي الأردني، تهمة للجلبي بتحويل 70 مليون دولار إلى حساب خاص باسمه في أحد البنوك السويسرية.
وصل الجلبي إلى واشنطن لحظة انتخاب جورج دبليو بوش رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. ولم يكن حتى حرب الخليج الأولى سوى أحد الكثيرين من أمثاله الذين يبحثون عن مصالحهم.
لكن الحرب غيّرت المعطيات وتقرّب الجلبي باسم المؤتمر الوطني العراقي من أجواء المحافظين الجدد المحيطين بجورج دبليو بوش ومن بينهم ديك شيني وبول وولفويتز ودونالد رامسفيلد واتفق الجلبي مع هذا الأخير على القول أن صدام حسين قد يشكل خطرا على العالم كله.
والمثير للاستغراب أن الجلبي بدأ بالاطلاع على تقارير سرّية حول صدام حسين من إعداد وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. وأشار الجلبي إلى أن تقارير الوكالة بعيدة عن الواقع.
وفي نهاية صيف 2002، قبل عدة أيام من الذكرى الأولى لتفجيرات 11 سبتمبر، أمر رامسفيلد بإنشاء وحدة خاصة في البنتاغون من أجل إعادة النظر بالمعلومات التي يقدمها الجلبي وإعادة تقويم علاقات صدام حسين بالقاعدة وتطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق.
وضمن هذا الإطار أصبح أحمد الجلبي أحد مصادر المعلومات الرئيسية بالنسبة لرامسفيلد. وقد أثار ذلك غضب جورج تينيت، مدير الوكالة المركزية، الشديد إلى درجة أنه قدّم استقالته في أغسطس 2002، وحيث تدخل «تشيني» من أجل بقائه.
وجد مائير داجان الحظوة التي يتمتع بها الجلبي لدى رامسفيلد غريبة جدا، لاسيما وأن الملف الذي بيديه عنه يدل بوضوح على أنه لم يقدم سوى معلومات قليلة الأهمية عندما كان يتجسس لحساب الموساد في العراق. ثم إنه بعد عشر سنوات من مغادرته العراق، من المحتمل قليلا جدا أنه تكون له صلات حقيقية داخل نظام صدام حسين.
الديمقراطية والعضلات
تعرّف داجان خلال زياراته لواشنطن، كما فعل جميع مدراء الموساد، على أعضاء مهمين في إدارة بوش، وخاصة أولئك الذين ينادون بالديمقراطية ذات العضلات والذين كانوا يرددون في حديثهم ما يدل على تزمتهم الديني.
ويشير المؤلف في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه القس بيل غراهام، صديق عائلة بوش منذ فترة طويلة، في حث الرئيس بوش، بعد تفجيرات 11 سبتمبر، من أجل استئصال الإرهاب باسم «الغضب العادل»، بل وقام غراهام بإهداء جورج دبليو بوش إنجيلا صغيرا كي يضعه باستمرار في جيبه.
وعلى قاعدة مثل هذا الاعتقاد الديني تحدث بوش عن «محور الشر». ويضيف المؤلف: «إن إلحاح الرئيس بوش لشن هجوم على العراق كان مرتبطا، هو الآخر، بالاعتقاد الديني المتزمت للمحافظين الجدد الذين كانوا يحيطون به».
وفي الأيام الأولى من فبراير 2003، إثر محادثة هاتفية بين آرييل شارون والرئيس الأميركي بوش، أحاط شارون داجان علما أنه اقترح مشاركة الموساد النشطة باغتيال صدام حسين، وأن بوش قد قبل ذلك الاقتراح.
بدأ خبراء الموساد بتحليل محاولات الاغتيال السابقة لصدام حسين وأسباب فشلها وحيث كان الرئيس العراقي قد تعرّض خلال السنوات العشرالأخيرة إلى 15 محاولة اغتيال.
وكان وراء بعضها الموساد أو أجهزة الاستخبارات البريطانية. ولم يستطع أولئك الذين تمّ تجنيدهم للقيام بها من اختراق إجراءات الحماية الأمنية الممتازة لصدام أو لأنهم لم يستطيعوا بكل بساطة الاقتراب إلى درجة كافية من الهدف.
كان الموساد قد قام بمحاولة أولى في نوفمبر 1992، وكان عملاؤه في العراق قد خبروا أن صدام حسين سيقوم بزيارة إلى بلدة قرب تكريت وأنه سيصل قبل حلول الليل بقليل وسيزور في اليوم التالي قاعدة عسكرية في الجوار قبل أن يعود بالطائرة إلى بغداد. وبالتالي قد يكون هدفا ممكنا في فترة ال15 دقيقة التي يحتاجها للانتقال من البلدة إلى القاعدة العسكرية.
قام الجنرال أميرام لوفين، نائب مدير الموساد آنذاك، بالإشراف شخصيا على إعداد خطة الاغتيال، ووافق بنيامين نتانياهو عليها، وقام الفريق المكلّف بتنفيذها بالتدرب عليها في صحراء النقب. وكان مقررا أن يساند قتلة الموساد فريق من 40 عضوا من الفرقة 262 من القوات الخاصة التي كانت قد شاركت في قتل خاطفي طائرة العال إلى مطار أوغندي عام 1976.
كان مقررا أن يطير القتلة على ارتفاع منخفض بحيث لا تكشفهم الرادارات على متن طائرتين من طراز «هركيوليز سي - 130» وبحيث يتوزعون على الأرض إلى مجموعتين إحداهما تتمركز على بعد حوالي 200 متر من الفيللا التي كان صدام فيها بالقرب من تكريت وبجانب الطريق الذي يُفترض أن يسلكه إلى القاعدة العسكرية الجوية.
أما المجموعة الرئيسية فتكمن على بعد 10 كيلومترات ويتم تزويدها بصاروخ خاص يستخدمه الموساد ويتم توجيهه إلكترونيا. كان يُفترض أن يقوم فريق القتلة القريب بتصوير سيارة صدام وهو يطلق النار عليها، وفي اللحظة نفسها يعطي أحدهم الإشارة لفريق الصاروخ كي يطلقه تبعا للمعطيات المقدّمة بواسطة «الكاميرات» .
وبالتالي يتم تدمير السيارة. وما يؤكده المؤلف أن هذه العملية ألغيت باللحظة الأخيرة بدفع من آرييل شارون، وزير الخارجية، وإسحاق مردخاي، وزير الدفاع، على خلفية تقديرهما أن مخاطر فشلها كانت كبيرة جدا.
بعد عشر سنوات من تلك المحاولة، التي لم تتم، بدا أن الموساد، وبدعم من واشنطن، يتردد بدرجة أقل بكثير في محاولة اغتيال صدام حسين. وكانت خطة الموساد مستوحاة هذه المرة من محاولة الاغتيال التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو.
وكان العملاء قد حشدوا عددا كبيرا من الأصداف البحرية بالمتفجرات ووضعوها في قعر البحر حيث كان كاسترو يحب الاستحمام. لقد فشلت تلك المحاولة لأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أغفلت من حساباتها التيارات القوية التي جرفت القواقع بعيدا عن المنطقة.
لكن مثل هذه التيارات لم تكن تطرح أية مشكلة بالنسبة للنهر حيث يستحم صدام، وكانت المتفجرات مصممة هذه المرة للانفجار بمجرد قيام السابحين بأية حركة.
قبل أيام فقط من تنفيذ خطة الاغتيال الجديدة انفجرت حرب الخليج ثانية، وقدّم عملاء الموساد معلومات مهمة عندها قامت الطائرات الأميركية والبريطانية على أساسها بغارات قتلت الألوف من العراقيين.
ويؤكد المؤلف أن جورج تينيت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كان يتصل عدة مرّات يوميا بمائير داجان، مدير الموساد، ليسأله عمّا إذا كان جهازه قادرا على تأكيد حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل.
وكانت الإجابة دائما هي: «ليس بعد، ولكننا نبحث». لكن محللي الموساد كانوا قد شرحوا لداجان أنه لا يوجد هناك أي برهان قاطع على امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل.
رددت وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية، عند بداية الحرب، تحذيرات لإشاعة الاعتقاد بإمكانية قيام نظام صدام باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل أو ضد قبرص، حيث تتواجد أعداد كبيرة من القوات البريطانية، أو في منطقة الخليج حيث يرابط المارينز الأميركيون، أو حتى ضد الكويت، نقطة انطلاق الهجوم على العراق. «لكن لم يحصل شيء من هذا كله، ولم تنطلق قذيفة واحدة فيها أي أثر لسموم كيميائية.
ولم يعرف تاريخ الحرب كله مثل خيبة الأمل تلك». وبعد عشرين يوما من بداية الحرب كانت المعارك قد توقفت لتبدأ حرب أخرى، أكثر فتكا، تمتزج فيها الأحقاد الدفينة والمسائل البترولية والجشع المسيطر على النفوس...
وبدأت الدماء تنزف أكثر فأكثر في العراق. كان لا بد للعراق أن يغرق في الفوضى، وليصبح الوضع اعتبارا من مايو 2003 أكثر رعبا مما كان مرعبا في ظل دكتاتورية صدام حسين.
بعد السقوط
لم يكن الموساد، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب، بعيدا عن ملاحقة صدام بعد سقوط نظامه. وُضعت فرضيات كثيرة حول مكان وجوده، وليس أقلها غرابة إمكانية لجوئه إلى الأصدقاء الذين اعتمد عليهم في الماضي، أي روسيا والصين، هذا على الرغم من تأكيد البلدين رسميا أنهما لن يمنحاه حق اللجوء إليهما.
في الوقت نفسه كانت ألوف الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية تصل كل دقيقة إلى مقرات القيادات المختصة وكذلك آلاف المحادثات الهاتفية. أدركت عندها أجهزة الاستخبارات الأميركية المتنوعة مدى افتقارها إلى مترجمين يقومون ب«غربلة» تلك المحادثات. وكان بوش وبلير وشارون في حالة غضب متصاعد أمام فشل العثور على صدام أو معرفة إذا كان قد مات.
وقد كانوا يؤكدون في تصريحاتهم العلنية أن ذلك لم يكن يشكّل موضوعا ذا أهمية كبيرة فصدام لم يعد يمثل أي تهديد. لكن لم يكن هناك الكثيرون ممن يصدقون ذلك».
وكان اهتمام بوش وبلير منصبا أكثر على إيجاد أسلحة الدمار الشامل المزعومة. لكن الحقيقة تكشفت عن شيء آخر، هو أنها غير موجودة في العراق.
ولم يتردد روبن كوك، وزير الخارجية البريطاني السابق، وكلير شورت، الوزيرة السابقة في حكومة بلير التصريح أن رئيس وزراء بريطانيا قد كذب على البرلمان والشعب عندما أكد وجود مثل تلك الأسلحة في العراق.
وأثناء الأزمة كلها كان مائير داجان، لا يكف عن ترديد قوله أن الموساد «لا يزال يبحث» عن الأسلحة المزعومة، من دون إضافة شيء آخر. ولو كان يدرك حقيقة عدم وجودها.
وفي ديسمبر 2003 ألقي القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. يقول المؤلف: «لقد قبضوا عليه بسبب متطلبات المرأة الوحيدة التي كان لا يزال يثق بها أي سميرة شهبندر، الزوجة الثانية بين الزوجات الأربع».
ويضيف: «بتاريخ 11 ديسمبر اتصلت هاتفيا بصدام من مقهى للانترنت ببعلبك؛ حيث كانت تعيش في لبنان هي وابنها علي، الابن الوحيد الحي من أبناء صدام، تحت أسماء مستعارة منذ أن غادرا العراق قبل عدة أشهر من بداية الحرب». وفي بيروت تمّ رصدها ومراقبتها.
ويؤكد مؤلف هذا الكتاب أن مقرّبا من مائير داجان قد شرح له أنه «لأسباب سياسية لم تتم رسميا دعوة الموساد للمشاركة في العيد»، ويقصد ملاحقة صدام من قبل الأميركيين. وما يؤكده أيضا هو أن الموساد قد التقط يوم 11 ديسمبر 2003 مكالمة سميرة الهاتفية لصدام حسين وتمّ فيها تحديد موعد للقاء بالدقيقة والمكان.
وفي اللحظة نفسها التي كانت تستعد فيها للذهاب إلى موعدها جاءها صوت في الهاتف، ليس صوت صدام، يقول لها إن الموعد قد ألغي. وفي اللحظة نفسها أيضا كانت تلفزيونات العالم تبث صورا لاعتقال صدام في حجرةعلى عمق 5,2 متر في باطن الأرض قرب تكريت.
وعند رؤية تلك الصور طرح محللو الموساد أسئلة، لا تزال دون إجابات، مثل: من كان الرجلان المسلحان المجهولان ويقومان بالحراسة أمام الحجرة؟
هل كانا لحماية صدام أم لقتله إذا حاول الهرب؟ لماذا لم يستخدم صدام مسدسه للانتحار؟ هل منعه الجبن أم أنه كان يأمل في عقد صفقة؟ ثم لم يكن لمخبئه سوى مدخل واحد، فهل كان سجينا؟
ألم يكن وجوده حيث كان جزءاً من صفقة؟ وماذا كان يريد أن يفعل بال000 750 دولار التي وجدوها معه عند اعتقاله؟ ولماذا لم يكن معه أية وسيلة للاتصال بالخارج ولو حتى هاتف نقّال؟




















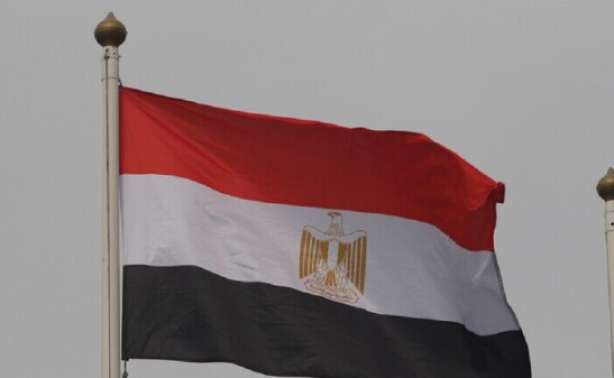











التعليقات